إنجيل متى | 14 | الكنز الجليل
الكنز الجليل في تفسير الإنجيل
شرح إنجيل متى
الأصحاح الرابع عشر
١ «فِي ذٰلِكَ ٱلْوَقْتِ سَمِعَ هِيرُودُسُ رَئِيسُ ٱلرُّبْعِ خَبَرَ يَسُوعَ».
هِيرُودُس هو أنتيباس بن هيرودس الكبير من امرأته ملثاسي، حكم بعد موت أبيه على الجليل والسامرة وبيرية، أي عبر الأردن. وامرأته الأولى بنت الحارث ملك دمشق المذكور في ٢كورنثوس ١١: ٣٢. وبعد ذلك رأى هيروديا زوجة أخيه فيلبس، وهي بنت أخيه أرستوبولس بن هيرودس الكبير فأغراها بترك زوجها وتزوجها، ولأجلها طلق امرأته بنت الحارث. فوبخه يوحنا المعمدان على هذا الزنا، وهو محرم حسب الشريعة اليهودية لسببين: (١) أنها ابنة أخيه، و(٢) أنها زوجة أخ حي. ووبخه أيضاً على ذنوب أخرى (لوقا ٣: ١٩) فسجنه لتجاسره على توبيخه إياه، ولخوفه من تأثير وعظه في الشعب. وبعد قليل من قتل يوحنا حارب الحارث هيرودس وهزمه وشتت جنوده. ثم ذهب إلى روما يبتغي رتبة ملك، فنُفي إلى ليون في غاليا (أي فرنسا). ورافقته هيروديا وذهبا من هناك إلى أسبانيا وماتا فيها. وكان ظالماً (لوقا ٣: ١٩) خادعاً (لوقا ١٣: ٣١، ٣٢). وهو هيرودس الذي أتى المسيح إليه ووقف أمامه بأمر بيلاطس (لوقا ٢٣: ٦ – ١١).
رَئِيسُ ٱلرُّبْعِ قُصد بهذا اللقب أولاً ما يدل عليه ظاهر معناه، ثم صار بمعنى والٍ (أقل من الملك) بغضّ النظر عن مساحة ما يتولاه من البلاد. وكانوا يدعونه أحياناً ملكاً على سبيل الإكرام والتعظيم (مرقس ٦: ١٤).
خَبَرَ يَسُوع لا ريب في أن شهرة المسيح بتعليمه ومعجزاته كانت ذائعةً في كل تلك البلاد، وانتشر أكثر من ذلك عندما أرسل تلاميذه ينادون به ويصنعون الآيات باسمه، فبلغ خبره هيرودس ورغب في أن يراه (لوقا ٩: ٩).
٢ «فَقَالَ لِغِلْمَانِهِ: هٰذَا هُوَ يُوحَنَّا ٱلْمَعْمَدَانُ قَدْ قَامَ مِنَ ٱلأَمْوَاتِ، وَلِذٰلِكَ تُعْمَلُ بِهِ ٱلْقُوَّات».
قَامَ مِنَ ٱلأَمْوَاتِ اعتقد اليهود كلهم سوى الصدوقيين بقيامة الأموات، مع أن هذه الحقيقة لم توضح في العهد القديم كما وضحت بعدئذٍ في العهد الجديد.
كان هيرودس يعتنق مذهب الصدوقيين (مرقس ٨: ١٥) فكان قوله إن يوحنا قام من الأموات مناقضاً لاعتقاده أن لا قيامة لميت.
وَلِذٰلِكَ تُعْمَلُ بِهِ ٱلْقُوَّات يوحنا لم يفعل معجزة (يوحنا ٤٠: ٤١) فلا يكون صنع المعجزات برهاناً على قيامته. فما قاله هيرودس كان غالباً نتيجة توبيخات ضميره. لكن مخاوفه لم تقده إلى التوبة. فالضمير المؤنب يجعل الخاطئ يتوقع العقاب دائماً، ويتوهم أن كل أمر غريب هو بدء ذلك. وتعنيف الضمير برهان على الدينونة الآتية ونموذجها. وكثيرون يعتقدون في وقت الصحة والنجاح عقائد باطلة ينكرونها في وقت الخطر والاضطراب.
٣ «فَإِنَّ هِيرُودُسَ كَانَ قَدْ أَمْسَكَ يُوحَنَّا وَأَوْثَقَهُ وَطَرَحَهُ فِي سِجْنٍ مِنْ أَجْلِ هِيرُودِيَّا ٱمْرَأَةِ فِيلُبُّسَ أَخِيهِ».
لوقا ٣: ١٩، ٢٠
فَإِنَّ أي الكلام الآتي تعليل وإيضاح لقول هيرودس «قد قام من الأموات».
أَمْسَك أي أمسكه العسكر بأمر هيرودس.
أَوْثَقَه إما بالقيود وإما بسجنه، وذلك نحو سنة ونصف سنة وهو نحو نصف الزمن من بداءة تبشيره إلى وفاته.
فِي سِجْنٍ قال يوسيفوس كان ذلك السجن في قلعة ماخيروس شرقي بحر لوط.
هِيرُودِيَّا بنت أرستوبولس الذي قتله أبوه هيرودس الكبير، وزوجها الأول فيلبس عمها. وهو ليس فيلبس رئيس الربع المذكور في لوقا ٣: ١ لأنه لم يكن ذا منصب. تركته وتزوجت أخاه هيرودس أنتيباس عمها وسلفها، وهو طلق امرأته بنت الحارث لأجلها وبذلك اشتبك في حرب حميه أبيها ولم ينجُ من تلك الحرب إلا بواسطة الرومان. فنسب اليهود مصائبه إلى قتله يوحنا المعمدان ظلماً كما ذكر يوسيفوس المؤرخ.
٤ «لأَنَّ يُوحَنَّا كَانَ يَقُولُ لَهُ: لاَ يَحِلُّ أَنْ تَكُونَ لَكَ».
لاويين ١٨: ١٦ و٢٠: ٢١
حرَّم ذلك العمل الناموسي الطبيعي وناموس الله على يد موسى. وفي عمل هيرودس ثلاث خطايا: تطليق امرأته بلا سبب شرعي، وزواجه بامرأة أخيه وهو حيٌّ، وهي ابنة أخيه (لاويين ١٨: ١٦ و٢٠: ٢١). وأظهر يوحنا المعمدان أمانته وشجاعته بأنه وبخ حاكماً قديراً ظالماً ينتقم من كل إغاظة، فأثبت أنه ليس «قصبة مرضوضة تحركها الريح» (متّى ١١: ٧) وقوله «يوحنا كان يقول له» المراد به في الأصل اليوناني أنه كان دائماً يقول له ذلك.
٥ «وَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَقْتُلَهُ خَافَ مِنَ ٱلشَّعْبِ، لأَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُمْ مِثْلَ نَبِيٍّ».
متّى ٢١: ٢٦ ولوقا ٢٠: ٦
ما أجمل أن يكون للرأي العام كلمة، ولا سيما إذا كان منصفاً تقياً يرى الصواب فيذيعه، ويرى الخطأ فيبعد الناس عنه. ولكن هذا الرأي العام في ذاك الحين كان ضعيفاً جداً لم يستطع أن يقف في وجه الطاغية ويقول له: هذا لا يجوز. وأمثال يوحنا المعمدان وإيليا النبي قليلون.
تبين لنا مما قاله مرقس (مرقس ٦: ٢٠) أن تعليم يوحنا أثر كثيراً في هيرودس في أول عهده به، وأن هيرودس اعترف بحسن صفاته وجودة تعليمه. لكن تأثيراته كانت وقتية وزالت بما أبدته له هيروديا (مرقس ٦: ٢١) وبضجره من كثرة توبيخ يوحنا له، فأراد قتله وامتنع خوفاً من الناس لأنهم اعتقدوا أن يوحنا نبي. وكان أهل الجليل يومئذٍ يميلون إلى الهياج دائماً، وكان هيرودس لا يستطيع تهدئتهم إلا ببذل كل جهده.
٦ «ثُمَّ لَمَّا صَارَ مَوْلِدُ هِيرُودُسَ رَقَصَتِ ٱبْنَةُ هِيرُودِيَّا فِي ٱلْوَسَطِ فَسَرَّتْ هِيرُودُسَ».
لَمَّا صَارَ مَوْلِد الاحتفال بعيد ميلاد الملوك من العادات القديمة (تكوين ٤٠: ٢٠) فحضر الاحتفال بعيد ميلاد هيرودس رؤساء البلاد (مرقس ٦: ٢١).
رَقَصَتِ ٱبْنَةُ هِيرُودِيَّا أي ابنتها من فيلبس زوجها الأول، وقال يوسيفوس إن اسمها «سالومي». ولم يكن رقصها كرقص السيدات في بيوتهن بل كرقص المستأجرات في الملاعب بلا حياء، تأباه النساء الشريفات من اليونان والرومان واليهود في المحافل. فخفضت مقامها الملكي وداست شرفها وعفافها لتُسرَّ هيرودس وتنال مرادها. فسُر هيرودس برقصها وبذل جهده في إرضائها وإرضاء مدعويه.
٧ «مِنْ ثَمَّ وَعَدَ بِقَسَمٍ أَنَّهُ مَهْمَا طَلَبَتْ يُعْطِيهَا».
تجاوز بهذا الوعد الحد فأظهر به طيشه وشدة لذاته برقص سالومي. ولا يبعد أنه كان نشوان من الخمر، فلم يكتفِ بالوعد بل أثبته بقسم.
٨ «فَهِيَ إِذْ كَانَتْ قَدْ تَلَقَّنَتْ مِنْ أُمِّهَا قَالَتْ: أَعْطِنِي هٰهُنَا عَلَى طَبَقٍ رَأْسَ يُوحَنَّا ٱلْمَعْمَدَانِ».
تَلَقَّنَتْ لقَّنتها أمها وأغرتها. وسرعة طلبها تدل على شدة بغض هيروديا ليوحنا وقصدها الانتقام في أول فرصة. ولعلها أغرت سالومي بذلك لهذه الغاية عينها، وإنما رغبت في قتل يوحنا خوفاً من أن يؤثر كلامه في نفس هيرودس فيقتنع بإثمه، لأنه أخذها من زوجها الشرعي.
فمن أسرار العناية الإلهية أن تُبذل حياة أعظم الأنبياء خليفة إيليا وسابق المسيح تشفياً لامرأة شريرة زانية، وأن يعطى رأسُه أجرة رقص ابنتها. وطلبت هيروديا أن يقدم لها رأس يوحنا لأمرين: (١) أن تتيقن أنه هو قُتل لا غيره بدلاً منه، و(٢) أن تتشفى من غيظها بمشاهدة وجه عدوها قتيلاً.
٩ «فَٱغْتَمَّ ٱلْمَلِكُ. وَلٰكِنْ مِنْ أَجْلِ ٱلأَقْسَامِ وَٱلْمُتَّكِئِينَ مَعَهُ أَمَرَ أَنْ يُعْطَى».
فَٱغْتَمَّ لم يكن غم هيرودس شديداً ولم يشغل وقتاً طويلاً، فهو كتأثره من وعظ يوحنا (مرقس ٦: ٢٠) ومثل توقف بيلاطس في الحكم على المسيح. ولذلك لم يمنع الغم هيرودس عن أن يرتكب إثماً آخر فوق آثامه السابقة، فخالف شريعة ضميره وشهادته أيضاً. ولعل ذلك كان آخر تأثير للروح القدس ففارقه بعده إلى الأبد.
ويحتمل أنه اغتم خفية لأنه خاف أن ينتج قتل يوحنا هياج الشعب، لأننا نعلم أنه لم يمنعه عن قتله قبلاً سوى الخوف من ذلك (متّى ١٤: ٥). ولعل هذا هو الأرجح.
ٱلْمَلِك لم يلقبه متّى بالملك لأن له حقاً في هذا اللقب بل أتى به على سبيل التعظيم.
مِنْ أَجْلِ ٱلأَقْسَامِ الذي حمله على إجابة سؤال سالومي أمران: (١) إلزام ضميره إياه أن يفي بوعده الذي أثبته بالحلف، و(٢) خوفه من أن يلومه المدعوون ويهزأون به إن لم يفِ. على أنه لم يكن يجوز له أن يجيب سؤلها لأن ليس له حق أن يقتل فاضلاً بريئاً. فخير لنا أن نخالف كلامنا من أن نخالف كلام الله.
ثم أن كل وعدٍ يأتيه الإنسان بلا تأمل ونظر في عواقبه خطيئة، لأنه يعرض صاحبه للضرر، ويضر غيره في الوفاء به، كما كان من أمر يفتاح (قضاة ١١: ٣٠ – ٤٠). فيجب أن ننتبه لما نعد به ولا سيما ما نقسم عليه (جامعة ٥: ٢، ٦).
كثيرون يحذرون من الصغائر ويرتكبون الكبائر بلا تأمل فهم «يُصَفُّونَ عَنِ الْبَعُوضَةِ وَيَبْلَعُونَ الْجَمَلَ» (متّى ٢٣: ٢٤) فهيرودس خشي أن يخلف وعده للراقصة، ولكنه لم يبال بارتكاب الزنا والقتل.
وَٱلْمُتَّكِئِين ولعل الخوف من لوم هؤلاء معظم ما حمله على إجابة راقصته، فخشي من هزئهم أكثر مما خشي من تأنيب ضميره ودينونة الله. ومثله اليوم كثيرون يهيِّجون عليهم غضب ولوم الملائكة والناس الصالحين خوفاً من استخفاف الناس وضحكهم بهم. والشبان أكثر تعرضاً لهذه التجربة.
١٠ «فَأَرْسَلَ وَقَطَعَ رَأْسَ يُوحَنَّا فِي ٱلسِّجْنِ».
أرسل سيافاً (مرقس ٦: ٢٧). وعلم من قول يوسيفوس أن السجن كان في قلعة ماخيروس شرقي بحر لوط فنستنتج أن احتفال هيرودس كان في تلك القلعة أو في قلعة أخرى في ولاية قريبة منها لأنه لو كان في طبرية عاصمة الولاية لاقتضى ذهاب السياف ورجوعه وقتاً أكثر مما يقتضي نبأ الحادثة في قول الصبية «أريد أن تعطيني حالاً» (مرقس ٦: ٢٥).
قَطَعَ رَأْسَ يُوحَنَّا كما كان يوحنا مثل إيليا، كانت هيروديا مثل إيزابل عدو إيليا. فإن كانت هيروديا قد ظنت أنها تخلص من التوبيخ على آثامها بقتل يوحنا فقد غلطت، لأن لدمه صوتاً يشهد عليها كصوت دم هابيل على قايين. وأما يوحنا فقد أكمل عمله وأدى شهادته للمسيح فكان مستعداً للموت، فلم يكن الموت خسارة له بل ربحاً، لأنه انتقل من سجن ماخيروس إلى قصر الملك العظيم السماوي. فموت يوحنا في تلك الأحوال يدلنا على أن الإنسان يمكن أن يكون أميناً في عمله تقياً محبوباً من الله، وموت مع ذلك كله في شبابه. فحين يطالب الله بدم استفانوس ويعقوب وسائر الرسل والشهداء يطالب بذلك الدم الزكي وفقاً لقوله «لأَنَّهُ هُوَذَا الرَّبُّ يَخْرُجُ مِنْ مَكَانِهِ لِيُعَاقِبَ إِثْمَ سُكَّانِ الأَرْضِ فِيهِمْ، فَتَكْشِفُ الأَرْضُ دِمَاءَهَا وَلاَ تُغَطِّي قَتْلاَهَا فِي مَا بَعْدُ» (إشعياء ٢٦: ٢١).
١١ «فَأُحْضِرَ رَأْسُهُ عَلَى طَبَقٍ وَدُفِعَ إِلَى ٱلصَّبِيَّةِ، فَجَاءَتْ بِهِ إِلَى أُمِّهَا».
عَلَى طَبَقٍ أي على ما يؤكل عليه. فقُدم رأس يوحنا عليه وأخذته الصبية كأنه حصتها من الوليمة الملكية وأكثر قبولاً لقلبها القاسي من كل أطايب تلك الوليمة. فنتعلم من هذه القصة رذيلة هيرودس، وسهولة أن يجد من يجرون مقاصده الشريرة، ونهاية محزنة لحياة فاضل تقي لم يبلغ سن الرابعة والثلاثين، وخبث قلبَي والدة وابنتها وقساوتهما الخارقة العادة حتى طلبتا تلك الهبة الفظيعة وسُرتا بقبولها.
ٱلصَّبِيَّةِ هي سالومي تزوجت عمها فيلبس رئيس الربع، وتزوجت بعد موته ابن عمها أرستيبولس الثاني.
١٢ «فَتَقَدَّمَ تَلاَمِيذُهُ وَرَفَعُوا ٱلْجَسَدَ وَدَفَنُوهُ. ثُمَّ أَتَوْا وَأَخْبَرُوا يَسُوعَ».
تَلاَمِيذُهُ أي تلاميذ يوحنا (مرقس ٦: ٢٩). فيحتمل أنهم ممن سمعوا وعظه وصدقوا تعليمه واعتمدوا منه، لأن كثيرين منهم كانوا في أرض فلسطين فأظهروا اعتبارهم له بدفنهم بدنه، ولكنهم اكتفوا بذلك دون أن يبقوا عندهم شيئاً من آثاره تذكاراً له أو تبركاً به. ولا ذكر لإبقاء شيء من آثار نبي أو رسول لذلك من بدء كتاب الله إلى آخره. وبذهابهم إلى يسوع ليرووا له الخبر المحزن أظهروا أنهم اعترفوا بأنه خليفة يوحنا، وأخبروه ليشعر معهم بحزنهم ويعزيهم. ويحتمل أنهم قصدوا أن ينبهوه ليحذر الخطر.
فائدة: يجب علينا أن نخبر المسيح بأحزاننا في كل مصائبنا كما أخبره تلاميذ يوحنا بأحزانهم، فلا يقدر أحد أن يعيننا ويعزينا مثله.
ملحوظة: نورد ما يميز بين هيرودس المذكور هنا وهيرودس آخر ممن ذكر في الإنجيل. فنقول هيرودس الكبير قتل أطفال بيت لحم، وهيرودس أنتيباس قتل يوحنا المعمدان وسخر بيسوع، وهيرودس أغريباس قتل يعقوب الرسول وسجن بطرس. فعائلة الهيروديين اشتهرت وزادت عن كل عائلة عُرفت في الأرض بالظلم والرذيلة والقساوة والخداع وتعدي كل الشرائع البشرية والإلهية.
١٣ «فَلَمَّا سَمِعَ يَسُوعُ ٱنْصَرَفَ مِنْ هُنَاكَ فِي سَفِينَةٍ إِلَى مَوْضِعٍ خَلاَءٍ مُنْفَرِداً. فَسَمِعَ ٱلْجُمُوعُ وَتَبِعُوهُ مُشَاةً مِنَ ٱلْمُدُنِ».
متّى ١٠: ٢٣ و١٢: ١٥
لَمَّا سَمِعَ يَسُوعُ خبر مقتل يوحنا وقول هيرودس إنه هو يوحنا قد قام من الأموات.
ٱنْصَرَفَ مِنْ هُنَاكَ أي من كفرناحوم حيث كان ساكناً يومئذٍ من ولاية هيرودس لئلا يطلبه هيرودس فيسجنه توهماً أنه يوحنا، ولأن ساعته لم تأت بعد. أو لأنه لم يرد أن يكون بين الهائجين على قتل يوحنا لئلا يجتمعوا إليه ويتخذوه رئيساً. أو لأن الطبيعة ألجأته إلى الاعتزال لموت حبيبه وقريبه المكرم. ولذلك سبب آخر ذكره مرقس ٦: ٣٠، ٣١ ولوقا ٩: ١٠ وهو رجوع الاثني عشر الذين أرسلهم إلى القرى يبشرون واحتياجهم إلى الراحة.
مَوْضِعٍ خَلاَء وفي لوقا ٩: ١٠ أن ذلك كان في أرض لبيت صيدا شرقي بحر طبرية.
تَبِعُوهُ كان ذلك في أوج اعتباره، والناس لا يزالون متوقعين أنه يتمم آمالهم بأن يكون ملكاً أرضياً ومنقذاً زمنياً.
مُشَاة ذهب يسوع في السفينة وتبعه الناس على شاطئ البحر، فالظاهر أن الريح كانت لينة لم تدفع السفينة بسرعة، فأمكن الناس أن يسبقوه مشاةً إلى حيث رأوا السفينة متوجهة (مرقس ٦: ٣٣).
١٤ «فَلَمَّا خَرَجَ يَسُوعُ أَبْصَرَ جَمْعاً كَثِيراً فَتَحَنَّنَ عَلَيْهِمْ وَشَفَى مَرْضَاهُمْ».
متّى ٩: ٣٧ ومرقس ٦: ٣٢ الخ ولوقا ٩: ١٠ الخ ويوحنا ٦: ١ الخ
لَمَّا خَرَج من السفينة أو محل انفراده على البر (يوحنا ٦: ٣).
جَمْعاً كَثِيرا لأن الذين تبعوه اجتمعوا من كل قرى الجليل، وربما اجتمع إليهم الغرباء الذين كانوا صاعدين إلى أورشليم ليحضروا عيد الفصح فإنه كان قريباً (يوحنا ٦: ٤) فمجيئهم منع يسوع عن الراحة المقصودة لكنه لم يغظه.
تَحَنَّنَ عَلَيْهِمْ لاحتياجاتهم ولا سيما الروحية منها. قال مرقس «فَتَحَنَّنَ عَلَيْهِمْ إِذْ كَانُوا كَخِرَافٍ لاَ رَاعِيَ لَهَا» (مرقس ٦: ٣٤). فيجب على كل مسيحي يشاهد جمعاً كثيراً من الناس أن يشفق عليهم ويرغب في أن يقودهم إلى المسيح بالإيمان، ويجب عليه إذا افتكر في الألوف والربوات الكثيرة من الجهلاء الهالكين في البلاد الوثنية أن يشفق عليهم كما أشفق المسيح على ذلك الجمع.
وَشَفَى مَرْضَاهُم اعتنى أولاً باحتياجاتهم الجسدية ثم اعتنى بأعظم احتياجاتهم جميعاً «فَابْتَدَأَ يُعَلِّمُهُمْ كَثِيرًا» (مرقس ٦: ٣٤).
١٥ «وَلَمَّا صَارَ ٱلْمَسَاءُ تَقَدَّمَ إِلَيْهِ تَلاَمِيذُهُ قَائِلِينَ: ٱلْمَوْضِعُ خَلاَءٌ وَٱلْوَقْتُ قَدْ مَضَى. اِصْرِفِ ٱلْجُمُوعَ لِكَيْ يَمْضُوا إِلَى ٱلْقُرَى وَيَبْتَاعُوا لَهُمْ طَعَاماً».
لَمَّا صَارَ ٱلْمَسَاءُ كان عند اليهود مساءان: بداية الأول العصر وهو المذكور هنا، وبداية الثاني المغرب وهو المذكور في متّى ١٤: ٢٣ (سفر العدد ٩: ٥، ١١).
تَلاَمِيذُهُ أي رسله (لوقا ٩: ١٢) وأتوا إليه، إما في أثناء خطابه أو بعد أن فرغ منه.
ٱلْمَوْضِعُ خَلاَء ليس فيه سوق ولا وسيلة إلى تحصيل الطعام.
وَٱلْوَقْتُ قَدْ مَضَى أراد الرسل بذلك أن الوقت الباقي من النهار لا يكفي أن يصل الناس إلى القرى ليشتروا ما يأكلون قبل أن ينسدل عليهم ظلام الليل. فاهتم التلاميذ بأولئك الناس لكثرتهم، ولأنه ليس لهم ما يأكلون، وخافوا أنهم يخورون جوعاً وأن يسوع ينسى حاجات أجسادهم لكثرة عنايته بحاجات نفوسهم.
اِصْرِفِ ٱلْجُمُوع ذلك يدل على أنه لم يزل يخاطبهم.
وَيَبْتَاعُوا لم يخطر على بالهم إلا شراء الخبز.
ذكر يوحنا أن المسيح افتتح الكلام في هذا الشأن مع فيلبس ثم أندراوس. والمرجح أن ذلك كان قبل الحديث الذي ذكره متّى، بدليل قول يوحنا «نَظَرَ أَنَّ جَمْعًا كَثِيرًا مُقْبِلٌ إِلَيْهِ، فَقَالَ لِفِيلُبُّسَ» (يوحنا ٦: ٥ – ٩) وقول متّى «لَمَّا صَارَ الْمَسَاءُ» (متّى ١٤: ١٥) وذلك بعد ما ذكر أنه شفى مرضاهم.
١٦ – ١٨ «١٦ فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ: لاَ حَاجَةَ لَهُمْ أَنْ يَمْضُوا. أَعْطُوهُمْ أَنْتُمْ لِيَأْكُلُوا. ١٧ فَقَالُوا لَهُ: لَيْسَ عِنْدَنَا هٰهُنَا إِلاَّ خَمْسَةُ أَرْغِفَةٍ وَسَمَكَتَانِ. ١٨ فَقَالَ: ٱئْتُونِي بِهَا إِلَى هُنَا».
المعجزة المذكورة هنا هي المعجزة الوحيدة التي ذكرها كل البشيرين الأربعة، فيظهر أنهم رأوها أكثر أهمية من غيرها.
وأبطأ المسيح أن يصرف الجمع أو يطعمهم ليمتحن إيمان تلاميذه بقوته على أن يقوم بما يحتاج إليه الناس في أشد ضيقهم، وليعلّمهم أن يتكلوا عليه في كل ضيق أو شدة. وعلة سؤاله لهم كما ذكر يوحنا هي أن يجعلهم يشعرون ويعترفون بعجزهم ويتوقعون ما سيفعله (يوحنا ٦: ٦)
لاَ حَاجَةَ لَـهُمْ أَنْ يَمْضُوا لم يرد المسيح أن يكلفهم بالذهاب في تلك الساعة وهم جياع ليبتاعوا خبزاً، لأنه يصعب عليهم السير في هذه الحال.
أَعْطُوهُمْ أَنْتُم أمرهم المسيح بذلك ليمتحن إيمانهم، وليعرفهم ضعفهم وعدم قدرتهم.
خَمْسَةُ أَرْغِفَةٍ وَسَمَكَتَانِ ذكر يوحنا أن غلاماً أتى بذلك، وقال إن تلك الأرغفة «من شعير» وهو طعام فقراء الناس. وكل البشيرين عينوا مقدار ذلك الطعام ليظهروا صحة المعجزة، وليبينوا أنه لم يكن لهم الطعام سوى ذلك القدر القليل. وذلك كله لا يكفي التلاميذ وحدهم بل يكاد لا يكفي غير اثنين لأن معدل ما يأكله الرجل دفعة ثلاثة أرغفة (لوقا ١١: ٥، ٦).
١٩ «فَأَمَرَ ٱلْجُمُوعَ أَنْ يَتَّكِئُوا عَلَى ٱلْعُشْبِ، ثُمَّ أَخَذَ ٱلأَرْغِفَةَ ٱلْخَمْسَةَ وَٱلسَّمَكَتَيْنِ، وَرَفَعَ نَظَرَهُ نَحْوَ ٱلسَّمَاءِ وَبَارَكَ وَكَسَّرَ وَأَعْطَى ٱلأَرْغِفَةَ لِلتَّلاَمِيذِ، وَٱلتَّلاَمِيذُ لِلْجُمُوعِ».
يَتَّكِئُوا كعادتهم في بيوتهم، وذلك أكثر موافقة لهم وهم في البرية حيث لا مائدة لهم سوى الأرض.
عَلَى ٱلْعُشْب كانت الأرض هنالك مرعى ليست للفلاحة والزرع، وسُميت قديماً «سهل البطيحة» وهي شرقي بيت صيدا. وقال مرقس إنهم «اتكأوا صفوفاً صفوفاً مئة مئة وخمسين خمسين» وغايته من ذلك تسهيل التوزيع، والحذر من أن يُترك أحدٌ.
ٱلسَّمَاءِ أي الجو الذي يظهر أنه يفصل بيننا وبين السماء العليا التي لا تُرى.
وَبَارَك للمباركة في الإنجيل ثلاثة معان: (١) رضى الله عن عبيده (متّى ٢٥: ٣٤) و(٢) طلب الإنسان رضى الله على غيره (لوقا ٢: ٣٤) و(٣) حمد الإنسان لله لأنه رضى عنه (مزمور ١٠٣: ١، ٢). ومعنى بارك هنا شكر أو حمد. وشكر المسيح الله وسأله الرضى باعتبار أنه إنسان، وهو نفسه وهب ذلك باعتبار أنه إلهٌ. وهذا مثال لنا لنشكر الله على كل ما يهبه لنا من الخيرات ونلتمس رضاه علينا في قبولها (١تيموثاوس ٤: ٤).
وَأَعْطَى ٱلأَرْغِفَةَ الخ كان توسط التلاميذ في توزيع الطعام لائقاً، ومساعدةً للمسيح، وتعجيلاً للتوزيع، ورمزاً لعملهم في المستقبل في توزيع خبز الحياة التي أخذوه من يد المسيح. وبذلك كان لهم أن يشهدوا عن يقين بما شاهدوه عياناً واختبروه عملاً من قلة الأكل في أول الأمر وكثرته في نهايته.
٢٠ «فَأَكَلَ ٱلْجَمِيعُ وَشَبِعُوا. ثُمَّ رَفَعُوا مَا فَضَلَ مِنَ ٱلْكِسَرِ: ٱثْنَتَيْ عَشَرَةَ قُفَّةً مَمْلُوءةً».
فَأَكَلَ ٱلْجَمِيعُ وَشَبِعُوا هذا يدل على أن المعجزة لم يكن لها حدٌ سوى أنه لم يبق في طاقة الآكلين أن يزيدوا على ما أكلوا، فبقيت إلى أن شبع أكثرهم جوعاً. فإشباع المسيح أولئك الألوف الذين تركوا بيوتهم وأعمالهم وأتوا بلا طعام رغبة في سماع أقواله مصداق لقوله «اطْلُبُوا أَوَّلاً مَلَكُوتَ اللهِ وَبِرَّهُ، وَهذِهِ كُلُّهَا تُزَادُ لَكُمْ» (متّى ٦: ٣٣)
رَفَعُوا مَا فَضَلَ مِنَ ٱلْكِسَرِ أظهر المسيح قوته في تلك المعجزة بتكثير الطعام، وأظهر حكمته بعدها بأمر تلاميذه بجمع الكسر. لأنه لو انصرفوا من هنالك وليس لهم إلا ذكر ما شاهدوه لنسوها بعد قليل. ولكن الاثنتي عشرة قفة من الكسر التي جمعوها بأمر المسيح (يوحنا ٦: ١٢) بقيت برهاناً قاطعاً على صحة المعجزة، وأنها ليست خيالاً أو حلماً. فهكذا أمر الله أن يحفظ قسط المن في التابوت مُذكراً بالمعجزة التي جرت نحو أربعين سنة في البرية.
فأسباب أمر المسيح بجمع الكسر ثلاثة (١) التحذير من الإسراف والإغراء بالاقتصاد، أي الإنفاق على قدر الحاجة ولو في الأمور الزهيدة. و(٢) إرادته أن يبين للتلاميذ أنه لا يعولهم في المستقبل بالمعجزات، فيجب أن يتوقعوا الحصول على ما يحتاجون إليه بالوسائل العادية، ولذلك يجب أن يحفظوا الكسر. و(٣) أن تكون كل كسرة من الكسر شاهدة ما بقيت بالمعجزة ومذكرة بها، بدليل أن المسيح ذكَّر التلاميذ بعدئذٍ بمقدار الكسر الباقية في تلك المعجزة. وفي معجزة أخرى مثلها كأن مقدار تلك الكسر أمر يستحق الاعتبار والتأمل (متّى ١٦: ٩).
ٱثْنَتَيْ عَشَرَةَ قُفَّة هي القفف التي كان اليهود يحملون زادهم فيها وقت السفر. والأرجح أن كل رسول كان يجمع الكسر في قفة معه، ولذلك كانت قففهم اثنتي عشرة. فإن قيل هل كانت الكسر التي جمعوها مما كسره المسيح ولم يوزع، أو مما وُزع وفضل عن الآكلين على الأرض؟ قلنا يُحتمل الأمران. أما ما جمعوه فيُحتمل أنه وزع بعضه على المحتاجين في القرى التي دخلوها جرياً على عادة المسيح في اعتنائه بالفقراء (يوحنا ١٣: ٢٩).
٢١ «وَٱلآكِلُونَ كَانُوا نَحْوَ خَمْسَةِ آلاَفِ رَجُلٍ، مَا عَدَا ٱلنِّسَاءَ وَٱلأَوْلاَدَ».
سهل عد الرجال على التلاميذ لاتكائهم مئة مئة، وخمسين خمسين، ولكنهم لم يحسبوا عدد النساء والأولاد لأنهم كانوا أقل من الرجال لبُعد المسافة. والأغلب أن تكثير الطعام لم يحدث دفعة بل تدريجياً، فالذي شاهده الجموع أن الخبز والسمك كانا بلا انقطاع يقدمان من المسيح إلى الرسل، ومن الرسل إلى المتكئين إلى أن شبع الجميع.
هذه المعجزة تشبه ما ذكر في العهد القديم عن معجزة المن في البرية على يد موسى (خروج ١٦: ٣٦) وما ذكر في تاريخ إيليا وأليشع (١ملوك ١٧: ١٤ – ١٦ و٢ملوك ٤: ١ – ٧ و٤٢ – ٤٤). قصد المسيح أن يعلمهم المعجزة أنه هو الخبز الحقيقي لنفس الإنسان الجائعة، وأنه خبز كافٍ لتغذية كل نفوس الناس إلى الأبد.
وما أعظم الفرق بين وليمة هيرودس ووليمة المسيح. كان في الأولى رقص وبطر وسكر وأقسام محرمة، وانتهت بالقتل. وكان في الثانية تعاليم إلهية ومعجزة أظهرت الحنو الإلهي وتلاها شفاء المرضى في سهل جنيسارت (عد ٣٦).
٢٢ «َلِلْوَقْتِ أَلْزَمَ يَسُوعُ تَلاَمِيذَهُ أَنْ يَدْخُلُوا ٱلسَّفِينَةَ وَيَسْبِقُوهُ إِلَى ٱلْعَبْرِ حَتَّى يَصْرِفَ ٱلْجُمُوعَ».
اقتنع الناس من هذه المعجزة بأن يسوع هو المسيح اقتناعاً لم يشعروا به قبلها، لأنه بذلك تمت المشابهة بينه وبين موسى كما توقع الناس وعلَّم الكتبة بناءً على النبوة أن «الله يقيم لهم نبياً آخر منهم مثل موسى». ولذلك أرادوا أن يمسكوه ويجعلوه ملكاً على الرغم منه (يوحنا ٦: ١٤، ١٥). أما هو فلم يرد سلطاناً زمنياً فاعتزل عنهم إلى الجبل لكنه صرف التلاميذ أولاً ثم صرف الجموع.
أَلْزَمَ يَسُوعُ تَلاَمِيذَهُ أي أقنعهم أن يذهبوا على غير إرادتهم. فلا يبعد أنهم شاركوا الجموع في الأمل بأن يعلن نفسه ملكاً بالفعل. وصعب على التلاميذ أن ينفردوا رغبةً في فائدته وفائدتهم.
ٱلسَّفِينَة لعلها السفينة التي أتوا بها.
إِلَى ٱلْعَبْرِ أي إلى بيت صيدا غربي مكان المعجزة (مرقس ٦: ٤٥). فالتلاميذ توجهوا إليها أولاً لكنهم جاوزوها وبلغوا أرض كفرناحوم (يوحنا ٦: ١٧). ولعلهم دخلوا بيت صيدا ثم قصدوا كفرناحوم.
٢٣ «وَبَعْدَمَا صَرَفَ ٱلْجُمُوعَ صَعِدَ إِلَى ٱلْجَبَلِ مُنْفَرِداً لِيُصَلِّيَ. وَلَمَّا صَارَ ٱلْمَسَاءُ كَانَ هُنَاكَ وَحْدَهُ».
صَرَفَ ٱلْجُمُوعَ ربما اقتضى تعباً كثيراً وأنه شغل وقتاً طويلاً.
مُنْفَرِداً لِيُصَلِّيَ لا تناقض لبيان يوحنا، فهذا سبب آخر لانفراده (يوحنا ٦: ١٥). وهو أنه انفرد هرباً من أن يصيِّروه ملكاً.
لم يحتج المسيح مثلنا إلى أن يعترف بالخطايا ويطلب الغفران، لكنه صلى للذَّته بمخاطبة أبيه السماوي. وكان يومئذٍ يشفع في المؤمنين كما يشفع فيهم اليوم وهو عن يمين الله. ولعل الذي حمله يومئذٍ على كثرة التوسل من أجلهم هو توقعهم أن يكون ملكاً أرضياً، فسأل الآب أن يرشدهم إلى أن يعرفوا أن ملكه الروحي وأن يقبلوه ملكاً روحياً.
ٱلْجَبَلِ المراد بذلك الأرض المرتفعة المجاورة للبحر.
وَلَمَّا صَارَ ٱلْمَسَاءُ أي المساء الثاني (انظر تعليقنا على آية ١٥). واصطلح كتبة الأسفار الإلهية على استعمال المساء لوقتين، أحدهما من العصر إلى المغيب، والآخر من المغيب فصاعداً (خروج ١٢: ٦ و٢٩: ٣٩، ٤١ ولاويين ٢٣: ٥ وعدد ٩: ٣، ٥ و٢٨: ٤).
٢٤ «وَأَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ قَدْ صَارَتْ فِي وَسَطِ ٱلْبَحْرِ مُعَذَّبَةً مِنَ ٱلأَمْوَاجِ. لأَنَّ ٱلرِّيحَ كَانَتْ مُضَادَّةً».
هذا بيان لحال السفينة والمسيح على الشاطئ.
فِي وَسَطِ ٱلْبَحْرِ أي بعيدة عن الشاطئ نحو ٢٥ غلوة أو ثلاثين (يوحنا ٥: ١٩) وكان عرض ذلك البحر نحو ٤٠ أو ٤٥ غلوة.
مُعَذَّبَةً أي عذاب ركابها لشدة اضطراب البحر كعادته عند هبوب العواصف، زيادة على سائر أمثالها من البحار.
ٱلرِّيحَ كَانَتْ مُضَادَّةً أي كانت من الغرب فمنعت السفينة من التقدم إلى وجهتها، وجعلت الأمواج تلطم السفينة فأخذ الرسل يجذفون ومع ذلك لم يستطيعوا التقدم إلا قليلاً (مرقس ٦: ٤٨ ويوحنا ٦: ١٩). فسمح المسيح لهم أن يتضايقوا ليعلمهم أنهم بدونه لا يستطيعون شيئاً.
٢٥ «وَفِي ٱلْهَزِيعِ ٱلرَّابِعِ مِنَ ٱللَّيْلِ مَضَى إِلَيْهِمْ يَسُوعُ مَاشِياً عَلَى ٱلْبَحْرِ».
وَفِي ٱلْهَزِيعِ ٱلرَّابِعِ كان اليهود قديماً يقسمون الليل إلى ثلاثة هُزع (قضاة ٧: ١٩). ولكن بعد استيلاء الرومان على الأرض المقدسة بواسطة قائد جيوشهم بمبيوس قسموا الليل إلى أربعة هُزع، وعبروا عنها إما بالعدد أو بالأسماء، وهي: المساء، ونصف الليل، وصياح الديك، والصباح (مرقس ١٣: ٢٥). والهزيع الرابع المذكور هنا هو قبل طلوع الشمس بثلاث ساعات.
مَاشِياً عَلَى ٱلْبَحْر أي آتياً من البر إليهم على وجه الماء كأنه ماشٍ على اليابسة. وهذا من آيات لاهوته بدليل قوله «الْبَاسِطُ السَّمَاوَاتِ وَحْدَهُ، وَالْمَاشِي عَلَى أَعَالِي الْبَحْرِ» (أيوب ٩: ٨) فإن كانت مصائبنا كأمواج البحر الهائجة فلا تمنع المسيح من الإتيان إلينا.
٢٦ «فَلَمَّا أَبْصَرَهُ ٱلتَّلاَمِيذُ مَاشِياً عَلَى ٱلْبَحْرِ ٱضْطَرَبُوا قَائِلِينَ: إِنَّهُ خَيَالٌ. وَمِنَ ٱلْخَوْفِ صَرَخُوا».
خافوا من أعظم بركاتهم ونحن مثلهم في أنه عندما يأتينا الله بالمصائب لخيرنا، نخاف منها.
خَيَالٌ أي صورة لا ذات لها تنذر بالشر. وكان القدماء يظنون أرواح الموتى تظهر أحياناً للأحياء، وأن ظهورها هذا إعلان لحلول كارثة ستصيبهم.
صَرَخُوا هذا يدل على أن التلاميذ لم يزالوا كالأطفال في أنهم يخافون من الوهم، ولم يحكموا في الأمور بمقتضى العقل السليم، مع أنهم بالغون وقد تعلموا من المسيح كثيراً.
٢٧ «فَلِلْوَقْتِ قَالَ لَـهُمْ يَسُوعُ: تَشَجَّعُوا! أَنَا هُوَ. لاَ تَخَافُوا».
لم يعرفوا أنه هو المسيح حتى تكلم لأنه كان ليل. فاطمأنوا بسمع صوته المعهود وكلماته المشجعة. لا ريب في أن المسيح سمح بإرسال التلاميذ وحدهم في السفينة، كما سمح بهياج البحر وباضطرابهم وخوفهم لحكمة لا ندركها كل الإدراك. ولكننا نعلم أنه لم يتركهم زمناً طويلاً في الخطر بل بادر إلى معونتهم.
حدث قبلاً مثل هذا الاضطراب (متّى ٨: ٢٤) فعلمهم به وجوب الاتكال عليه وإن كان نائماً وظهر أنه غير منتبه لمصائبهم. وعلَّمهم بهذا الاضطراب وجوب الاتكال عليه وإن كان غائباً في الجسد باعتقادهم أنه يراقبهم دائماً، وأنه مستعدٌ كذلك لإعانتهم.
أَنَا هُوَ الخ في هذا الكلام توبيخ لطيف وتعزية كاملة، وهو يتضمن أنه حيث هو فلا خطر على تلاميذه. ونحن نستطيع أن نطمئن في كل المخاطر وفي وادي ظل الموت، لأنه يراقبنا في كل المصائب، وينادينا: «أَنَا هُوَ. لاَ تَخَافُوا».
٢٨ «فَأَجَابَهُ بُطْرُسُ: يَا سَيِّدُ، إِنْ كُنْتَ أَنْتَ هُوَ، فَمُرْنِي أَنْ آتِيَ إِلَيْكَ عَلَى ٱلْمَاءِ».
أظهر بطرس بذلك شجاعته الخاصة وغيرته المشهورة وإسراعه في الأمور وميله إلى سبق غيره. ولعله فعل ذلك ليستر ما ظهر من خوفه قبلاً. ويحتمل أن في ما قاله شيئاً من الطمع في أن يفعل ما لا يستطيع أن يفعله غيره من التلاميذ، فيظهر به إيماناً أكثر من إيمانهم.
إِنْ كُنْتَ أَنْتَ «إن» هنا للقطع لا للشك، فيكون المعنى لأنك أنت الخ.
فَمُرْنِي تكلم بالصواب لأنه يجب عليه أن يتوقع أمر المسيح قبل أن يذهب إليه على وجه الماء. فبطلب الأمر له وحده دون سائر التلاميذ أظهر نفس الميل الذي أظهره يوم قال للمسيح «وَإِنْ شَكَّ فِيكَ الْجَمِيعُ فَأَنَا لاَ أَشُكُّ أَبَدًا» (متّى ٣٦: ٣٣).
٢٩ «فَقَالَ: تَعَالَ. فَنَزَلَ بُطْرُسُ مِنَ ٱلسَّفِينَةِ وَمَشَى عَلَى ٱلْمَاءِ لِيَأْتِيَ إِلَى يَسُوعَ».
مشى المسيح على الماء معجزة. وإعطاؤه بطرس أن يفعل كذلك معجزة أخرى. وسمح لبطرس بهذا ليعلمه ما ينفعه، فكان يمشي على الماء بأمنٍ ما دام ينظر إلى المسيح ويثق به.
٣٠ «وَلٰكِنْ لَمَّا رَأَى ٱلرِّيحَ شَدِيدَةً خَافَ. وَإِذِ ٱبْتَدَأَ يَغْرَقُ صَرَخَ: يَا رَبُّ نَجِّنِي».
لما حوَّل بطرس نظره من المسيح إلى الموج وتأمل في الخطر ونسي التأمل في قوة المسيح ابتدأ يغرق. فظهر أن إيمانه أضعف مما ظن، فانهزم إيمانه أمام عيانه!
صَرَخَ قصد بطرس أن يظهر عظمة إيمانه وشجاعته فأظهر شدة خوفه وزال عنه كل جرأته وثقته. فسرعة تحوله من الشجاعة إلى الخوف جاءت متناسبة مع طبيعته، مثل قطعه أذن ملخس خادم رئيس الكهنة ثم إنكاره للمسيح بعد قليل من ذلك خوفاً من كلام جارية. فتبين من ذلك أنه كان في أول أمره ناقص الثبوت والرزانة، وصار صخراً بعد ذلك بالنعمة لا بالطبيعة.
يَا رَبُّ نَجِّنِي كان بطرس يحسن السباحة (يوحنا ٢١: ٧) لكنه يئس من النجاة بقوته لشدة اضطراب البحر يومئذٍ، فطلب مساعدة المسيح. وكانت صلاته وجيزة لا تزيد على كلمتين، لكنها كانت كافية لنوال المطلوب. وفيها إظهار الاحتياج والإيمان والغيرة، وقد وجهها إلى من يجب أن توجه إليه. نعم إن إيمان بطرس كان ضعيفاً حتى أنه أخذ يغرق، لكنه كان كافياً لأن يصرخ إلى المسيح وينجو. فتعلَّم بطرس من هذه الحادثة أن لا يسأل معجزة لا فائدة منها لأحد، فالمسيحي الحقيقي ينتظر من الله النجاة مما يصيبه، ولكن لا يعرض نفسه للخطر لكي ينقذه الله منه.
٣١ «فَفِي ٱلْحَالِ مَدَّ يَسُوعُ يَدَهُ وَأَمْسَكَ بِهِ وَقَالَ لَهُ: يَا قَلِيلَ ٱلإِيمَانِ، لِمَاذَا شَكَكْتَ؟».
لا شيء يضعف الحياة ويبدد جهودها مثل الشك، إذ نشك أولاً في قدرتنا على طلب العون، ثم نشك في نوال هذا العون لا سيما إذا أبطأ علينا ولم ننل ما نريده فنيأس من أنفسنا ومن نجاتنا. أما يسوع فحاضر دائماً، يمد يده إلينا لينجينا. فهل مددنا إليه يداً وقلنا له: يا سيد أعنا وهو وحده المعين.
لا يطلب أحد معونة المسيح عبثاً، فكان اختبار بطرس كاختبار داود الذي حمله على أن يقول «أَرْسَلَ مِنَ الْعُلَى فَأَخَذَنِي. نَشَلَنِي مِنْ مِيَاهٍ كَثِيرَةٍ» (مزمور ١٨: ١٦) وأن يقول «إِذْ قُلْتُ: قَدْ زَلَّتْ قَدَمِي فَرَحْمَتُكَ يَا رَبُّ تَعْضُدُنِي» (مزمور ٩٤: ١٨). فالمسيح وإن كان غير منظور اليوم ينشل كل مؤمن به ويعضده سريعاً، بدليل قوله في شأن رعيته «وَأَنَا أُعْطِيهَا حَيَاةً أَبَدِيَّةً، وَلَنْ تَهْلِكَ إِلَى الأَبَدِ، وَلاَ يَخْطَفُهَا أَحَدٌ مِنْ يَدِي» (يوحنا ١٠: ٢٨).
أَمْسَكَ بِهِ لم يُمسك بطرس بمخلصه ونجا، بل أمسك المخلص به ونجاه. فإمساكنا بالمسيح لا يخلصنا بل إمساكه بنا هو واسطة الخلاص.
وَقَالَ نجاه المسيح أولاً ثم وبخه.
يَا قَلِيلَ ٱلإِيمَان كان قليل الإيمان بأن المسيح يقدِّره على أن يمشي على الماء بعد ما أمره بذلك.
لِمَاذَا شَكَكْتَ لم يقل له: لماذا أتيت إليَّ؟ فلم يخطئ بأنه تعرض لأمر فوق طاقته بل بقلة إيمانه بأن المسيح يقدره عليه.
٣٢ «وَلَمَّا دَخَلاَ ٱلسَّفِينَةَ سَكَنَتِ ٱلرِّيحُ».
لم يذكر البشير أمر المسيح للريح بالسكون، ولكن القرينة تدل على ذلك، فقد تعجب الذين كانوا في السفينة كما يقول العدد التالي. وقال يوحنا إنهم قبلوه في السفينة وللوقت بلغت الشاطئ (يوحنا ٦: ٢١).
٣٣ «وَٱلَّذِينَ فِي ٱلسَّفِينَةِ جَاءُوا وَسَجَدُوا لَهُ قَائِلِينَ: بِٱلْحَقِيقَةِ أَنْتَ ٱبْنُ ٱللّٰه».
مرقس ٢: ٧ ومتّى ١٦: ١٦ و٢٦: ٦٣ ومرقس ١: ١ ولوقا ٤: ٤١ ويوحنا ١: ٤٩ و٦: ٦٩ و١١: ٢٧ وأعمال ٨: ٣٧ ورومية ١: ٤
ٱلَّذِينَ فِي ٱلسَّفِينَةِ أي التلاميذ والملاحون. وحقَّ لهم أن يتعجبوا لأن القوة التي أظهرها يسوع على الريح مما يختص بالله وحده حسب قول المرنم «فِي الْبَحْرِ طَرِيقُكَ، وَسُبُلُكَ فِي الْمِيَاهِ الْكَثِيرَةِ، وَآثارُكَ لَمْ تُعْرَفْ» (مزمور ٧٧: ١٩) فذهلوا إذ رأوا إنساناً مثلهم في المنظر متسربلاً بتلك القوة الإلهية.
أَنْتَ ٱبْنُ ٱللّٰه هذا الاسم استعمله اليهود كثيراً للمسيح الذي توقعوه. وأظهر الذين في السفينة بذلك زيادة إيمانهم باختبارهم رحمة الله وسلطان المسيح إذ رأوا الرياح والأمواج تطيعه.
يجب علينا كلما نجونا من شدة أن نجعل نجاتنا موضوع شكر، ووسيلة إلى زيادة ثقتنا بالله.
فائدة: تشبه الكنيسة وهي مضطربة من تجارب العالم واضطهاده تلك السفينة وهي مضطربة في بحر الجليل، وكثيراً ما تشعر الكنيسة بأنها متروكة كما ظن التلاميذ أن المسيح قد تركهم في تلك الليلة. وأما المسيح وهو يصلي على الجبل فافتكر في الذين في السفينة، وأتى إليهم حين بلغ الخطر أشدَّه. وهكذا يفعل المسيح الآن، فإنه يشفع في كنيسته في السماء يأتي إلى معونتها على الأرض، وبإتيانه يحول كل خوف وخطر وضيق إلى أمن وسلام واطمئنان.
٣٤ «فَلَمَّا عَبَرُوا جَاءُوا إِلَى أَرْضِ جَنِّيسَارَتَ».
تثنية ٣: ١٧ و١ملوك ١٥: ٢٠ ومتّى ٤: ١٨ ومرقس ٦: ٥٣ ولوقا ٥: ١ ويوحنا ٢١: ١
عَبَرُوا أي بحر الجليل.
أَرْضِ جَنِّيسَارَت هي سهل على الجانب الغربي من ذلك البحر طوله أربعة أميال وعرضه ميل، ولذلك أضيف إليه البحر أحياناً (لوقا ٥: ١). قال يوسيفوس إن ذلك السهل خصيب كجنة وبهيج جداً وكثير السكان. وكانت كفرناحوم على طرفه الشمالي الشرقي، ولذلك قال يوحنا في الكلام عن هذه الحادثة إن المسيح وتلاميذه جاءوا إلى كفرناحوم (يوحنا ٦: ١٧) ولا بد أنهم مروا ببيت صيدا قبلاً لأنها كانت على طريقهم (مرقس ٦: ٤٥). ولما بلغوا كفرناحوم وأرض جنيسارت دار الحديث بين المسيح والذين شاهدوا معجزة الأرغفة في معناها الروحي (يوحنا ٦: ٢٢ – ٦٥).
٣٥ «فَعَرَفَهُ رِجَالُ ذٰلِكَ ٱلْمَكَانِ. فَأَرْسَلُوا إِلَى جَمِيعِ تِلْكَ ٱلْكُورَةِ ٱلْمُحِيطَةِ وَأَحْضَرُوا إِلَيْهِ جَمِيعَ ٱلْمَرْضَى».
عرفه أهل تلك البلاد لأنه صرف مدة طويلة بينهم.
٣٦ «وَطَلَبُوا إِلَيْهِ أَنْ يَلْمِسُوا هُدْبَ ثَوْبِهِ فَقَطْ. فَجَمِيعُ ٱلَّذِينَ لَمَسُوهُ نَالُوا ٱلشِّفَاءَ».
متّى ٩: ٢٠ ومرقس ٣: ١٠ ولوقا ٦: ١٩ وأعمال ١٩: ١٢.
هذا ليس تكراراً لقول البشير في متّى ٨: ١٦ لأن هذه حادثة غير تلك، وقصد متّى بذكرها أن يبين أن المسيح كان يصنع في كل زمن خدمته الأرضية معجزات لم يذكر الإنجيليون سوى قليل منها.
يَلْمِسُوا هُدْبَ ثَوْبِهِ شفوا بلمسهم إياه لأنهم لمسوه بإيمان، ولعلهم أخذوا ذلك عن المرأة نازفة الدم لأن خبرها كان قد شاع هناك (متّى ٩: ٢٠ – ٢٢). وكان في سلطان المسيح أن يشفيهم بكلمة على البُعد، لكنه سُر بأن يصاحب الشفاء شيء من عملهم، كمدِّ أيديهم إليه علامة الإيمان به. فيا ليت كل مرضى الخطية الآن يرغبون في المسيح رغبة الإيمان كأولئك، لأن الناس في كل أرض لا في أرض جنيسارت وحدها يستطيعون أن يلمسوا هدب ثوبه بالإيمان، فيجدوا شفاءً لا موت بعده إلى الأبد.


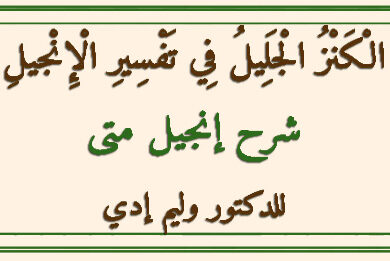
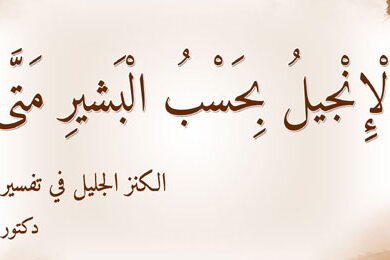
 العربية
العربية 简体中文
简体中文 Nederlands
Nederlands English
English Français
Français Deutsch
Deutsch Ελληνικά
Ελληνικά Gaeilge
Gaeilge Italiano
Italiano 한국어
한국어 كوردی
كوردی Português
Português Русский
Русский Español
Español