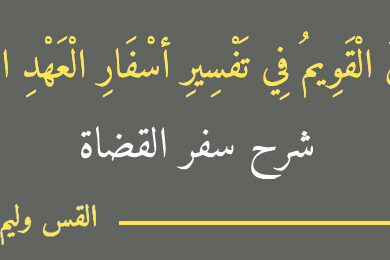سفر القضاة | 06 | السنن القويم
السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم
شرح سفر القضاة
للقس . وليم مارش
اَلأَصْحَاحُ ٱلسَّادِسُ
مضمون هذا الأصحاح عشر حوادث:
- ارتداد بني إسرائيل ودفع الله إياهم إلى يد مديان عقاباً لهم على ارتدادهم (ع ١ – ٦).
- توبيخ نبيٍّ لهم (ع ٧ – ١٠).
- ظهور ملاك لجدعون وأمره إياه بإنقاذ إسرائيل (ع ١١ – ٢٠).
- إزالة الملاك شكوك جدعون (ع ١١ – ١٨).
- تقدمة جدعون للملاك وتواري الملاك عن عينيه (ع ١٩ – ٢٣).
- بناء جدعون مذبح «يهوه شلُّوم» (٢٤).
- هدم جدعون مذبح البعل الذي لأبيه وقطع السارية عنده (ع ٢٥ – ٢٧).
- طلب أهل المدينة من يوآش تسليم ابنه جدعون وفصله الخطاب بأن البعل ينتقم لنفسه (ع ٢٨ – ٣٢).
- دعوة جدعون منسى وأشير وزبولون ونفتالي إلى مؤازرته في الحرب (ع ٣٣ – ٣٥).
- آية الجزّة (ع ٣٦ – ٤٠).
إذلال مديان للإسرائيليين ع ١ إلى ٦
١ «وَعَمِلَ بَنُو إِسْرَائِيلَ ٱلشَّرَّ فِي عَيْنَيِ ٱلرَّبِّ، فَدَفَعَهُمُ ٱلرَّبُّ لِيَدِ مِدْيَانَ سَبْعَ سِنِينَ».
ص ٢: ١٩ حبقوق ٣: ٧
وَعَمِلَ بَنُو إِسْرَائِيلَ ٱلشَّرَّ بعد أن استراحوا أربعين سنة (ص ٥: ٣١) حملتهم الراحة على نسيان الرب فارتكبوا الشر وهو قلة ثقتهم بالله والالتفات إليه وخوفهم آلهة الأمم الباطلة (ع ١٠). وقد تضرّ الراحة بالدنيويين والأمن بقليلي الإيمان. وكان هذا دأب الإسرائيليين يُضايَقون فيتوبون ويرحّب لهم فيرتدون فأشبهوا نبتة في مهب الريح متقطعة (ص ٢: ١١ و٣: ١٢ و٤: ١). وهذا شأن أكثر الناس لا يذكرون ربهم إلا عند حلول البلاء. وعبّر عن مخالفة الله «بالشر» لأنها تجلب الشر على المخالفين. والشر هنا نقيض الخير ولهذا جاء بمعنى الإثم والرذيلة والفساد والظلم.
فِي عَيْنَيِ ٱلرَّبِّ «لأَنَّ طُرُقَ ٱلْإِنْسَانِ أَمَامَ عَيْنَيِ ٱلرَّبِّ» (أمثال ٥: ٢١). ولأنه «فِي كُلِّ مَكَانٍ عَيْنَا ٱلرَّبِّ مُرَاقِبَتَيْنِ ٱلطَّالِحِينَ وَٱلصَّالِحِينَ» (أمثال ١٥: ٣).
فَدَفَعَهُمُ ٱلرَّبُّ تأديباً لهم وتنبيهاً على خطاياهم وعبادتهم الأصنام والشهوات لكي يرجعوا إليه ويحصلوا على رضاه ونعمه الوافرة فهو لوفرة رحمته لا يُمرض إلا للشفاء ولا يجرح إلا للبرء لا لشفاء الغيظ كآلهة الأمم القاسية الشريرة فإن «ٱلرَّبَّ صَالِحٌ، لأَنَّ إِلَى ٱلأَبَدِ رَحْمَتَهُ» (مزمور ١٠٦: ١).
مِدْيَانَ أي بني مديان وهو أحد أبناء إبراهيم من قطورة (تكوين ٢٥: ١ و٢) ونسله عدة قبائل من عرب البادية شغلت السهول التي شرقي موآب وكانوا كثيري العدد والبهائم (انظر عدد ٣١: ١ الخ). والراجح أن المديانيين المذكورين هنا القبائل التي كانت في الجنوب الشرقي من خليج العقبة (١ملوك ١١: ١٨). وعاش موسى بين المديانيين أربعين سنة (خروج ٣: ١). وقيل في (خروج ٣: ١) إن موسى ساق الغنم إلى جبل حوريب فنستنتج أن المديانيين رعوا مواشيهم شرقي خليج العقبة وغربيه أيضاً وأحياناً يُطلق الاسم مديانيون على قبائل أخرى (قضاة ٨: ٢٤). والإسرائيليون مُنعوا من مصادقتهم لأنهم ضلوا عن الإله الحق وعبدوا بعل فغور بإغواء بلعام وكان ما كان من أمر المديانية (عدد ٢٥: ١ – ١٨). والعرب يسمون مديان مِدين. وكان موسى قد استأصل قسماً منهم منذ ٢٠٠ سنة قبل زمان هذه الحادثة (عدد ٣١: ١ – ١٢) لكنهم بعد مدة نشطوا وأصحلوا شؤونهم ورجعوا إلى أرضهم بعد أن هجروا وأقاموا بها ونموا وصاروا من أهل القوة والثراء فقووا على جيرانهم الإسرائيليين لضعفهم بما ارتكبوه من الآثام وعاهدوا العمالقة لينتقموا لنفوسهم من غالبيهم القدماء وأقاموا بحدود البحر الأحمر الشرقية وجعلوا عاصمتهم أرنون. وظنّ بعضهم أن البدويين في تلك الأرض بقية منهم. أما قول بعضهم إن البدويين محرّف المديانيين فخطأ أظهر من أن يبين فإن البدويين منسوبون إلى البدو وهو البرية أو الصحراء لأنهم يسكنون البرية في بيوت الشعر والجلود والخيام وينتقلون من بقعة إلى أُخرى كما هو المشاهد اليوم من عرب البادية ويسمون سكان القرى والمدن بالحضريين نسبة إلى الحضر وهو ضدّ البدو.
٢ «فَٱعْتَزَّتْ يَدُ مِدْيَانَ عَلَى إِسْرَائِيلَ. بِسَبَبِ ٱلْمِدْيَانِيِّينَ عَمِلَ بَنُو إِسْرَائِيلَ لأَنْفُسِهِمِ ٱلْكُهُوفَ ٱلَّتِي فِي ٱلْجِبَالِ وَٱلْمَغَايِرَ وَٱلْحُصُونَ».
١صموئيل ١٣: ٦ عبرانيين ١١: ٣٨
فَٱعْتَزَّتْ يَدُ مِدْيَانَ عَلَى إِسْرَائِيلَ أي لأن الرب دفع الإسرائيليين إلى يد المديانيين اعتزت يد المديانيين على الإسرائيليين فالفاء سببية. ومعنى اعتزت على إسرائيل غلبتهم وأسند الفعل إلى اليد لأنها هي التي يُحمل بها السلاح في القتال وهي الآلة الأولى للمحراب. وعلى هذا جاءت بمعنى القدرة والسلطة واستعمالها هنا مجاز مرسل من استعمال الجزء بمعنى الكل.
بِسَبَبِ ٱلْمِدْيَانِيِّينَ عَمِلَ بَنُو إِسْرَائِيلَ لأَنْفُسِهِمِ ٱلْكُهُوفَ ٱلَّتِي فِي ٱلْجِبَالِ الكهوف جمع كهف وهو المغارة. والكهوف قسمان طبيعية وصناعية فالطبيعية ما أحدثته السيول والنيران الأرضية وغيرها من الحوادث الطبيعية والصناعية ما صنعته الناس والبهائم. والظاهر من نص الآية أن الكهوف المذكورة من صنع الإسرائيليين ما لم يكن معنى العمل هنا إعداد الكهوف ملاجئ لهم مع عمل شيء فيه من توسيع أو ترتيب وأحداث بعضها ولعل هذا هو الأرجح لأن الملتجئ إذا وجد الملجأ لا يكلف نفسه عمل غيره. وكانت الكهوف ملاجئ المظلومين والمضطهدين في كل عصر (١ملوك ١٨: ٤ و١٩: ٩ وعبرانيين ١١: ٣٨). وقوله «في الجبال» يدل على أن الإسرائيليين هربوا من السهول (١صموئيل ١٣: ٦) إليها بعد أن كانوا فيها أربعين سنة.
وَٱلْحُصُونَ الحصون هنا أماكن منيعة يتعسر الوصول إلى جوفها.
وكان الإسرائيليون يلجأون إلى تلك المخابئ زمن الجور والاضطهاد ويجمعون فيها بعض الغلال خوفاً من أن ينهبها المديانيون والعمالقة كما يدل عليه الكلام الآتي.
٣ «وَإِذَا زَرَعَ إِسْرَائِيلُ كَانَ ٱلْمِدْيَانِيُّونَ وَٱلْعَمَالِقَةُ وَبَنُو ٱلْمَشْرِقِ يَصْعَدُونَ عَلَيْهِمْ».
ص ٣: ١٣ تكوين ٢٩: ١ وص ٧: ١٢ و٨: ١٠ و١ملوك ٤: ٣٠ وأيوب ١: ٣
وَإِذَا زَرَعَ إِسْرَائِيلُ ونبت زرعهم ونما وأحصد كله أو بعضه أي حان أن يُحصد. «وإذا» متعلقة بقوله «كان» بعد هذه العبارة.
كَانَ يَصْعَد ٱلْمِدْيَانِيُّونَ أي كانوا يهجمون عليهم ويقصدون زروعهم في السهول المجاورة للجبال لأنهم تركوا السهول خوفاً من أولئك ومن حالفهم. وتقدّم الكلام على المديانيين في تفسير (ع ١).
وَٱلْعَمَالِقَةُ (انظر تفسير ص ٣: ١٣).
وَبَنُو ٱلْمَشْرِقِ هم قبائل من عرب البادية آزروا المديانيين والعمالقة بغية السلب والسبي وهم سلالات أبناء إبراهيم من هاجر وقطورة وسلالة لوط فهم خليط من الإسماعيليين والموآبيين والعمونيين وكانوا في شرقي فلسطين وجنوبيها وأكثرهم في المشرق وذُكروا في عدة مواضع من الكتاب (انظر ص ٧: ١٢ و٨: ١٠ و١١ وتكوين ٢٩: ١ وأيوب ١: ٣ وحزقيال ٢٥: ٤). وكانوا منتشرين من فلسطين إلى تهامة وغيرها من بلاد العرب. وكانوا كالوحوش لا يهمهم شيء كالنهب والسلب على أن قليليين منهم كانوا يخافون الله في العصور الخالية قبل هذه الحادثة كأيوب وأقربائه.
٤ «وَيَنْزِلُونَ عَلَيْهِمْ وَيُتْلِفُونَ غَلَّةَ ٱلأَرْضِ إِلَى مَجِيئِكَ إِلَى غَزَّةَ، وَلاَ يَتْرُكُونَ لإِسْرَائِيلَ قُوتَ ٱلْحَيَاةِ، وَلاَ غَنَماً وَلاَ بَقَراً وَلاَ حَمِيراً».
لاويين ٢٦: ١٦ وتثنية ٢٨: ٣٠ و٣٣ و٥١ وميخا ٦: ١٥
وَيَنْزِلُونَ عَلَيْهِمْ إلى أرض الزروع السهلية لا قصد الحرب بل قصد النهب والسلب كعادة عرب البادية إلى هذا اليوم لكن كانوا يقتلون من تصدى لدفعهم أو منعهم.
وَيُتْلِفُونَ غَلَّةَ ٱلأَرْضِ بحصد ما يحصدون وبترك جمالهم وحميرهم في الحقول.
إِلَى مَجِيئِكَ إِلَى غَزَّةَ أي من الأردن إلى غزة. والظاهر أن المديانيين وأحلافهم كانوا يدخلون أرض إسرائيل من مخاوض الأردن قرب بيت شان المعروفة اليوم ببيسان ويقصدون السهول الخصبة المجاورة الجبال وشاطئ البحر وينهبون ويسلبون إلى أن يصلوا إلى غزّة وهي الحد الأقصى لأرض إسرائيل (١ملوك ٤: ٢٤).
وَلاَ يَتْرُكُونَ لإِسْرَائِيلَ قُوتَ ٱلْحَيَاةِ أي لا يتركون لهم ما هو ضروري لحياتهم من الغلال أو ما يمسكون به الرمق. فكانوا إن مانعوهم قتلوهم سريعاً وإن تركوهم ماتوا جوعاً أو عاشوا عيشة هي بين الموت والحياة.
وَلاَ غَنَماً وَلاَ بَقَراً وَلاَ حَمِيراً لأن عرب البادية ينتفعون بهذه البهائم كثيراً كما ينتفعون بالجمال. وهذا شأنهم إلى اليوم مع أهل الزراعة حيث لا رادع لهم. فلا يبقون للإسرائيليين خبزاً ولا لبناً ولا لحماً ولا ما لا يستطيعون الحرث بدونه. فقد وقع على الإسرائيليين ما أنذورا به (انظر لاويين ٢٦: ١٦ و١٧ و٢٦ وتثنية ٢٨: ٣٣ و٥١).
٥ «لأَنَّهُمْ كَانُوا يَصْعَدُونَ بِمَوَاشِيهِمْ وَخِيَامِهِمْ وَيَجِيئُونَ كَٱلْجَرَادِ فِي ٱلْكَثْرَةِ وَلَيْسَ لَهُمْ وَلِجِمَالِهِمْ عَدَدٌ، وَدَخَلُوا ٱلأَرْضَ لِيُخْرِبُوهَا».
ص ٧: ١٢
لأَنَّهُمْ كَانُوا أي المديانيون والعمالقة وبنو المشرق (ع ٤).
يَصْعَدُونَ بِمَوَاشِيهِمْ المواشي جمع ماشية وهي المقتنيات من الجمال والغنم وبعضهم أطلقها على الغنم والإبل والبقر والظاهر أن المراد بها هنا كل ما يقتنى من البهائم.
وَخِيَامِهِمْ بيوت البدو كالبيوت المعروفة عند أهل البادية اليوم والمقتنى ما يجمعه الإنسان لنفسه ومعظم مقتنى أهل البادية المواشي من الجمال والبقر والغنم.
كَٱلْجَرَادِ فِي ٱلْكَثْرَةِ ذكر وجه الشبه إذ لم يرد من التشبيه سوى الكثرة ليُري ضعف اليهود عن دفعهم أولئك الظالمين وإلا فهم كانوا كالجراد في الكثرة وفي الإتلاف كما ذُكر في الآية الرابعة. وأحياناً الجراد يحجب ضوء الشمس كأنه غيم مطبق. وفي حمص السنة ١٩٠٨ غطى الجراد وجه نهر العاصي والأرضين هناك وقد ترك الأشجار عارية من الأوراق فيبس كثير منها وأخلى الأرض من الأعشاب حتى صارت المروج كالفلوات. وعمل الجراد أكثر من هذا في كل سورية السنة ١٩١٥.
وَلَيْسَ لَهُمْ وَلِجِمَالِهِمْ عَدَدٌ أي يتعسر عدهم أو يتعذر للكثرة وعرب البادية يكثرون من الجمال لأنها مراكبهم في الأسفار وهم يغتذون بألبانها ولحومها وينتفعون بأوبارها. وهي تصبر على العطش في الفلوات ومنافعها كثيرة لهم. وفلسطين لم تكن موطن الجمال فكانوا يأتون بها من المشرق بالغزو والنهب.
٦ «فَذَلَّ إِسْرَائِيلُ جِدّاً مِنْ قِبَلِ ٱلْمِدْيَانِيِّينَ. وَصَرَخَ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى ٱلرَّبِّ».
ص ٣: ١٥ وهوشع ٥: ١٥
فَذَلَّ إِسْرَائِيلُ جِدّاً مِنْ قِبَلِ ٱلْمِدْيَانِيِّينَ الذل ضد العزّ أي فصاروا من العزّ إلى الذل والهوان فافتقروا وساء عيشهم ولهذا جاء في الترجمة السبعينية «فرد إسرائيل إلى الفقر». وقوله «من قِبَل المديانيين» في العبرانية «من وجه المديانيين» من أعمالهم التي يواجهونهم بها من إهانة ونهب وسلب وإتلاف.
وَصَرَخَ بَنُو إِسْرَائِيلَ وفي العبرانية «زعق بنو إسرائيل» أي صرخوا صراخاً عالياً دليلاً على شدة بؤسهم وهذا دأبهم عند نزول البلاء ودأب أكثر الناس (انظر ص ٣: ٩ و١٥ و٤: ٣).
٧، ٨ «٧ وَكَانَ لَمَّا صَرَخَ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى ٱلرَّبِّ بِسَبَبِ ٱلْمِدْيَانِيِّينَ ٨ أَنَّ ٱلرَّبَّ أَرْسَلَ نَبِيّاً إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَقَالَ لَهُمْ: هٰكَذَا قَالَ ٱلرَّبُّ إِلٰهُ إِسْرَائِيلَ: إِنِّي قَدْ أَصْعَدْتُكُمْ مِنْ مِصْرَ وَأَخْرَجْتُكُمْ مِنْ بَيْتِ ٱلْعُبُودِيَّةِ».
نَبِيّاً لم يسمه الكتاب لكن اليهود يقولون إنه فينحاس بن العازار بن هارون.
إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ولعلهم كانوا حينئذ مجتمعين للاحتفاء ببعض الأعياد.
أَصْعَدْتُكُمْ (قابل بما في ص ٢: ١ – ٣ و٢ملوك ١٧: ٣٦ – ٣٨).
مِنْ بَيْتِ ٱلْعُبُودِيَّةِ الإشارة هنا إلى ما في (خروج ٢٠: ٢ قابل هذا بما في مزمور ٤٤: ١ و٢).
٩ «وَأَنْقَذْتُكُمْ مِنْ يَدِ ٱلْمِصْرِيِّينَ وَمِنْ يَدِ جَمِيعِ مُضَايِقِيكُمْ، وَطَرَدْتُهُمْ مِنْ أَمَامِكُمْ وَأَعْطَيْتُكُمْ أَرْضَهُمْ».
مزمور ٤٤: ٢ و٣
طَرَدْتُهُمْ مِنْ أَمَامِكُمْ الخ أي سقتهم أمامكم والمعنى أن الله هو الذي دفع الأمم عن إسرائيل وملكهم الأرض لا هم (مزمور ٤٤: ٢ و٣).
١٠ «وَقُلْتُ لَكُمْ: أَنَا ٱلرَّبُّ إِلٰهُكُمْ. لاَ تَخَافُوا آلِهَةَ ٱلأَمُورِيِّينَ ٱلَّذِينَ أَنْتُمْ سَاكِنُونَ أَرْضَهُمْ. وَلَمْ تَسْمَعُوا لِصَوْتِي».
٢ملوك ١٧: ٣٥ و٣٧ و٣٨ وإرميا ١٠: ٢
لاَ تَخَافُوا آلِهَةَ ٱلأَمُورِيِّينَ معنى الأموريين الجبليين لأنهم كانوا في الأرض الجبلية بين نهر الأردن والبحر المتوسط قبل دخول الإسرائيليين أرض كنعان لكنهم لم يكتفوا بتلك الأرض فاختاروا أخصب الأرضين في كنعان وهي الأرض التي بين نهر أرنون ونهر يبوق والأردن وكانوا أكثر الكنعانيين عداوة للإسرائيليين وأشدهم بغضاً لهم. واشتهروا بطول القامة (عاموس ٢: ٩). وهم أمة من الكنعانيين. وقد يُطلق اسمهم على كل الكنعانيين (يشوع ٢٤: ١٥). وعلى هذا يصح أن المراد بآلهة الأموريين آلهة الكنعانيين.
وقوله «لا تخافوا» دلّ على أنهم اتقوها كما يتقي المخلوق الخالق وهذا الجهل كله وما يؤدي إلى شر العواقب. «وَبَيْنَمَا هُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ حُكَمَاءُ صَارُوا جُهَلاَءَ، وَأَبْدَلُوا مَجْدَ ٱللّٰهِ ٱلَّذِي لاَ يَفْنَى بِشِبْهِ صُورَةِ ٱلْإِنْسَانِ… لِذٰلِكَ أَسْلَمَهُمُ ٱللّٰهُ الخ» (رومية ١: ٢٢ – ٢٦). وأرسل الله إليهم نبياً وبخهم على عملهم وبيّن لهم فظاعة إثمهم ليتوبوا إلى الله ولم يبشرهم بالإنقاذ إذ لا إنقاذ بلا توبة. فكانت غاية الله من تسليمهم إلى الأعداء وإذلالهم وتوبيخهم بواسطة نبي جذبهم إليه لكي يخلصهم. وهذه العناية من مسببات الحكمة الأزلية والرحمة الأبدية ولكن كثيرون من الناس لا يعقلون ويتذمرون على الله وهو يحسن إليهم بتدبيره الأمور.
لَمْ تَسْمَعُوا لِصَوْتِي أي لم تطيعوني وتحفظوا وصاياي لتدوم لكم النعم.
١١ «وَأَتَى مَلاَكُ ٱلرَّبِّ وَجَلَسَ تَحْتَ ٱلْبُطْمَةِ ٱلَّتِي فِي عَفْرَةَ ٱلَّتِي لِيُوآشَ ٱلأَبِيعَزَرِيِّ. وَٱبْنُهُ جِدْعُونُ كَانَ يَخْبِطُ حِنْطَةً فِي ٱلْمِعْصَرَةِ لِيُهَرِّبَهَا مِنَ ٱلْمِدْيَانِيِّينَ».
يشوع ١٨: ٢٣ يشوع ١٧: ٢ عبرانيين ١١: ٣٢
وَأَتَى مَلاَكُ ٱلرَّبِّ ظن بعضهم أن المراد «بملاك الرب» هنا الرجل النبي الذي ذُكر في (ع ٨) وهو خطأٌ فإن ما في الآية الثامنة في العبراني «إيش نبياً» أي رجلاً نبياً وما في الآية الحادية عشرة فيه «ملاك يهوه» أي ملاك الرب. نعم إن ملاك الرب ظهر بصورة بشرية كعادة الله في إعلان الملائكة للخلق وإلا ما استطاع الناس أن يروهم (انظر تكوين ١٨: ٢ ويشوع ٥: ١٣). وكان المسيحيون القدماء يرون أن هذا الملاك ابن الله ملاك العهد (خروج ٢٣: ٢ و٢٣ و٣٣: ٢) ولما ظهر مذهب آريوس عدل الآباء المسيحيون عن تفسير ذلك الملاك بالمسيح خوفاً من أن ذلك يُضعف الإيمان بلاهوت المسيح. ثم رجع إليه اللاهوتيون المحدثون. وسُمي أيضاً «ملاك العهد» (ملاخي ٣: ١) و«ملاك الحضرة» (إشعياء ٦٣: ٩). وأشار إلى هذا الاسم يوحنا الرسول بقوله «اَللّٰهُ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ قَطُّ. اَلابْنُ ٱلْوَحِيدُ ٱلَّذِي هُوَ فِي حِضْنِ ٱلآبِ هُوَ خَبَّرَ» (يوحنا ١: ١٨) لأن قوله «في حضن الآب» يلزم منه أنه في حضرته. والخلاصة أن ذلك الملاك ليس بإنسان ولا بروح مخلوق لكنه ابن الله نفسه الكلمة الأزلية رب الملائكة الذي سجدت له كل ملائكة الله (عبرانيين ١: ٦) ظهر يومئذ في صورة بشرية ثم ظهر في ملء الزمان إنساناً كاملاً مولوداً من امرأة تحت الناموس (غلاطية ٤: ٤) ومن البراهين على ذلك ما جاء في (ع ١٤ – ١٦) من أنه هو الرب «يهوه» وإنه قال لجدعون «إني أكون معك».
جَلَسَ تَحْتَ ٱلْبُطْمَةِ البطم شجر من الفصيلة السماقية يكثر في سورية وفلسطين ويعمر وقد يكثر كثيراً. وهو سبط الأوراق وثمره حب كحب الفلفل وله عناقيد كعناقيده. وكانت هذه البطمة يومئذ معهودة للجميع على جانب المذبح في عفرة.
عَفْرَةَ قرية كانت ليوآش الأبيعزري في نصيب منسى الغربي قرب شكيم المعروفة اليوم بنابلس.
لِيُوآشَ ٱلأَبِيعَزَرِيِّ نُسب إلى أبيعزر لأنه من نسله وكان رأس أسرة من ذلك النسل. وأبيعزر هو ابن جلعاد بن ماكير بن منسى (عدد ٢٦: ٣٠ ويشوع ١٧: ٢). وسُمي في سفر العدد «إيعزر» وفي سفر يشوع «أبيعزر» وجاء في (١أيام ٧: ١٨) اسم «أبيعزر» وفيه أنه ابن همولكة أخت جلعاد. ولعل همولكة سمت ابنها باسم ابن أخيها كما يكثر ذلك بين الأقرباء. فيوآش كان من سبط منسى ومسكنه بينهم.
وَٱبْنُهُ جِدْعُونُ كَانَ يَخْبِطُ حِنْطَةً فِي ٱلْمِعْصَرَةِ أي كان يضرب سنابل الحنطة بالعصا ضرباً شديداً ليخلّص الحب منها. كان هذا يأتيه الفقراء الذين لا بهائم لهم ولا أدوات للدراس وسنابلهم من أرض صغيرة يزرعونها أو سنابل يلتقطونها وراء الحاصدين والظاهر من الحديث في هذا الأصحاح أن هذه السنابل كانت بقية مما نهبه أهل البدو الكنعانيين من غلال الإسرائيليين (انظر ع ٣ و٤) والمعصرة المكان الذي يُداس فيه العنب لإخراج عصيره والمرجّح أن هذه المعصرة كانت في كهف أو غار أتى ذلك فيها لكي لا يراه الناهبون فيقصدونه وينهبون ما بين يديه. فانظر إلى الحال التي صار إليها الإسرائيليون من تركهم الرب. إنهم صاروا إلى جهد البلاء وهي الحال التي يؤثر فيها الموت على الحياة تنبيهاً لهم على ضلالهم ليرجعوا إلى ربهم الذي أنقذهم من أرزاء كثيرة في ما سلف من الدهر. ولكن خطأ الإسرائيليين ليس بعذر للأمم التي ظلمتهم من الكنعانيين وغيرهم كالمديانيين هنا فإن أولئك ظلموهم لا حباً لله ولا بغية تأديبهم بل طمعاً في أموالهم وبغضاً لهم والله يضربهم وضربهم أكثر مما ضرب الإسرائيليين. ومعنى جدعون مُحَطَّب وسمي أيضاً «يربَّعل» أي يقاتل بعل (ع ٣٢). وكان شجاعاً مكرماً وتقياً متواضعاً (انظر ع ١٤ و١٥) وهو القاضي الخامس للإسرائيليين.
لِيُهَرِّبَهَا مِنَ ٱلْمِدْيَانِيِّينَ خبط جدعون السنابل في الخفاء ليذهب بها خفية ويخبأها في غار أو المخابئ. وكان يهون على جدعون أن يهرب بتلك الحنطة ليحفظها من المديانيين لأنها مقدار قليل. إن ضربة الشعب لكثرة ما فيه من الأشرار تلم بالأخيار فضربة أهل سدوم خسّرت لوطاً البار وأتعبته. وضربة الله للإسرائيليين هنا عذّبت جدعون التقي وكلفته مشقات وأخطاراً كثيرة. فالأثيم يسيء إلى نفسه وإلى غيره ويغيظ الله بالإساءتين.
١٢ «فَظَهَرَ لَهُ مَلاَكُ ٱلرَّبِّ وَقَالَ لَهُ: ٱلرَّبُّ مَعَكَ يَا جَبَّارَ ٱلْبَأْسِ!».
ص ١٣: ٣ ولوقا ١: ١١ و٢٨ يشوع ١: ٥
فَظَهَرَ لَهُ مَلاَكُ ٱلرَّبِّ بهيئة إنسان فإن الملائكة كثيراً ما تحضر ولا تظهر لأنهم أرواح لا تدركهم الأبصار إلا يلبسهم صورة مرئية (انظر عدد ٢٢: ٣١ و٢صموئيل ٢٤: ١٧ و٢ملوك ٦: ١٧).
ٱلرَّبُّ مَعَكَ هذه عبارة تحية لا تزال في الشرق إلى هذا اليوم. وتُرجمت العبارة في الكلدانية «كلمة الرب معك» وما في ترجمتنا على وفق الأصل العبراني «يهوه عمك» ويصح أن تكون الجملة خيرية لا دعائية والمعنى أنه هو الرب وهو معه حينئذ ليساعده ويرشده كا يظهر من جواب جدعون له (ع ١٣).
يَا جَبَّارَ ٱلْبَأْسِ هذا يدل على أن جدعون كان قبل هذه الحادثة مشهوراً بالشجاعة والقوة. والله كثيراً ما يختار مَن هم أهلٌ للأمر الذي يختارهم له على أنه تعالى قد يختار الضعفاء لما لا يستطيعه إلا الأقوياء لكنه يمنحهم القوة عليه. والأمر الذي اختار له جدعون وهو إنقاذ الإسرائيليين من عبودية المديانيين وظلمهم يقتضي القوة والشجاعة.
١٣ «فَقَالَ لَهُ جِدْعُونُ: أَسْأَلُكَ يَا سَيِّدِي، إِذَا كَانَ ٱلرَّبُّ مَعَنَا فَلِمَاذَا أَصَابَتْنَا كُلُّ هٰذِهِ، وَأَيْنَ كُلُّ عَجَائِبِهِ ٱلَّتِي أَخْبَرَنَا بِهَا آبَاؤُنَا قَائِلِينَ: أَلَمْ يُصْعِدْنَا ٱلرَّبُّ مِنْ مِصْرَ؟ وَٱلآنَ قَدْ رَفَضَنَا ٱلرَّبُّ وَجَعَلَنَا فِي كَفِّ مِدْيَانَ».
مزمور ٨٩: ٤٩ وإشعياء ٥٩: ١ و٦٣: ١٥ مزمور ٤٤: ١ و٢أيام ١٥: ٢
إِذَا كَانَ ٱلرَّبُّ مَعَنَا فَلِمَاذَا أَصَابَتْنَا كُلُّ هٰذِهِ أي هذه النوازل أو المصائب وهذا يُقال جواباً لخبر لا لدعاء. وجدعون لم يشك في أن الرب قادر ولكنه شك في أنه معه واعتقد أنه رفض شعبه وإلا ما ترك الإسرائيليين لما وقع عليهم من الأعداء والملاك قال هل «الرب معك» لا معكم. فقال جدعون «إذا كان معنا» لا معي لأن المصاب وقع عليه وعلى كل إسرائيل فلو كان معه لكان مع كل شعبه لأن الضربة على الجميع فالبركة على الجميع وقد حسب جدعون نفسه وسائر إسرائيل واحداً أو كأنه قال إذا كان شعبي في هذا المصاب فالرب ليس معي ولا مع شعبي لأن مصابه مصابي.
أَيْنَ كُلُّ عَجَائِبِهِ ٱلَّتِي أَخْبَرَنَا بِهَا آبَاؤُنَا لم يكذب جدعون أخبار الآباء بعجائب الرب لإسرائيل سابقاً بل نفى وقوع مثلها له ولشعبه ليثبت أن الرب رفض شعبه فكأنه قال إن الله على كل شيء قدير وقد صنع العجائب للشعب حين كان معه واليوم لم يصنع منها شيئاً فما علة ذلك إلا أنه تعالى رفض شعبه.
أَلَمْ يُصْعِدْنَا ٱلرَّبُّ مِنْ مِصْرَ أي قد أصعدنا من مصر بقوّة وأنقذنا من عبودية الظالمين لأنه كان معنا واليوم لم ينقذنا من عبودية المديانيين.
ٱلآنَ قَدْ رَفَضَنَا هذه هي الدعوى وقد أقام جدعون على إثباتها الأدلة القاطعة لأن الرب تركهم حقيقة لكي يؤدبهم وينبههم على ضلالهم ليرجعوا إليه.
وَجَعَلَنَا فِي كَفِّ مِدْيَانَ أي سلّط علينا المديانيين فصرنا ملكاً لهم يتصرفون بنا كما يتصرف الإنسان بما في يده. لم يتكلم جدعون إلا بالحق والواقع ولم يلُم الله على ذلك فالظاهر أنه كان يعلم إن آثامهم فرّقت بينهم وبين ربهم والملاك لم يكذبه بشيء لأنه صدق بكل ما قاله. نعم يُلام جدعون على أنه شك في قول ملاك العهد الرب لكن يُعتذر عنه بأنه لم يعرفه في أول الأمر وظنه واحداً من الناس كما يدل عليه ما يأتي من الآيات (انظر ع ١٧ – ٢٢).
١٤ «فَٱلْتَفَتَ إِلَيْهِ ٱلرَّبُّ وَقَالَ: ٱذْهَبْ بِقُوَّتِكَ هٰذِهِ وَخَلِّصْ إِسْرَائِيلَ مِنْ كَفِّ مِدْيَانَ. أَمَا أَرْسَلْتُكَ؟».
١صموئيل ١٢: ١١ وعبرانيين ١١: ٣٢ و٣٤ يشوع ١: ٩ وص ٤: ٦
فَٱلْتَفَتَ إِلَيْهِ ٱلرَّبُّ في الأصل العبراني «يهوه» وهو لا يطلق على غيره تعالى فدلّ ذلك على أن ذلك الملاك هو ملاك العهد وملاك الحضرة الذي لما جاء ملء الزمان ظهر في صورة بشرية دائمة أخذها من عذراء قدّسها وطهّرها وباركها. نعم قُرئ في بعض النسخ «فالتفت إليه ملاك الرب» لكن تلك قراءة لا تضر بالمعنى لأن يهوه قبل التجسد كان حين يظهر بالهيئة البشرية يُسمى «ملاك الرب» و«ملاك العهد» و«رئيس جند الرب» ولأنه دُعي «الرب» في عدة مواضع من هذا الأصحاح باتفاق كل النسخ العبرانية. ولعل التفاته إلى جدعون كان حينئذ كالتفاته بعد التجسد إلى بطرس في التأثير (لوقا ٢٢: ٦١). ولكن التفاته إلى بطرس كان التفات توبيخ والتفاته إلى جدعون كان التفات تنشيط وتشجيع أزال خوفه ومنحه حياة جديدة وثقة قويّة.
ٱذْهَبْ بِقُوَّتِكَ هٰذِهِ أي اذهب لمحاربة الأعداء بقوتك الطبيعية. فشجعه بتنبيهه على أنه قوي البنية والقلب بحسب فطرته. وهذا لا يلزم منه أنه أمره بمجرد الاتكال على هذه القوة لما ذكر بأن الله معه ولما يذكر من أنه هو أرسله. ولكن قوة البنية والقلب مما يحمل على الثقة بالفوز طبعاً. على أن تلك القوة كلها منحة إلهية. فالفضل لله على كل حال (انظر تفسير ع ١٢).
وَخَلِّصْ إِسْرَائِيلَ مِنْ كَفِّ مِدْيَانَ هذا مبني على قول جدعون «وجعلنا في كف مديان» (ع ١٣) فكأنه قال له إن الذي جعل إسرائيل في كف مديان أرسلك لتخلّصه من تلك الكفّ فاذهب وخلّصه منها.
أَمَا أَرْسَلْتُكَ أي أنا الرب قد أرسلتك لتخليص إسرائيل فلا بد من أن أنصرك. ومن يستطيع أن يقول هذا عن ثقة إلا الرب. ولعل جدعون إلى هنا لم يعلم أنه الرب أو ملاك الرب وربما ظنها رجلاً إسرائيلياً من أهل الرأي والتدبير رآه قوياً شجاعاً فأخذ يهيج حميته ليقود رجال إسرائيل إلى الحرب ويخلص الشعب. فأصغى إلى مشورته وأظهر له ما في نفسه من ذلك الأمر واحترمه وأكرمه إكرام التلميذ للمعلم. وما زال كذلك حتى قال له «إني أكون معك» (ع ١٦) فانتبه لما كان غافلاً عنه مع شيء من الشك في نفسه. ثم لما أتى الملاك أو الرب ما أتاه (ع ٢١) زال الشك كله من نفس جدعون (ع ٢٢). وكان الله والملائكة يظهرون للأنبياء والرسل بصورة بشرية ليأنسوا بهم ولا يخافوا. وقول الرب هنا لجدعون «أما أرسلتك» كقوله ليشوع «أما أمرتك» (يشوع ١: ١ و٩).
١٥ «فَقَالَ لَهُ: أَسْأَلُكَ يَا سَيِّدِي، بِمَاذَا أُخَلِّصُ إِسْرَائِيلَ؟ هَا عَشِيرَتِي هِيَ ٱلذُّلَّى فِي مَنَسَّى، وَأَنَا ٱلأَصْغَرُ فِي بَيْتِ أَبِي».
خروج ١٨: ٢١ و٢٥ و١صموئيل ٩: ٢١ وميخا ٥: ٢
فَقَالَ لَهُ أي قال جدعون للملاك.
أَسْأَلُكَ يَا سَيِّدِي قوله «يا سيدي» يدل على أنه إلى الآن لم يعرف إن الذي يخاطبه الرب غير ان الكلمة العبرانية «أدوناي» تحتمل أيضاً معنى «يهوه» وهو الاسم المخصص بالرب. وأما الفرق بين أدوناي بمعنى سيد وبينها بمعنى يهوه فهو بالحركات فقط.
بِمَاذَا أُخَلِّصُ إِسْرَائِيلَ أي لا واسطة لي ولا وسيلة إلى إنقاذ إسرائيل لا أهبة ولا أدوات ولا مركبات ولا جنود وأنا وقومي ضعفاء. وهذا دل على تواضع جدعون وعدم اعتداده بقوته وشجاعته وإنه مفتقر إلى عون الله الذي ترك إسرائيل. فانظر إن الله يعين الضعفاء ليخزي الأقوياء (انظر خروج ٤: ١ – ١٢ و١صموئيل ٩: ٢١ وإشعياء ٦: ٥ – ٧ وإرميا ١: ٥٦ و٧).
هَا عَشِيرَتِي هِيَ ٱلذُّلَّى فِي مَنَسَّى وفي الأصل العبراني ألفي الأذلّ أو الأقلّ أو الأفقر. إذا رجعنا آخر الأصحاح الثامن عشر من سفر الخروج نرى أن الإسرائيليين كانوا أقساماً عشرات وخماسين ومئات وألوفاً وأشار إلى هذا ميخا بقوله «أَمَّا أَنْتِ يَا بَيْتَ لَحْمَ أَفْرَاتَةَ، وَأَنْتِ صَغِيرَةٌ أَنْ تَكُونِي بَيْنَ أُلُوفِ يَهُوذَا» (ميخا ٥: ٢) ومعلوم أن الألف يشتمل على بيوت ومجموع هذه البيوت عشيرة. فمعنى جدعون أن الألف الذي بيته منه مع أنه قليل العدد بالنسبة إلى غيره من العشائر الكبيرة فقير وذلك فلا يتوقع أنهم يثبتون تجاه المديانيين في حومة القتال.
وَأَنَا ٱلأَصْغَرُ فِي بَيْتِ أَبِي قوله «الأصغر» الخ يحتمل أنه أصغر إخوته في السن أو أصغرهم في القدر والوجاهة. ولعل قوله هذا يدل على تواضعه فلم يكن صغيراً أو حقيراً كما قال عن نفسه. ونستنتج من بقية قصته أنه كان لبيته نوع من الاعتبار والسلطة.
١٦ «فَقَالَ لَهُ ٱلرَّبُّ: إِنِّي أَكُونُ مَعَكَ، وَسَتَضْرِبُ ٱلْمِدْيَانِيِّينَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ».
خروج ٣: ١٢ ويشوع ١: ٥ عدد ١٤: ١٥
فَقَالَ لَهُ ٱلرَّبُّ: إِنِّي أَكُونُ مَعَكَ وهو نص على أن ذلك الملاك هو ملاك العهد الأزلي (انظر خروج ٣: ١٢ ويشوع ١: ٥). وهذا يرفع كل الموانع من سبيل جدعون لأن من كان الرب معه لا يقدر عليه الأعداء مهما كثروا وقووا ووفرت عدد الحرب عندهم فلم يبق لجدعون من حاجة إلا أن يعرف المتكلم ليكون على يقين في ما أنبأه به. وقد تبين من هنا أن جدعون كان قليل الثقة بنفسه لفرط تواضعه.
وَسَتَضْرِبُ ٱلْمِدْيَانِيِّينَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ أي كأنهم رجل واحد أو تقوى عليهم كما تقوى على رجل واحد. إن الرب قادر على أن يجعل لجدعون وكل من رجاله بعنايته قوة جماعة حتى يصير مجموع قواتهم عظيماً فتُعد عنده قوات المديانيين قوة رجل واحد والخلاصة أنه ينتصر عليهم بسهولة. وهذا أقوى مشجع لا جبن الجبناء فكم يشجع جدعون «جبار البأس» (ع ١٢ انظر عدد ١٤: ١٥).
١٧ «فَقَالَ لَهُ: إِنْ كُنْتُ قَدْ وَجَدْتُ نِعْمَةً فِي عَيْنَيْكَ فَٱصْنَعْ لِي عَلاَمَةً أَنَّكَ أَنْتَ تُكَلِّمُنِي».
خروج ٤: ١ إلى ٨ وع ٣٦ و٣٧ و٢ملوك ٢٠: ٨ ومزمور ٨٦: ١٧ وإشعياء ٧: ١١
فَٱصْنَعْ لِي عَلاَمَةً أَنَّكَ أَنْتَ تُكَلِّمُنِي قد جاء ما يشبه هذه العبارة في قول إبراهيم لعفرون «إِنْ كُنْتَ أَنْتَ إِيَّاهُ» (تكوين ٢٣: ١٣) فالمعنى في قول إبراهيم «إنك الرجل الذي يهب» وهنا «إنك أنت الذي يكلمني ذات حقه لا خيال وإنك الرب» لأن الكلام الذي قلته لا يتوقّع إلا من الرب «فاصنع لي علامة» إنك موجود حقاً وإنك أنت الرب. فجدعون فهم هنا من كلامه إنه الرب ولكن شك في ذلك لأنه رأى الذي يكلمه إنساناً وخشي أنه كان يرى صورة خيالية ويسمع كلاماً خيالياً فإن مثل هذا قد يحدث لعوارض عصبية أو دماغية فيرى الإنسان صور الخيال في الخارج ويسمع كلاماً لا متكلم به. ومن ثم أخذ في ما يوصله إلى اليقين من الامتحان. وهو ما ذُكر في (ع ١٨ – ٢١).
١٨ «لاَ تَبْرَحْ مِنْ هٰهُنَا حَتَّى آتِيَ إِلَيْكَ وَأُخْرِجَ تَقْدِمَتِي وَأَضَعَهَا أَمَامَكَ. فَقَالَ: إِنِّي أَبْقَى حَتَّى تَرْجِعَ».
تكوين ١٨: ٣ و٥ وص ١٣: ١٥
لاَ تَبْرَحْ مِنْ هٰهُنَا أي لا تفارق مكانك الذي تحت البطمة (ع ١١ و١٩). خاف جدعون أن يذهب عنه قبل أن يتحقق من هو ويتيقن ما أنبأه به بالطريقة المألوفة قديماً وهي تقديم الطعام للزائر ولا تزال هذه العادة في كثير من أنحاء سورية وغيرها من أرض المشرق (انظر تكوين ١٨: ٣ و٥).
حَتَّى آتِيَ إِلَيْكَ أي أرجع إليك بعد ذهابي عنك وإن طال انتظارك شيئاً.
وَأُخْرِجَ تَقْدِمَتِي وَأَضَعَهَا أَمَامَكَ وفي العبرانية «اخرج منحتي» وهي في العربية العطية ومعناها في الآية ما يقدم للضيف أو لله وترجمها بعضهم بالقربان اتباعاً للسبعينية والفلغاتا وقال هو القربان لله بناء على فهمه من قوله «أما أرسلتك» وقوله «إني أكون معك» إنه الرب ليرى من ذلك آية تزيل كل الريب من نفسه. ويؤيد ذلك إن الذي قدمه كان مما يقرّب لله بمقتضى الشريعة من الفطير والمعزى (لاويين ٣: ٤ – ٦ و١٢).
١٩ «فَدَخَلَ جِدْعُونُ وَعَمِلَ جَدْيَ مِعْزىً وَإِيفَةَ دَقِيقٍ فَطِيراً. أَمَّا ٱللَّحْمُ فَوَضَعَهُ فِي سَلٍّ، وَأَمَّا ٱلْمَرَقُ فَوَضَعَهُ فِي قِدْرٍ وَخَرَجَ بِهَا إِلَيْهِ إِلَى تَحْتِ ٱلْبُطْمَةِ وَقَدَّمَهَا».
تكوين ١٨: ٦ و٧ و٨ خروج ١٦: ٣٦
فَدَخَلَ جِدْعُونُ أي دخل مسكنه ولعله كان كهفاً قرب المعصرة.
جَدْيَ مِعْزىً وَإِيفَةَ دَقِيقٍ فَطِيراً أي طبخ جدي معزى وعجن إيفة دقيق وخبزها فطيراً أي غير مختمرة للسرعة ولا ريب في أنه خبزها على الطاجن (الصاج) ولا يزال عرب البادية وأهل بعض القرى يخبزون عليه إلى هذا اليوم. و«الإيفة» نحو ثماني أُقات أو أربعة أرطال شامية. وكان العمر أي عُشر الإيفة كافياً للرجل الواحد (خروج ١٦: ١٦) لو أراد مجرد تقدمة الطعام على سبيل الضيافة فضلاً عن أن غلة الإسرائيليين كانت قليلة (انظر ع ٣ – ٥). وقال بعض المفسرين هنا. كان العمر كافياً ولكن الشرقيين لا يحسبون كثرة النفقة في قرى الضيف إسرافاً. وأبان بهذا أن التقدمة كانت تقدمة الطعام للضيف لا قرباناً لله. وهذا مذهب كثيرين في تفسير المنحة في هذه الآية على ما في الأصل.
وَقَدَّمَهَا (انظر ص ١٣: ١٩) وفي نسخة الفاتيكان السبعينية «تزلّف بها» أي تقرّب بها إلى الرب أو ملاك العهد. وفي بعض النسخ «تعبّد بها». وفسّر ذلك من رأى التقدمة طعام الضيافة إنه وضع الطعام أمام ضيفه باحترام وإكرام. وقال أحد أيمة الدين أن جدعون أتى بتلك التقدمة ما يدلّ على الأمرين القرى والعبادة للامتحان فكان يرى أنه إن أكل الطعام كان إنساناً عالماً أو نبياً وإلا فهو الرب. قلنا وفي هذا ما فيه (انظر تكوين ١٨: ٦ – ٨). والذي نراه أن ذلك كان امتحاناً ليرى علامة أو آية قبول التقدمة المعهود من إنشاء نار تحرقها (انظر ع ٢١ ولاويين ٩: ٢٤ و١ملوك ١٨: ٣٨ و١أيام ٢١: ٢٦ و٢أيام ٧: ١) فيتيقن أنه الرب ظهر له بصورة إنسان.
٢٠ «فَقَالَ لَهُ مَلاَكُ ٱللّٰهِ: خُذِ ٱللَّحْمَ وَٱلْفَطِيرَ وَضَعْهُمَا عَلَى تِلْكَ ٱلصَّخْرَةِ وَٱسْكُبِ ٱلْمَرَقَ. فَفَعَلَ كَذٰلِكَ».
ص ٣: ١٩ و١ملوك ١٨: ٣٣ و٣٤
تِلْكَ ٱلصَّخْرَةِ صخرة قرب البطمة أقامها مقام المذبح (انظر ص ١٣: ١٩).
وَٱسْكُبِ ٱلْمَرَقَ على اللحم والفطير. أمره بذلك تأكيداً للآية لأن المرق كالماء يمنع من الاحتراق (انظر ١ملوك ١٨: ٣٣ – ٣٥).
٢١ «فَمَدَّ مَلاَكُ ٱلرَّبِّ طَرَفَ ٱلْعُكَّازِ ٱلَّذِي بِيَدِهِ وَمَسَّ ٱللَّحْمَ وَٱلْفَطِيرَ، فَصَعِدَتْ نَارٌ مِنَ ٱلصَّخْرَةِ وَأَكَلَتِ ٱللَّحْمَ وَٱلْفَطِيرَ. وَذَهَبَ مَلاَكُ ٱلرَّبِّ عَنْ عَيْنَيْهِ».
لاويين ٩: ٢٤ و١ملوك ١٨: ٣٨ و٢أيام ٧: ١
فَمَدَّ مَلاَكُ ٱلرَّبِّ طَرَفَ ٱلْعُكَّازِ ٱلَّذِي بِيَدِهِ يظهر من هذه العبارة أن الرب ظهر لجدعون في هيئة رجل مسافر على قدميه يحمل عصا يتوكأ عليها استعانة على السير وقد تعب واشتد عليه الحر فأوى إلى ظل البطمة وقعد فيه ليتبرد ويستريح مما عراه من التعب. وهذا ما أوقع الشك في نفس جدعون فلم يتيقن أنه الرب عندما فهم من كلامه إنه الرب فسأله الآية وأتى الامتحان بالتقدمة.
فَصَعِدَتْ نَارٌ مِنَ ٱلصَّخْرَةِ وَأَكَلَتِ ٱللَّحْمَ أي أحرقت اللحم فلم يبق له من أثر كأنها أكلته وبلعته. وهذه علامة وآية لا يستطيعها بشر فدل بذلك دلالة اليقين على أنه هو الرب فلم يبق في نفس جدعون ريب في أن ضيفه الرب كما لم يبق للتقدمة من أثر. ودل ذلك على أن الرب قبل تقدمته.
وَذَهَبَ مَلاَكُ ٱلرَّبِّ عَنْ عَيْنَيْهِ أي خلع الصورة البشرية وأخفاها مع الثياب والعصا وتوارى عنه فجأة ولم ينتقل من مكانه كالناس. وهذه آية أخرى على أنه الرب أو ملاك الرب الذي هو ملاك العهد الأزلي.
٢٢ «فَرَأَى جِدْعُونُ أَنَّهُ مَلاَكُ ٱلرَّبِّ، فَقَالَ جِدْعُونُ: آهِ يَا سَيِّدِي ٱلرَّبَّ! لأَنِّي قَدْ رَأَيْتُ مَلاَكَ ٱلرَّبِّ وَجْهاً لِوَجْهٍ!».
ص ١٣: ٢١ تكوين ١٦: ١٣ و٣٢: ٣٠ وخروج ٣٣: ٢٠ وص ١٣: ٢٢
فَرَأَى جِدْعُونُ أَنَّهُ مَلاَكُ ٱلرَّبِّ أي فعلم جدعون علم اليقين أن الذي رآه تحت البطمة كان ملاك الرب.
آهِ يقول الإنسان آه وآهٍ وآهاً الخ عند الشكاية أو التوجع.
لأَنِّي قَدْ رَأَيْتُ مَلاَكَ ٱلرَّبِّ وَجْهاً لِوَجْهٍ اللام في «لأني» متعلقة بما في «آه» من معنى التوجع. كان اعتقاد القدماء أنه لا أحد يعاين الرب ويحيا وهذا حقٌ أثبته الرب بقوله لموسى «لاَ تَقْدِرُ أَنْ تَرَى وَجْهِي، لأَنَّ ٱلْإِنْسَانَ لاَ يَرَانِي وَيَعِيشُ» (خروج ٣٣: ٢٠) ولكن رؤيته في صورة إنسانية ما كانت تميت لأنه رآه كثيرون من عبيده كذلك ولم يموتوا إلا أن الخوف من رؤيته تعالى جعل الناس يحسبون أن رؤيته تميت الإنسان لأنه خاطئ على أي صورة كانت.
٢٣ «فَقَالَ لَهُ ٱلرَّبُّ: ٱلسَّلاَمُ لَكَ. لاَ تَخَفْ. لاَ تَمُوتُ».
دانيال ١٠: ١٩
فَقَالَ لَهُ ٱلرَّبُّ هل ظهر له ثانية وخاطبه أم أسمعه الكلام ولم يظهر له أم أوحى ذلك إلى نفسه فشعر به لم يبيّن الكتاب لنا شيئاً من ذلك والمرجّح أنه أوحى إليه ذلك بلا ظهور ولا صوت.
ٱلسَّلاَمُ لَكَ أي سلامة وحياة وأمنٌ لك.
لاَ تَخَفْ من أن تموت وإن رأيتني بصورة بشرية.
لاَ تَمُوتُ تعليل لقوله «لا تخف» (انظر تفسير ع ٢٢) والمعنى اطمئن ولا تخف لأنك لا تموت. فالرب لم يترك جدعون في اضطرابه. ومن آلائه أنه يسكّن قلق خائفيه (انظر دانيال ١٠: ٧ – ١٢ وحزقيال ١: ٢٨ – ٢: ١ ومرقس ١٦: ١ – ٨ ولوقا ١: ١٢ و١٣ و٢: ٩ و١٠ ورؤيا ١: ١٧).
٢٤ «فَبَنَى جِدْعُونُ هُنَاكَ مَذْبَحاً لِلرَّبِّ وَدَعَاهُ «يَهْوَهَ شَلُومَ». إِلَى هٰذَا ٱلْيَوْمِ لَمْ يَزَلْ فِي عَفْرَةِ ٱلأَبِيعَزَرِيِّينَ».
تكوين ٢٢: ١٤ وخروج ١٧: ١٥ وإرميا ٣٣: ١٦ وحزقيال ٤٨: ٣٥ ص ٨: ٣٢
فَبَنَى جِدْعُونُ هُنَاكَ مَذْبَحاً لِلرَّبِّ ليكون ذكرى لتلك الحادثة العجيبة لا لتقدم عليه القرابين في مذبح خيمة الشهادة وهيكل سليمان. وقد بُنيت عدة مذابح لهذا المقصد (تكوين ٢٦: ٢٤ و٢٥ ويشوع ٨: ٣٠).
وَدَعَاهُ «يَهْوَهَ شَلُومَ» أي الرب سلام وهو مبنيٌ على قول الرب لجدعون «سلام لك».
إِلَى هٰذَا ٱلْيَوْمِ أي يوم كتابة هذا الآية.
فِي عَفْرَةِ ٱلأَبِيعَزَرِيِّينَ وفي العبرانية «أبي العزريين» والمراد المنسوبون إلى أبيعزر ولذلك تُرجمت منسوبة إليه (انظر ص ٨: ٣٢). و«عفرة» تقدّم الكلام عليها في تفسير (ع ١١).
الأمر بهدم مذبح البعل وقطع السارية والائتمار به ع ٢٥ إلى ٣٢
٢٥ «وَكَانَ فِي تِلْكَ ٱللَّيْلَةِ أَنَّ ٱلرَّبَّ قَالَ لَهُ: خُذْ ثَوْرَ ٱلْبَقَرِ ٱلَّذِي لأَبِيكَ، وَثَوْراً ثَانِياً ٱبْنَ سَبْعِ سِنِينَ، وَٱهْدِمْ مَذْبَحَ ٱلْبَعْلِ ٱلَّذِي لأَبِيكَ وَٱقْطَعِ ٱلسَّارِيَةَ ٱلَّتِي عِنْدَهُ».
خروج ٣٤: ١٣ وتثنية ٧: ٥
تِلْكَ ٱللَّيْلَةِ أي الليلة التي كانت على أثر مخاطبة ملاك الرب إياه. وذكر بناء المذبح مقدماً. وجاء في هذه الآية وما بعدها بتفصيل النبأ فهو لم يبنٍ المذبح قبل قول الرب له فيها.
خُذْ ثَوْرَ ٱلْبَقَرِ ٱلَّذِي لأَبِيكَ المظنون أن هذا الثور كان أبو جدعون يعلفه ويسمنه قرباناً عن نفسه أو عنها وعن أهل بيته فأمره بأخذه منه يتصرّف به كيف شاء. ولعله استخدمه لحمل مواد المذبح والحطب.
وَثَوْراً ثَانِياً ٱبْنَ سَبْعِ سِنِينَ وفي العبرانية «الثور الثاني» فهو ثور معهود وهو من ثيران أبيه الموقوفة للبعل. قال أحد المفسرين ولعل كونه ابن سبع سنين إشارة إلى المدة التي استعبد فيها المديانيون الإسرائيليين.
وَٱهْدِمْ مَذْبَحَ ٱلْبَعْلِ ٱلَّذِي لأَبِيكَ الظاهر أن أباه كان قد بنى للبعل مذبحاً يقدّم عليه القرابين للبعل أي الشمس وأباح للجميع أن يقربوا عليه إكراماً للبعل.
وَٱقْطَعِ ٱلسَّارِيَةَ ٱلَّتِي عِنْدَهُ السارية العمود وكانت السواري من الخشب وكانت تُنصب على محل مرتفع تُعبد عليه ويُعبد عندها البعل. وتُعرف السارية بالنصب أيضاً وكانت كثيرة عند الكنعانيين والعرب قال المهلهل وهو عدّي بن ربيعة أخو كليب وائل:
| كلّا وأنصاب لنا عادية | معبودة قد قُطعت تقطيعا |
والمرجّح أنه كان على السواري صور عشتروت أو تماثيلها فكانوا يعبدون البعل وعشتروت معاً على المرتفعات (١ملوك ١٦: ٣١ – ٣٣) وهما كما ذكرنا الشمس والقمر. وهدم مذابح الأوثان وكسر الأصنام وقطع السواري مما أمر الله به في التوراة (انظر خروج ٣٤: ١٣ وتثنية ٧: ٥).
٢٦ «وَٱبْنِ مَذْبَحاً لِلرَّبِّ إِلٰهِكَ عَلَى رَأْسِ هٰذَا ٱلْحِصْنِ بِتَرْتِيبٍ، وَخُذِ ٱلثَّوْرَ ٱلثَّانِيَ وَأَصْعِدْ مُحْرَقَةً عَلَى حَطَبِ ٱلسَّارِيَةِ ٱلَّتِي تَقْطَعُهَا».
تكوين ٢٢: ٩ ولاويين ١: ٧ و١ملوك ١٨: ٣٣
وَٱبْنِ مَذْبَحاً هذا هو المذبح الذي ذُكر في (ع ٢٤) ذكره سابقاً وأتى بتفصيل نبإه هنا.
لِلرَّبِّ إِلٰهِكَ الحق بدلاً من مذبح البعل الإله الباطل.
عَلَى رَأْسِ هٰذَا ٱلْحِصْنِ أي قلعة المدينة عفرة ليراه الجميع.
بِتَرْتِيبٍ بمراعاة النسبة في أجزائه وكل ما يتعلق به (تكوين ٢٢: ٩ ولاويين ١: ٧ – ٩ و١ملوك ١٨: ٣٣).
وَخُذِ ٱلثَّوْرَ ٱلثَّانِيَ الذي وُقف للبعل.
وَأَصْعِدْ مُحْرَقَةً عَلَى حَطَبِ ٱلسَّارِيَةِ هذا إذلال للبعل لأن الثور كان موقوفاً له على ما يرجّح ولعشتروث إلاهة القمر عند الأكثرين وإلاهة الزُهرة عند بعض الوثنيين وإلاهة الطبيعة عند آخرين فأحرق ثور البعل على خشب عشتاروث.
وهنا عدة اعتراضات (١) إن القربان لم يقدّم في شيلون. (٢) إنه لم يقدّمه كاهن. (٣) إنه قُدّم ليلاً (ع ٢٧). (٤) إن وقود النار المقدسة كان خشب السارية النجسة. (٥) إن الثور المقدّم كان نجساً لأنه كان وقفاً للبعل على ما رجّحنا.
وندفع ذلك بأن المذبح لم يبنَ لتقديم الذبائح العبادية بل بُني تذكاراً لإحسان الله إلى جدعون. وتقديم الثور لم يكن كتقدمات خيمة الشهادة بل كان إذلالاً للبعل وعشتروث وبيان أن لا قوة لهما. هذا وإن الإسرائيليين كانوا يومئذ عبيداً وكان الكهنة يختبئون في الكهوف خوفاً من العذاب والقتل. والقيام بالفروض الموسوية مهملاً لضلال الشعب ولما هم فيه من الضيق فإن كانت تقدمة المحرقة حينئذ عبادية فللضرورة ولم يكن جواز تقدمتها من استحسان جدعون بل بإجازة الرب نفسه وشتان بين استحسان البشر واستحسان الرب. فالعمل على ذلك من النوادر والوقتيات.
٢٧ «فَأَخَذَ جِدْعُونُ عَشَرَةَ رِجَالٍ مِنْ عَبِيدِهِ وَعَمِلَ كَمَا كَلَّمَهُ ٱلرَّبُّ. وَإِذْ كَانَ يَخَافُ مِنْ بَيْتِ أَبِيهِ وَأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ أَنْ يَعْمَلَ ذٰلِكَ نَهَاراً فَعَمِلَهُ لَيْلاً».
فَأَخَذَ جِدْعُونُ عَشَرَةَ رِجَالٍ مِنْ عَبِيدِهِ هذا يدل على أن جدعون كان مستقلاً عن أبيه وإنه كان يبذل جهده في منع أهل بيته من العبادة الوثنية ومخالطة الضاليّن.
وَإِذْ كَانَ يَخَافُ مِنْ بَيْتِ أَبِيهِ أي الأبيعزريين لأنهم كانوا يعبدون البعل وعشتاروث.
فَعَمِلَهُ لَيْلاً هدم في ذلك الليل بمساعدة عبيده العشرة مذبح البعل وقطع السارية وبنى مذبحاً للرب وأحرق عليه الثور الموقوف للبعل. ولا ندري ماذا فعل بثور أبيه الخاصّ.
وقد ترجم بعضهم الآية الخامسة والعشرين كما يأتي «خذ ثور البقر الذي لأبيك أي الثور الثاني ابن سبع سنين الخ» والمفهوم من العبارة أنه كان لأبيه ثوران وأمر الرب جدعون أن يأخذ أحدهما وهو الثور الثاني من جهة العمر لان ابن سبع سنين يوافق المقصود أكثر من الثور الآخر.
٢٨ «فَبَكَّرَ أَهْلُ ٱلْمَدِينَةِ فِي ٱلْغَدِ وَإِذَا بِمَذْبَحِ ٱلْبَعْلِ قَدْ هُدِمَ وَٱلسَّارِيَةُ ٱلَّتِي عِنْدَهُ قَدْ قُطِعَتْ، وَٱلثَّوْرُ ٱلثَّانِي قَدْ أُصْعِدَ عَلَى ٱلْمَذْبَحِ ٱلَّذِي بُنِيَ».
فَبَكَّرَ أَهْلُ ٱلْمَدِينَةِ فِي ٱلْغَدِ ليسجدوا للشمس عند طلوعها.
وَٱلسَّارِيَةُ ٱلَّتِي عِنْدَهُ قَدْ قُطِعَتْ أي والعمود الخشب المنصوب لعشتاروث في جوار مذبح البعل قد قُطع. كان هذا كافياً ليبين لهم أن إلههم لم يقدر أن يحمي مذبحه وإلاهتهم لم تستطع أن تقي نصبها. نعم إن الله كان يسمح بهدم مذبحه لكن لا لعجزٍ تعالى عن ذلك علوّاً كبيراً بل تأديباً لبني إسرائيل على خطاياهم وأما المديانيون والكنعانيون والضالون من الإسرائيليين فكانوا مجتهدين في عبادة الشمس والقمر فلو كانا إلهين لأبانا ألوهيتهما بوقاية المذبح والنصب تشديداً لإيمان عبدتهما. ودليل إخلاص المذكورين العبادة لهما أنهم بكروا للسجود للبعل وعشتاروت لأن نصبها قرب مذبح البعل.
وَٱلثَّوْرُ ٱلثَّانِي قَدْ أُصْعِدَ عَلَى ٱلْمَذْبَحِ ٱلَّذِي بُنِيَ هذا يدل على أن ذلك الثور كان معهوداً ومشهوراً وما على اشتهاره على المرجّح إلا أنه كان موقوفاً للبعل. فإن قيل كيف عرفوا إن الثور الثاني أُصعد على المذبح الجديد. قلنا المرجّح إن مكانه ومعلفه كانا قرب المذبح وكانوا يفتقدونه كل صباح ولما وصلوا إلى المذبح افتقدوه فلم يجدوه ورأوا على المذبح الجديد حمم عظام ثور فحكموا بأنها عظام الثور الثاني. ولعله نُعت بالثاني تمييزاً له عن ثور أبي جدعون الخاص. وقد ظن بعضهم أن الثور الخاص كان للتقدمة عن أبي جدعون وحده أو عنه وعن أهل بيته.
٢٩ «فَقَالُوا ٱلْوَاحِدُ لِصَاحِبِهِ: مَنْ عَمِلَ هٰذَا ٱلأَمْرَ؟ فَسَأَلُوا وَبَحَثُوا فَقَالُوا: إِنَّ جِدْعُونَ بْنَ يُوآشَ قَدْ فَعَلَ هٰذَا ٱلأَمْرَ».
إِنَّ جِدْعُونَ بْنَ يُوآشَ قَدْ فَعَلَ هٰذَا ٱلأَمْرَ استدلوا بأنه هو الفاعل ذلك الأمر لما اشتهر من أمره إنه كان يحرّم عبادة البعل وينهي عنها وينادي بوجوب عبادة الرب.
٣٠ «فَقَالَ أَهْلُ ٱلْمَدِينَةِ لِيُوآشَ: أَخْرِجِ ٱبْنَكَ لِنَقْتُلَهُ، لأَنَّهُ هَدَمَ مَذْبَحَ ٱلْبَعْلِ وَقَطَعَ ٱلسَّارِيَةَ ٱلَّتِي عِنْدَهُ».
فَقَالَ أَهْلُ ٱلْمَدِينَةِ لِيُوآشَ: أَخْرِجِ ٱبْنَكَ لِنَقْتُلَهُ أي اخرج ابنك من مخبأه وسلمه إلينا لنقتله. وهذا يؤيد ما قلناه قبلاً إن القوم كانوا شديدي العبادة للبعل والاحترام لمذبحه. فانظر إلى أي حد يصل الناس من الجهل بتركهم الرب.
لأَنَّهُ هَدَمَ مَذْبَحَ ٱلْبَعْلِ وَقَطَعَ ٱلسَّارِيَةَ ٱلَّتِي عِنْدَهُ هذا هو الذنب الذي أوجبوا به الموت على جدعون مع أن شريعة الله أمرت بهدم المذابح الوثنية وكسر الأصنام وقطع السواري أو الأنصاب. قال بعضهم وأهل المدينة هنا الوثنيون الذين كثيرون منهم كنعانيون لا اليهود على ما يظن.
٣١ «فَقَالَ يُوآشُ لِجَمِيعِ ٱلْقَائِمِينَ عَلَيْهِ: أَنْتُمْ تُقَاتِلُونَ لِلْبَعْلِ، أَمْ أَنْتُمْ تُخَلِّصُونَهُ؟ مَنْ يُقَاتِلْ لَهُ يُقْتَلْ فِي هٰذَا ٱلصَّبَاحِ. إِنْ كَانَ إِلٰهاً فَلْيُقَاتِلْ لِنَفْسِهِ لأَنَّ مَذْبَحَهُ قَدْ هُدِمَ».
فَقَالَ يُوآشُ لِجَمِيعِ ٱلْقَائِمِينَ عَلَيْهِ الأصل يحتمل معنى القائمين لديه أو الواقفين حوله.
أَنْتُمْ تُقَاتِلُونَ لِلْبَعْلِ، أَمْ أَنْتُمْ تُخَلِّصُونَهُ الخ الكلام استفهام إنكاري أي أنتم ما من شأنكم أن تقاتلوا لإلاهكم فهو أقوى منكم فإن كان إلهاً فليقاتل عن نفسه وإن كان ليس بإلهٍ فمن الخطإ أن يُقتل مَن هدم مذبحه ويجب قتل من يقاتل للبعل وذلك سريعاً.
قلنا الظاهر من هذا أن يوآش ضعف إيمانه بالبعل بل استخفّ به إذ لم يقتصّ لنفسه. ولا ريب في أنه أعجب بشجاعة ابنه ورأى أنه مصيب بتحريم عبادة البعل. وإنه رأى من العار والحطّة لإسرائيل أن يقتل الأمم ابن كبير فيهم.
٣٢ «فَدَعَاهُ فِي ذٰلِكَ ٱلْيَوْمِ «يَرُبَّعْلَ» قَائِلاً: لِيُقَاتِلْهُ ٱلْبَعْلُ لأَنَّهُ قَدْ هَدَمَ مَذْبَحَهُ».
١صموئيل ١٢: ١١ و٢صموئيل ١١: ٢١ وإرميا ١١: ١٣ وهوشع ٩: ١٠
فَدَعَاهُ فِي ذٰلِكَ ٱلْيَوْمِ «يَرُبَّعْلَ» الخ قال بعض العلماء الأولى على مقتضى الأصل العبراني أن يُقال فدُعي في ذلك اليوم أي اشتهر بهذا الاسم «يربعل» لا إن أباه دعاه به. وأصل «يربعل» يرب بعل أي يحارب أو يقاتل البعل أو الذي بينه وبين البعل قتال. وفي (٢صموئيل ١١: ٢١) يقال «يربوشث» أي يقاتل بوشث ومعنى بوشث الخزي. وهكذا إيشبوشث في (٢صموئيل ٢: ٨) أي أصله أشبعل والتغيير في الاسم بقصد الاحتقار للبعل.
لِيُقَاتِلْهُ ٱلْبَعْلُ هل هذا دعاء عل ابنه أم دعاء للبعل المرجّح الثاني كإنه أراد إن كان البعل إلهاً فليقاتله لانه هدم مذبحه.
الاستعداد للحرب وإعلان الله آيتين لجدعون ع ٣٣ إلى ٤٠
٣٣ «وَٱجْتَمَعَ جَمِيعُ ٱلْمِدْيَانِيِّينَ وَٱلْعَمَالِقَةِ وَبَنِي ٱلْمَشْرِقِ مَعاً وَعَبَرُوا وَنَزَلُوا فِي وَادِي يَزْرَعِيلَ».
ع ٣ يشوع ١٧: ١٦
وَٱجْتَمَعَ جَمِيعُ ٱلْمِدْيَانِيِّينَ وَٱلْعَمَالِقَةِ وَبَنِي ٱلْمَشْرِقِ لنهب غلال الإسرائيليين كعادتهم (انظر تفسير ع ٣).
وَعَبَرُوا أي عبروا الأردن في المخاوض قرب بيت شان فإن هناك يمكن خوض النهر من عدة مواضع.
وَنَزَلُوا فِي وَادِي يَزْرَعِيلَ كما فعل الفلسطينيون بعد ذلك (١صموئيل ٢٩: ١ و١١). وهذا الوادي بين جلبوع وحرمون أي جبل الشيخ. والظاهر أن الوادي نُسب إلى يزرعيل وهي مدينة كانت ذات شأن وهي اليوم قرية حقيرة تُسمى زرعين.
ووادي يزرعيل أو سهل يزرعيل سهل في فلسطين يمتد من البحر المتوسط إلى الأردن ومن الكرمل وجبال السامرة إلى جبال الجليل وطوله من الشرق إلى الغرب ٢٥ ميلاً وعرضه ١٢ ميلاً ويُعرف بمرج ابن عامر.
٣٤ «وَلَبِسَ رُوحُ ٱلرَّبِّ جِدْعُونَ فَضَرَبَ بِٱلْبُوقِ، فَٱجْتَمَعَ أَبِيعَزَرُ وَرَاءَهُ».
ص ٣: ١٠ و١ايام ١٢: ١٨ و٢أيام ٢٤: ٢٠ وأيوب ٢٩: ١٤ ولوقا ٢٤: ٤٩ عدد ١٠: ٣ وص ٣: ٢٧
وَلَبِسَ رُوحُ ٱلرَّبِّ جِدْعُونَ وفي بعض الترجمات «حل على جدعون» والمفهوم هنا أنه حلّ فيه لأن جدعون كان بمنزلة كساء عليه. وفي معنى الحلول فيه قوة ليست بالحلول عليه كما لا يخفى على نبيه (انظر تفسير ص ٣: ١٠). والمعنى أن أفعال جدعون في ما انتُدب له كانت بإرشاد الروح القدس وتحريكه له حتى كأن ذلك الروح العظيم قام مقام روحه في إحيائه وتدبيره.
فَضَرَبَ بِٱلْبُوقِ الفاء سببية أي بسبب أن روح الرب لبس جدعون ضرب بالبوق أي نفخ فيه كأنه يضربه بنفسه ليأتيه قومه. وكان النفخ بالبوق في مثل تلك الحال دعوة للاجتماع.
فَٱجْتَمَعَ الفاء سببية أيضاً إذ النفخ بالبوق كان سبب الاجتماع.
أَبِيعَزَرُ أي عشيرة أبيعزر أو رجال تلك العشيرة.
وَرَاءَهُ أي كانوا جنوداً هو يقودهم للقتال. إن الذي كان يخاف من هدم مذبح نهاراً ويخبط حنطته في المعصرة لكي لا يراه أحد ويسلبه إياها دعا قومه إلى القتال ومشى أمامهم. فهذا التغيّر العظيم في وقت قصير ليس من العادات ولا الحوادث الطبيعية إنما هو فعل روح الرب الذي لبسه.
٣٥ «وَأَرْسَلَ رُسُلاً إِلَى جَمِيعِ مَنَسَّى، فَٱجْتَمَعَ هُوَ أَيْضاً وَرَاءَهُ، وَأَرْسَلَ رُسُلاً إِلَى أَشِيرَ وَزَبُولُونَ وَنَفْتَالِي فَصَعِدُوا لِلِقَائِهِمْ».
وَأَرْسَلَ رُسُلاً إِلَى جَمِيعِ مَنَسَّى إن إخلاص عشيرته الأبيعزرية له وتجندهم معه جعلت له الحق أن يدعو سائر سبط منسى إلى القتال.
فَٱجْتَمَعَ هُوَ أَيْضاً وَرَاءَهُ أي سبط منسى فعل فِعل عشيرة جدعون في زحفهم وراءه للحرب.
أَشِيرَ أي سبط أشير أو الأشيرين. فهؤلاء الذين عيّرتهم دبورة في قصيدتها على خذلهم إخوتهم والتهائهم بتجارتهم (ص ٥: ١٧) دفعوا عنهم ذلك التعبير والعار الذي لحقهم بإجابتهم دعوة جدعون إلى الحرب.
وَزَبُولُونَ وَنَفْتَالِي هذان السبطان ممن امتازوا في حرب يابين ومدحتهم دبورة النبية في قصيدتها البليغة (ص ٥: ١٨). ولم يُذكر يساكر مع أنه كان في حرب سيسرا (ص ٥: ١٥) وكانت أرضه موقع الحرب أي في سهل يزرعيل. والأرجح أنه كان مع إخوته في القتال وإن لم يُذكر اسمه.
فَصَعِدُوا لِلِقَائِهِمْ أي صعد أشير وزبولون ونفتالي للقاء إخوتهم بني منسى ومساعدتهم والظاهر من هذا أن بني منسى نزلوا حومة القتال قبل أن يصل إليهم أولئك الأسباط الثلاثة كانوا في الشمال ومنسى في جنوب سهل يزرعيل وهو المعروف بين العامة اليوم بمرج ابن عامر وفي كتب مؤرخي العرب بمرج ابن عمير وكانت جيوش المديانيين في وادي يزرعيل وكانت فاصلة بين زبولون ونفتالي في شمالي هذا الوادي وبين منسى في الجنوب منه فلا بد من أنهم عاقوا الأسباط الثلاثة فلم يمكنهم الوصول قبل زحف منسى ليمشوا وراء جدعون كما فعل رجال عشيرته.
٣٦ «وَقَالَ جِدْعُونُ لِلّٰهِ: إِنْ كُنْتَ تُخَلِّصُ بِيَدِي إِسْرَائِيلَ كَمَا تَكَلَّمْتَ».
إِنْ كُنْتَ تُخَلِّصُ بِيَدِي إِسْرَائِيلَ كَمَا تَكَلَّمْتَ جواب الشرط محذوف يدل على معناه ما يأتي في بقية الآيات من هذا الأصحاح. ومعناه فأظهر لي ما أطلبه وهو آيتان كما يأتي. ومثل هذا الحذف للدلالة كثير في اللغات الساميّة.
ومن العجب أنه بقي في نفس جدعون شك ولكن الإنسان ضعيف جداً فإنه لما شاهد كثرة الأعداء وعددهم وقلة رجاله بالنسبة إليهم خاف أنه مخدوع فطلب الآيتين. فالإنسان في حاجة إلى تقوية إيمانه في الشدائد والأهوال.
٣٧ «فَهَا إِنِّي وَاضِعٌ جَزَّةَ ٱلصُّوفِ فِي ٱلْبَيْدَرِ. فَإِنْ كَانَ طَلٌّ عَلَى ٱلْجَزَّةِ وَحْدَهَا، وَجَفَافٌ عَلَى ٱلأَرْضِ كُلِّهَا، عَلِمْتُ أَنَّكَ تُخَلِّصُ بِيَدِي إِسْرَائِيلَ كَمَا تَكَلَّمْتَ».
خروج ٤: ٣ إلى ٧
فَهَا إِنِّي وَاضِعٌ جَزَّةَ ٱلصُّوفِ فِي ٱلْبَيْدَرِ الجزّة ما يجز أو يُقطع من صوف النعجة ويجمع بعضه إلى بعض. والبيدر له معنيان (١) الموضع الذي تدرَس فيه السنابل ويخرج الحب من العصافة والتبن. (٢) الكدس الموضوع للدرس وهذا هو المراد هنا إن كان المراد بالطلّ في العبارة الآتية الندى وفي بعض كتب العربية «وضع البيدر في البيدر أي الكدس في موضعه الذي يُداس فيه».
فَإِنْ كَانَ طَلٌّ عَلَى ٱلْجَزَّةِ وَحْدَهَا، وَجَفَافٌ عَلَى ٱلأَرْضِ كُلِّهَا للطلّ معانٍ منها المطر الضعيف وأخف المطر وأضعفه والندى وما فوق الندى ودون المطر. فإن كان المراد به المطر فيكون الحادث معجزة لأن من عادة المطر أن يقع على الصوف والتراب والحجارة وعلى ذلك يكون معنى الأرض على ظاهره. وإن كان المراد «بالطل» الندى «وبالأرض» التراب والحجارة كان وجود الندى على الجزّة دون ما جاورها من الأرض أمراً عادياً لا معجزة ولم يكن وجوده على الجزّة دون ما جاورها آية فيلزم حينئذ أن المراد بالأرض ما غطاها من السنابل من ذكر المكان وإرادة ما يشغله وهو كثير في الكلام فإنها من المواد الكثيرة الإشعاع للحرارة والقليلة الإيصال لها كالصوف فيكون وجود الندى على الجزّة دون الكدس أو السنابل المكدوسة معجزة لأنه خارق العادة. وقوله «الأرض كلها» المراد به كل أرض البيدر. وإن قيل إن جدعون طلب الآية على وجهين كما سيأتي فإن كان الأول طبيعياً كان الثاني على خلاف الطبيعة. فمن المحتمل على هذا الفرض أن جدعون لما طلب الآية على الوجه الأول خطر على باله إنه ربما كان على سبيل العادة فطلب نقيضه فلم يبق بوقوعه شيء من الشك في نفسه. فعلى كل فرض وتقدير حصلت العلامة المزيلة للريب.
٣٨ «وَكَانَ كَذٰلِكَ. فَبَكَّرَ فِي ٱلْغَدِ وَضَغَطَ ٱلْجَزَّةَ وَعَصَرَ طَلاًّ مِنَ ٱلْجَزَّةِ، مِلْءَ قَصْعَةٍ مَاءً».
وَكَانَ كَذٰلِكَ أي كان الطلّ على الجزّة وحدها وجفاف على الأرض كلها (ع ٣٧). فأجاب الله صلاة جدعون لأنه طلب الآية لتقوية إيمانه لا امتحاناً لربه.
مِلْءَ قَصْعَةٍ مَاءً أي ملء صحفة وهي ما تسع من الطعام ما يُشبع خمسة رجال فلا ريب في أن ملؤها كان لا يقل عن أربع أقق إن لم يكن أكثر من ذلك. وهذا المقدار من جزّة واحدة يدل على أن المراد «بالطل» المطر فالآية هنا معجزة لأنه لا يمكن أن تكون الأرض جافة مع ذلك وإن كان الطل يبقى على الجزة أكثر مما يبقى على الأرض على أن جدعون بكّر للمشاهدة فلم تكن الشمس قد أرسلت أشعتها إلى الأرض ولا اشتدّ حرُها عليها.
٣٩ «فَقَالَ جِدْعُونُ لِلّٰهِ: لاَ يَحْمَ غَضَبُكَ عَلَيَّ فَأَتَكَلَّمَ هٰذِهِ ٱلْمَرَّةَ فَقَطْ. أَمْتَحِنُ هٰذِهِ ٱلْمَرَّةَ فَقَطْ بِٱلْجَزَّةِ. فَلْيَكُنْ جَفَافٌ فِي ٱلْجَزَّةِ وَحْدَهَا وَعَلَى كُلِّ ٱلأَرْضِ لِيَكُنْ طَلٌّ».
تكوين ١٨: ٣٢
لاَ يَحْمَ غَضَبُكَ عَلَيَّ (انظر تكوين ١٨: ٣٠ و٣٢). قال ذلك لعلمه أن هذا الطلب دلّ على ضعفه إيمانه بالرب ولكن الرب رحيم لا يرفض المؤمن وإن كان إيمانه ضعيفاً.
فَلْيَكُنْ جَفَافٌ فِي ٱلْجَزَّةِ وَحْدَهَا وَعَلَى كُلِّ ٱلأَرْضِ لِيَكُنْ طَلٌّ هذا أمر خارق العادة سواء أكان الطلّ مطراً أم كان ندىً وسواء أكان المراد بالأرض التراب والحجارة أم ما كان عليها من السنابل بل الأولى إن كان ندى أن يكون على الجزّة دون الأرض.
٤٠ «فَفَعَلَ ٱللّٰهُ كَذٰلِكَ فِي تِلْكَ ٱللَّيْلَةِ. فَكَانَ جَفَافٌ فِي ٱلْجَزَّةِ وَحْدَهَا وَعَلَى ٱلأَرْضِ كُلِّهَا كَانَ طَلٌّ».
فَفَعَلَ ٱللّٰهُ كَذٰلِكَ أي فأجاب الرب طلبته بأن انفردت الجزّة بالجفاف وغطى الطل كل الأرض وأصل الطل في العبرانية طل بالرسم نفسه ومعناه في العبرانية كمعناه في العربية فجاء بمعنى المطر الخفيف في قول صاحب النشيد «لإَنَّ رَأْسِي ٱمْتَلَأَ مِنَ ٱلطَّلِّ» (نشيد الأناشيد ٥: ٢). وهو ما يسميه بعض العامة بالصحرة. وما كانوا يفرقون بين الندى والمطر الخفيف في الزمن القديم ولكن الفلاسفة أخيراً خصصوا الندى بما يجتمع من رطوبة الهواء على وجه الأرض إذا برد فيستحيل البخار المائي في ما يمسه من الهواء ماء ويجتمع قطرات على الأعشاب والأزهار وغيرهما ولهذا جاء الطل بمعنى الندى في كثير من الآيات ونُسب إليه النزول كما ينسب إلى المطر. وعلى ذلك قول المرنم «مِثْلُ نَدَى حَرْمُونَ ٱلنَّازِلِ عَلَى جَبَلِ صِهْيَوْنَ» (مزمور ١٣٣: ٣) وفي العبرانية «مثل طل حرمون النازل» الخ. وفي كتب اللغة العربية «الندى المطر وما أصاب من بلل». وانظر في الآيات الماضية نظر لغوي لا نظر فيلسوف على أنك إذا راعيت فيها مصطلح الفلاسفة لم يلحق الوحي غبار منه كما ذكرناه مفصلاً.
فوائد
- إننا عديمو الشكر لأننا نتضرّع إلى الرب في الضيق وننساه بعد ما ينقذنا منه (ع ١).
- أعظم مصيبة للإنسان هي أن يتركه الرب الذي هو مصدر الحياة والبركة.
- يلزمنا التأديب (ع ٢) والتعليم (ع ٨) والإنذار (ع ١٠) والتوبة والاعتراف والرجوع إلى الرب ليرجع إلينا وينقذنا.
- الرب يدعو للخدمة من له المواهب اللازمة وإيمان وطاعة وقلب مستعد لقبول الروح.
- الرب يعدّنا للخدمة أولاً بجذبه نظرنا إليه لأن قوتنا منه فيعطينا كل ما نحتاج إليه. وثانياً بزيادة الثقة بنفوسنا كمدعوين ومرسلين منه (ع ١٢).
- إذا دعانا الرب لخدمةٍ فمن كل بُدٍّ يعطينا كل ما يلزمنا لتلك الخدمة (ع ١٦).
- إن طلب الآيات ليس بخطيئة إن كانت غايتنا تقوية إيماننا (ع ١٨ و٣٦ – ٤٠) فأعطى الرب آية لجدعون ولم يعط المسيح آية للفريسيين.
- السلام من الله (ع ٢٤) وسلام الله يحتوي على (١) سلامة الضمير «فَإِذْ قَدْ تَبَرَّرْنَا بِٱلْإِيمَانِ لَنَا سَلاَمٌ مَعَ ٱللّٰهِ بِرَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ» (رومية ٥: ١). (٢) السلام مع الناس فيكون في البيت وفي المجتمع وفي المملكة.
- إننا قبلما نباشر خدمة الرب يلزمنا التطهير من الكبرياء والاتكال على النفس وعلى الناس ونزع كل ما أقمناه مكان الله في قلوبنا (ع ٢٥).
- إن الأصنام التي نسجد لها إن كانت بعل أو المال أو المجد العالميين لا تقدر أن تشبع النفس أو تنقذنا في يوم الضيق (ع ٣٢).
- الإنسان الممتلئ من الروح القدس يجذب العالم إلى نفسه (ع ٣٤ و٣٥).
- علينا أن نجتهد في إزالة الوثنية في كل الأرض بالحرب الروحية الجسدية ولا نستخدم لذلك سوى سيف كلمة الله.
-
الطلّ على الجزّة والجفاف على الأرض يشبه بني إسرائيل لأنهم لما كانوا شعب الله المختار كان عليهم نعمة خصوصية دون غيرهم من شعوب الأرض. والطل على الأرض والجفاف في الجزة يشبه بني إسرائيل كما هم اليوم إذ رفضهم الله وقتياً وسكب نعمته على الذين ليسوا من نسل إبراهيم.
السابق |
التالي |