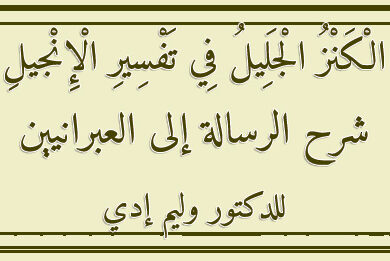الرسالة إلى العبرانيين | 03 | الكنز الجليل
الكنز الجليل في تفسير الإنجيل
شرح الرسالة إلى العبرانيين
للدكتور . وليم إدي
اَلأَصْحَاحُ ٱلثَّالِثُ
لما أثبت الكاتب فضل المسيح على الملائكة الذين ترتب العهد القديم بواسطتهم أخذ في مقابلة المسيح وتفضيله على موسى الذي استخدمه الله في إعلان الشريعة لبني إسرائيل وعلى رئيس الكهنة في المرتبة القديمة. غير أنه لا يذكر في بداءة هذا الأصحاح إلى المقابلة بينه وبين موسى تاركاً مقابلته برئيس الكهنة إلى معظم الرسالة من (ص ٤: ١٤ – ص ١٠). ثم بعد الكلام عليه وعلى موسى في هذا الأصحاح إلى (ع ٦) يقدم للعبرانيين مواعظ تحثهم على الثبات في الديانة المسيحية ولا ينتهي من ذلك إلا في (ص ٤: ١ – ١٤). وأما المقابلة التي أقامها بين المسيح وموسى فهي أن المسيح هو الباني لبيت الله الروحي وهو متسلط فيه تسلط الابن وما كان موسى إلا خادماً فيه (ع ٣ – ٦).
١ «مِنْ ثَمَّ أَيُّهَا ٱلإِخْوَةُ ٱلْقِدِّيسُونَ، شُرَكَاءُ ٱلدَّعْوَةِ ٱلسَّمَاوِيَّةِ، لاَحِظُوا رَسُولَ ٱعْتِرَافِنَا وَرَئِيسَ كَهَنَتِهِ ٱلْمَسِيحَ يَسُوعَ».
رومية ١: ٧ و١كورنثوس ١: ٢ وأفسس ٤: ١ وفيلبي ٣: ١٤ و٢تسالونيكي ١: ١١ وتيطس ١: ٩ و٢بطرس ١: ١٠ ورومية ١٥: ٨ وص ٢: ١٧ و٤: ١٤ و٥: ٥ و٦: ٢٠ و٨: ١ و٩: ١١ و١٠: ٢١ و١صموئيل ١٢: ٦
مِنْ ثَمَّ هو في الأصل حرف يدل على المكان ثم على نتيجة مما تقدم وهكذا هو في العربية بدلالة الالتزام فهو قياس في مثل هذا المقام بمعنى بناء على ذلك. والمراد أنه بناء عل ما تقدم من جهة كون المسيح رحيماً ورئيس كهنة أميناً (ص ٢: ١٧) الخ يجب علينا أن ننظر جيداً إلى صفات المسيح قبل أن نرفضه.
أَيُّهَا ٱلإِخْوَةُ في الإيمان المسيحي والذين مؤاساتنا لهم مؤاساة الإخوة.
ٱلْقِدِّيسُونَ تسمية المسيحيين «بالقديسين» كثيرة في العهد الجديد والمراد إما إن كل مسيحي بالحق قد نال من الله بداءة عمل التقديس في قلبه وهي الصفة المستولية عليه فتُنسب إليه أو أن كل مسيحي مفرز لخدمة المسيح بناء على أن الكلمة في استعمالها الأصلي عند العبرانيين تفيد الإفراز حقيقة والقداسة وضعاً ثانياً كما يُدعى شعب اليهود في العهد القديم مقدساً أو مُفرزاً.
شُرَكَاءُ ٱلدَّعْوَةِ ٱلسَّمَاوِيَّةِ نعت آخر للإخوة والمعنى أن لهم نصيباً أو هم متشاركون في بركات العهد الجديد المقدمة لهم في الإنجيل. ووُصفت هذه الدعوة بكونها «سماوية» إما لكونها من السماء والآتي بها هو المسيح النازل من السماء أو لكون منتهاها في السماء وفيها بركات أفضل جداً من بركات كنعان الأرضية. وهنا نرى بداءة ما أتى كثيراً في هذا الرسالة من المقابلة بين الأرض والسماء وبين الجسديات والروحيات وبين الزائل والباقي فإن ما في السماء حقيقي وأما ما على الأرض فهو مثل فقط ورمز (ص ٩: ٢٣) وهناك المسكن الحقيقي والمدينة التي لها أساسات (ص ١٢: ٢٧) وهي الوطن الأفضل الذي ابتغاه الآباء (ص ١١: ١٦) وأُعلنت لنا هذه السماويات بالمسيح الذي أتى من السماء ودخلها أيضاً كسابق لأجلنا (ص ٦: ٢٠) ورئيس كهنة (ص ١٠: ١٩).
لاَحِظُوا أي تأملوا جيداً فإذا تأملتم في صفات المسيح وفضله على موسى لا ترجعون عنه.
رَسُولَ مُرسل على الاستعمال الغالب في العهد القديم والجديد وبناء على ذلك يكون المعنى أن المسيح رسول الله لوضع الديانة المسيحية. وقد تحتمل الكلمة معنى آخر يوافق رتبة إدارة المجمع عند اليهود وبعضهم يقول إن هذا هو المراد هنا بدليل تدبير البيت الذي أشار إليه في الآيات اللاحقة.
ٱعْتِرَافِنَا أي الرسول الذي اعترفنا به وتمسكنا به. وهنا تمييز بين موسى الذي اعترف به اليهود بأن الله أرسله إليهم وبين المسيح الذي يعترف به المؤمنون في العهد الجديد.
وَرَئِيسَ كَهَنَتِهِ ٱلْمَسِيحَ يَسُوعَ قد تسمى المسيح «برئيس كهنة» لأنه سبقت له هذه التسمية في العهد القديم (مزمور ١١٠: ٤) ولأن الكاتب يقابله برئيس الكهنة عند اليهود ولأن هذه الوظيفة كانت عند اليهود رمزاً إلى الوظيفة التي تممها المسيح بتقديمه ذاته ذبيحة عن خطايا الناس. وربما كان هنا إشارة إلى اجتماع وظيفة موسى ووظيفة هرون في المسيح الأولى الرئاسة والإدارة في بيت الله والثانية تقديم الذبائح والاستغفار عن الخطيئة أي أن المسيح أعلن لنا إرادة الله ووضع لنا الديانة المسيحية وقدّم ذاته كفارة للخطايا فكان رسولاً كموسى وكاهناً كهرون.
٢ «حَالَ كَوْنِهِ أَمِيناً لِلَّذِي أَقَامَهُ، كَمَا كَانَ مُوسَى أَيْضاً فِي كُلِّ بَيْتِهِ».
١صموئيل ١٢: ٦ وعدد ١٢: ٧ وع ٥
حَالَ كَوْنِهِ أي المسيح.
أَمِيناً في بناء الكنيسة المسيحية وإدارتها قائماً بذلك حق القيام.
لِلَّذِي أَقَامَهُ أي الآب السماوي «الذي قدسه الآب وأرسله إلى العالم الخ» (يوحنا ١٠: ٣٦). وقد أُقيم المسيح على ما سبق رسولاً من الله لأجل تأسيس الكنيسة المسيحية.
كَمَا كَانَ مُوسَى أَيْضاً أي أميناً في خدمته في العهد القديم وربما في هذا الكلام إشارة إلى شهادة الله لموسى حيث قال «أَمَّا عَبْدِي مُوسَى فَلَيْسَ هٰكَذَا، بَلْ هُوَ أَمِينٌ فِي كُلِّ بَيْتِي» (عدد ١٢: ٧).
فِي كُلِّ بَيْتِهِ معنى «البيت» هنا أهله ثم الشعب أو الكنيسة المقامة لله والمراد أن موسى كان أميناً في تعليم شعبه جميع العبارة أن المسيح لم يكن أقل أمانة من موسى في تأسيس كنيسته على دعائم الحق وأنه كما كان موسى أميناً في خدمته في الكنيسة اليهودية هكذا المسيح في الكنيسة المسيحية. غير أنه كما أنهما متساويان في الأمانة من هذا القبيل يفضل المسيح موسى من وجه ذكره في الآية التابعة.
٣ «فَإِنَّ هٰذَا قَدْ حُسِبَ أَهْلاً لِمَجْدٍ أَكْثَرَ مِنْ مُوسَى، بِمِقْدَارِ مَا لِبَانِي ٱلْبَيْتِ مِنْ كَرَامَةٍ أَكْثَرَ مِنَ ٱلْبَيْتِ».
زكريا ٦: ١٢ ومتّى ١٦: ١٨
فَإِنَّ هٰذَا أي المسيح.
قَدْ حُسِبَ أَهْلاً لِمَجْدٍ أي قد نال شرفاً ومقاماً أعلى.
أَكْثَرَ مِنْ مُوسَى المقابَل هو به.
بِمِقْدَارِ مَا لِبَانِي ٱلْبَيْتِ مِنْ كَرَامَةٍ أَكْثَرَ مِنَ ٱلْبَيْتِ المعنى هنا ظاهر نظراً إلى البناء والباني فإن الفضل لا يستقر في نفس البناء بل في الباني الذي رتب البناء. والكاتب يقول أنه لما كان هذا الأمر ظاهراً نتج من ذلك فضل المسيح على موسى لأن موسى كان جزءاً من البيت الذي أقامه أي عضواً من الكنيسة المعروفة بالموسوية ومحتاجاً إلى خدمتها كما كان يحتاج إليها شعب اليهود وأما المسيح فلم يكن محتاجاً إلى خدمة الكنيسة المسيحية أو كان عضواً منها بل كان مؤسسها فقط وقد فسر مراده بعد ذلك بقوله «وَمُوسَى كَانَ أَمِيناً فِي كُلِّ بَيْتِهِ كَخَادِمٍ… وَأَمَّا ٱلْمَسِيحُ فَكَٱبْنٍ» (ع ٥ و٦).
٤ «لأَنَّ كُلَّ بَيْتٍ يَبْنِيهِ إِنْسَانٌ مَا، وَلٰكِنَّ بَانِيَ ٱلْكُلِّ هُوَ ٱللّٰهُ».
أفسس ٢: ١٠ و٣: ٩ وص ١: ٢
لأَنَّ كُلَّ بَيْتٍ يَبْنِيهِ إِنْسَانٌ مَا كلمة «إنسان» لا وجود لها في اليونانية بل كلمة معناها أحدٌ ما.
وَلٰكِنَّ بَانِيَ ٱلْكُلِّ هُوَ ٱللّٰهُ لا يُعلم إن كان المراد هنا «بالكل» جميع البرايا أو كل جماعة دينية إشارة إلى الكنيسة اليهودية والكنيسة المسيحية ولعل القرينة تقتضي المعنى الثاني فإن الكلام فيهما. وعلى ذلك يكون معنى «بيت» في العبارة الأولى من هذه الباب أيضاً. ولكن ما هو المراد بهذا الكلام الذي معناه الظاهري جليّ وإنما موقعه في حجة الكاتب غامض. وقد يكون ذلك على أحد وجهين الوجه الأول أن كل جماعة مبنبة لله لا بد أن يبنيها أحد يقيمه الله لذلك على أن الباني الحقيقي الأصلي هو الله فأقام موسى في بناء كنيسة العهد القديم كخادم (ع ٥) وأقام المسيح في بناء كنيسة العد الجديد كابن (ع ٦). والوجه الثاني أن المراد «بباني الكل» المسيح الذي هو الله فإن موسى كان في بناء رتبته كخادم وأما المسيح فكابن.
٥ «وَمُوسَى كَانَ أَمِيناً فِي كُلِّ بَيْتِهِ كَخَادِمٍ، شَهَادَةً لِلْعَتِيدِ أَنْ يُتَكَلَّمَ بِهِ».
ع ٢ خروج ١٤: ٣١ وعدد ١٢: ٧ وتثنية ٣: ٢٤ ويشوع ١: ٢ و٨: ٣١ وتثنية ١٨: ١٥ و١٨ و١٩
وَمُوسَى كَانَ أَمِيناً فِي كُلِّ بَيْتِهِ قد تقدّم الكلام على أمانة موسى في خدمته (ع ٢). وأما قوله «بيته» فالضمير عائد إلى الله وهكذا في (ع ٢) والمعنى شعب الله المتمسكون بشريعته والعاملون إرادته. والمراد بجميع العبارة أن موسى كان أميناً في خدمته في كنيسة الله القديمة ولكن –
كَخَادِمٍ لا كرئيس على البيت كما كان المسيح (ع ٦) إلا أن الكلمة الأصلية معناها الخدمة الشريفة لا الدنيّة فإذ كان موسى خادماً في بيت الله لا رئيساً عليه كما كان المسيح كانت خدمته شريفة لأنها خدمة الله فإن العبد إذا كان عبداً لمملوك يكون دنيّاً وليس كذلك إذا كان عبداً لملك بل تفيد الكلمة حينئذ الشرف والأشرف من ذلك عبد الله أو رجل الله أو خادم الله. وأما خدمة موسى فكانت أنه اتبع أوامر الله في تعليمه الشعب اليهودي وترتيب رتبتهم الخاصة بهم. وتسمية الله فيه «أما عبدي موسى» الخ (عدد ١٢: ٧) ونتج منها أن موسى لم يكن مشترعاً أي واضعاً الشريعة بل كان مرسلاً من واضعها.
شَهَادَةً ليس المراد «بالشهادة» هنا أكثر من الإنذار والتعليم كما جرى استعمالها كثيراً بهذا المعنى في العهد الجديد (أعمال ٢٠: ٢١ و٢٣ و٢٤).
لِلْعَتِيدِ أَنْ يُتَكَلَّمَ يحتمل أن يكون المعنى لما كان مأموراً أن يعلّم به بني إسرائيل غير أن هذا التفسير لا يوافق زماناً مستقبلاً مشاراً إليه في كلام العبارة. فالأولى حمله مع جمهور المفسرين على الديانة المسيحية التي كانت تعاليم موسى تشير إليها كما يشير الرمز إلى المرموز إليه. ومما يؤيد هذا التفسير قول المسيح لليهود «لَوْ كُنْتُمْ تُصَدِّقُونَ مُوسَى لَكُنْتُمْ تُصَدِّقُونَنِي، لأَنَّهُ هُوَ كَتَبَ عَنِّي» (يوحنا ٥: ٤٦) بمعنى أن معظم ديانة موسى كانت رموزاً وإشارات تمت في المسيح وديانته. وإلى هذا الأمر يتجه أكثر هذا الرسالة.
٦ «وَأَمَّا ٱلْمَسِيحُ فَكَٱبْنٍ عَلَى بَيْتِهِ. وَبَيْتُهُ نَحْنُ إِنْ تَمَسَّكْنَا بِثِقَةِ ٱلرَّجَاءِ وَٱفْتِخَارِهِ ثَابِتَةً إِلَى ٱلنِّهَايَةِ».
ص ١: ٢ و١كورنثوس ٣: ١٦ و٦: ١٩ و٢كورنثوس ٦: ١٦ وأفسس ٢: ٢١ و٢٢ و١تيموثاوس ٣: ١٥ و١بطرس ٢: ٥ ومتّى ١٠: ٢٢ و٣٤: ١٣ ورومية ٥: ٢ وكولوسي ١: ٢٣ وع ١٤ وص ٦: ١١ و١٠: ٣٥
وَأَمَّا ٱلْمَسِيحُ في بنائه كنيسة العهد الجديد.
فَكَٱبْنٍ عَلَى بَيْتِهِ الضمير يعود على الأصح إلى الله أي كنيسة الله. وهنا قد ظهرت المقابلة بين موسى في الرتبة القديمة والمسيح في الرتبة الجديدة فالأول كان خادماً في بيت الله وهو عضو منه وخاضع لنظامه والثاني كان رئيساً عليه كابن لا كخادم. وجه الاتفاق بين موسى والمسيح هو الأمانة ووجها الاختلاف ما يأتي (١) إن موسى كان خادماً أما المسيح فابنٌ (٢) إن موسى كان ضمن البيت وأحد أهله وأما المسيح ففوق البيت. وكانت أمانة المسيح آخر أي أمانة ابن. والبيت هو بيت واحد مع اختلاف خدمته فإنه للكنيسة الموسوية الرموز وللكنيسة المسيحية المرموز إليه وللكنيسة الموسوية الصّور وللكنيسة المسيحية الحقيقة.
وَبَيْتُهُ نَحْنُ أي نحن شعب الله وكنيسته ويريد بالضمير جميع الذين يعترفون بالديانة المسيحية يهوداً كانوا أو أمماً.
إِنْ تَمَسَّكْنَا أي نكون من شعب الله بشرط أن تمسك –
بِثِقَةِ ٱلرَّجَاءِ وَٱفْتِخَارِهِ الكلمة المترجمة هنا «ثقة» معناها الأول حرية التكلم بجراءة ثم استعملت للدلالة على الجراءة والثقة و «الرجاء» هو ما يُرجى من نيل المغفرة هنا والخلاص الأبدي بعد الموت «وافتخاره» نعت فيه المعنى للرجاء أي هو رجاء يفتخر به. والمعنى إن تمسكنا بثقة بالرجاء الثمين المجيد الجدير أن يُفتخر به أو الذي يُوثق أن يُفتخر به.
ثَابِتَةً حال من ثقة بحسب تركيب الترجمة العربية وقد يكون المعنى عائداً إلى «التمسك» أي إذا تمسكنا تمسكاً ثابتاً –
إِلَى ٱلنِّهَايَةِ أي إلى نهاية الحياة. والمراد بجميع العبارة أننا نكون من شعب الله وأهله إذا تمسكنا بالإقرار المسيحي والرجاء المجيد الذي تقدمه لنا الديانة المسيحية على الدوام وإلى النهاية ولو احتملنا ما عظُم من الاضطهاد والمقاومة بشأن ذلك. وفي هذا الكلام مناسبة عظيمة لحال العبرانيين المؤمنين بالمسيح الذين كانوا يحتملون المقاومة لأجل إيمانهم وكانوا في خطر من الارتداد عنه.
٧ «لِذٰلِكَ كَمَا يَقُولُ ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ: ٱلْيَوْمَ إِنْ سَمِعْتُمْ صَوْتَهُ».
٢صموئيل ٢٣: ٢ وأعمال ١: ١٦ ومزمور ٩٥: ٧ وع ١٥
هنا الكاتب يخاطب اليهود المؤمنين بكلام منقول عن العهد القديم موافق لحالهم بقصد تثبيتهم في إيمانهم وعدم ارتدادهم عنه.
لِذٰلِكَ أي بناء على ما تقدم من فضل المسيح على موسى أو بناء على ما أتى في الآية السابقة من قوله «وبيته نحن إن تمسكنا» الخ وتكملة الجملة غير واضحة والأرجح أنها في (ع ١٢) والمعنى بما أنكم بيت الله… لذلك… انظروا أن لا يكون الخ.
كَمَا يَقُولُ ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ (مزمور ٩٥: ٧ – ١١) عندما يقتبس الكاتب هذه الكلمات مرة أخرى في (ص ٤: ٧) يقول أن داود قائلها وهنا ينسب القول إلى الروح القدس فيكون المعنى أن الروح القدس كان يتكلم بفم داود أو بكلام آخر كان داود ملهماً من الروح القدس في ما كتبه. ومن هذا كثير في العهد الجديد والمراد أن الكتب المقدسة ألهم الروح القدس بها.
ٱلْيَوْمَ بمعنى الآن وفيه تمييز للعهد الجديد عن العهد القديم.
إِنْ سَمِعْتُمْ صَوْتَهُ أي بينما أنتم تسمعون صوته. صوت الله في العهد القديم وصوت ابنه الآن. والموضوع مقدر ولكنه ظاهر مما سيأتي وهو الدخول إلى راحته. «صوته» أي أقواله المنذرة التي تحثكم على الدخول إلى الراحة.
٨ «فَلاَ تُقَسُّوا قُلُوبَكُمْ، كَمَا فِي ٱلإِسْخَاطِ، يَوْمَ ٱلتَّجْرِبَةِ فِي ٱلْقَفْرِ».
فَلاَ تُقَسُّوا قُلُوبَكُمْ يراد «بالقلب» على طريق المجاز مجلس العواطف والإحساسات فإذا وصل الأمر في الإنسان إلى عدم الإحساس يقال أنه قاسي القلب. والمراد هنا بقساوة القلب أن أوامر الله ووعده ووعيده لا تؤثر فيه. والإنسان قد يأتي بنفسه إلى هذه الحالة بواسطة مبادئ الكفر والرداءة والتصرفات الشهوانية وترك الصلاة والاجتماعات الروحية ومطالعة الكتاب المقدس واستماع الكلمة بدون الطاعة لها. وأما النهي في العبارة فمعناه لا تسلّموا أنفسكم إلى مبادئ غير صحيحة في الدين وإلى التطوّح في الدنيا حتى تقسو قلوبكم فلا يفعل فيكم صوت الله.
كَمَا فِي ٱلإِسْخَاطِ الإغضاب أو المغاضبة الشديدة وإنما الكلمة في المكان الأصلي المنقولة عنه جميع العبارة (مزمور ٩٥: ٧) الخ مريبة حيث خاصم الإسرائيليون الله وتذمروا عليه (خروج ١٧: ٧) فدُعي اسم ذلك المكان مريبة أي الخصام. ولم تكن هذه الواقعة الوحيدة التي فيها أغضب الله بنو إسرائيل وإنما أُشير إليها على الخصوص لأنهم أظهروا عدم إرادتهم في الدخول إلى أرض كنعان فلذلك أقسم الله أن لا يدخلها أهل ذلك الجيل.
يَوْمَ ٱلتَّجْرِبَةِ فِي ٱلْقَفْرِ الإشارة إلى زمان تيه بني إسرائيل في القفر ولا سيما واقعة مريبة.
٩ «حَيْثُ جَرَّبَنِي آبَاؤُكُمُ. ٱخْتَبَرُونِي وَأَبْصَرُوا أَعْمَالِي أَرْبَعِينَ سَنَةً».
حَيْثُ جَرَّبَنِي آبَاؤُكُمُ سلفاؤكم وأما قوله «جربني» فالفعل في اليوناني معناه (١) التملق للخطية وليس هذا المراد هنا. (٢) الامتحان وهو المراد أي أن عدم إيمان الإسرائيليين وتذمّرهم كانا (كما تكلم على الإنسان) امتحاناً لصبر الله وطول أناته.
ٱخْتَبَرُونِي امتحنوني أيضاً والتكرار لزيادة الإيضاح.
وَأَبْصَرُوا أَعْمَالِي أَرْبَعِينَ سَنَةً الواو هنا بمعنى مع أن أي أنهم كانوا يجربون الله مع أن أعماله وعنايته والمعجزات التي أجراها أمامهم ولأجلهم كانت ظاهرة بينهم مدة أربعين سنة. تعلق الظرف هنا بقوله «أبصروا» أي أنهم أبصروا أعماله مدة هذه السنين المذكورة. وأما في العبراني فبحسب تقسيم المزمور إلى أعداد قد علقوا الظرف بقوله «مقتّ» في العدد التالي ولا فرق في المعنى فإنه تعالى إن كان مقتهم أربعين سنة فذلك لأنهم جربوه أربعين سنة وإن كانوا جربوه أربعين سنة فمقتهم تلك المدة كلها.
١٠ «لِذٰلِكَ مَقَتُّ ذٰلِكَ ٱلْجِيلَ، وَقُلْتُ إِنَّهُمْ دَائِماً يَضِلُّونَ فِي قُلُوبِهِمْ، وَلٰكِنَّهُمْ لَمْ يَعْرِفُوا سُبُلِي».
لِذٰلِكَ أي لأجل تجربتهم إياي وهذه الكلمة ليس لها وجود لا في العبراني ولا في الترجمة السبعينية وقد أضافها الكاتب لبيان المعنى.
مَقَتُّ أي غضبت وكرهت.
ذٰلِكَ ٱلْجِيلَ أي أهله.
وَقُلْتُ القائل هو الله.
إِنَّهُمْ دَائِماً يَضِلُّونَ فِي قُلُوبِهِمْ فلم يكن ضلالهم عقلياً من ضعف أو تشويش في القوة الحاكمة فإن هذا يُعذر في أكثر الأحوال بل كان في قلوبهم أي أنه كان ناتجاً عن فساد في القلب وانحراف رديء فيهم كما أن أكثر الضلال الذي في العالم راجع إلى هذا المصدر.
وَلٰكِنَّهُمْ لَمْ يَعْرِفُوا سُبُلِي كلمة «ولكن» من صلة قوله «وأبصروا أعمالي» فالمعنى أبصروا أعمال ولكنهم لم يعرفوا سبلي. والبعض يترجمون الحرف الأصلي بحرف عطف على نفي فيقال «ولم يعرفوا سبيلي» أي ولم يفهموا ويستصوبوا طرقي فلم يثقوا بي ويسلموا لي عندما أخرجتهم من أرض مصر لأجل إدخالهم إلى أرض كنعان.
١١ «حَتَّى أَقْسَمْتُ فِي غَضَبِي لَنْ يَدْخُلُوا رَاحَتِي».
حَتَّى حرف ابتداء يفيد التعليل. والتقدير أنه لأجل عدم إيمانهم وتجربتهم إياي وقصاصاً لهم على ذلك.
أَقْسَمْتُ فِي غَضَبِي الذي حرّكوه بواسطة شرّهم. والقول هنا من جهة الله مجازي من باب أن يُنسب إليه ما يُنسب إلى الإنسان. فالأقسام والغضب ليسا في الله حقيقة وإنما نُسبا إليه كما يُنسبان إلى الإنسان لكي نقدر أن نفهم أعماله تعالى التي كانت من جهة بني إسرائيل كما تكون أعمال الإنسان. فليس المراد أكثر من أن الله حقق لهم أن لا يدخلوا راحته مجازاة عادلة على أعمالهم.
لَنْ يَدْخُلُوا «لن» حرف نفي في العبراني يتبع القسم. وفي العربية قد اختلفوا هل يفيد زماناً مقيداً أو بلا نهاية والصحيح أنه قد تغلب استعماله بالمعنى الآخر وقد ورد أحياناً بالمعنى الأول. والمراد هنا لا يدخلونها أبداً لأنهم ماتوا جميعاً في البرية ما عدا يشوع وكالب ودخلها أولادهم فقط.
رَاحَتِي أما راحته في اقتياد بني إسرائيل إلى كنعان كما قيل أنه «استراح في اليوم السابع» أو هي الراحة التي أعدها لهم بالنظر إلى عبوديتهم في مصر ومشقات الطريق وهو الأصح.
١٢ «اُنْظُرُوا أَيُّهَا ٱلإِخْوَةُ أَنْ لاَ يَكُونَ فِي أَحَدِكُمْ قَلْبٌ شِرِّيرٌ بِعَدَمِ إِيمَانٍ فِي ٱلارْتِدَادِ عَنِ ٱللّٰهِ ٱلْحَيِّ».
في هذه الآية وما يليها يذكر الكاتب مناسبة الاقتباس الذي سبق من جهة بني إسرائيل لليهود المؤمنين بالإنجيل. فإنه كما أن الإسرائيليين جربوا الله بعدم إيمانهم فأقسم أنهم لن يدخلوا أرض كنعان كذلك المسيحيون من اليهود الذين إذا ربوا عدم الإيمان في قلوبهم فلا يدخلون كنعان السماوية.
اُنْظُرُوا أَيُّهَا ٱلإِخْوَةُ بناء على ما تقدم من حال الإسرائيليين.
أَنْ لاَ يَكُونَ فِي أَحَدِكُمْ قَلْبٌ شِرِّيرٌ كما كان فيهم لما جربوا الله وأخطأوا فنالوا القصاص.
بِعَدَمِ إِيمَانٍ أي غير مؤمن وهو يعود إلى «قلب» ومفسر لقوله «شرير».
فِي ٱلارْتِدَادِ عَنِ ٱللّٰهِ أي الرجوع عنه تعالى إلى الديانة المسيحية والكفر بإنجيله. وربما في ذلك إشارة إلى قول العبرانيين بعضهم لبعض وهم على الطريق «نُقِيمُ رَئِيساً وَنَرْجِعُ إِلَى مِصْرَ» (عدد ١٤: ٤).
ٱلْحَيِّ وقد وُصف تعالى «بالحي» إما لكونه حياً بالنظر إلى الآلهة الكاذبة التي ليس فيها حياة أو لكونه الدائم كما وصف الماء بكونه حياً (يوحنا ٤: ١١ و٧: ٣٨) أي غير منقطع بالنظر إلى المياه التي تتقطع فلا تجري في أزمنة الجفاف مثلاً أو لكونه مصدر الحياة ومعطيها.
١٣ «بَلْ عِظُوا أَنْفُسَكُمْ كُلَّ يَوْمٍ، مَا دَامَ ٱلْوَقْتُ يُدْعَى ٱلْيَوْمَ، لِكَيْ لاَ يُقَسَّى أَحَدٌ مِنْكُمْ بِغُرُورِ ٱلْخَطِيَّةِ».
بَلْ أي بدلاً من عدم الإيمان والارتداد.
عِظُوا أَنْفُسَكُمْ بمعنى بعضكم بعضاً.
كُلَّ يَوْمٍ أي على الدوام.
مَا دَامَ ٱلْوَقْتُ يُدْعَى ٱلْيَوْمَ أي ما دام لكم الزمان والفرصة.
لِكَيْ لاَ يُقَسَّى أَحَدٌ مِنْكُمْ فيبطل شعور القلب بتأثير الحق.
بِغُرُورِ ٱلْخَطِيَّةِ أي بواسطة خداع الخطية التي تتملق الإنسان وتغشه سواء كان ذلك من خوف الاضطهاد أو من طبيعة الخطية مطلقاً التي شأنها أن تقود الإنسان من طاعة الله إلى ولايتها عليه أو من الوساوس التي يقررها في أذهانهم المعلمون الكذبة.
١٤ «لأَنَّنَا قَدْ صِرْنَا شُرَكَاءَ ٱلْمَسِيحِ، إِنْ تَمَسَّكْنَا بِبَدَاءَةِ ٱلثِّقَةِ ثَابِتَةً إِلَى ٱلنِّهَايَةِ».
ع ٦
لأَنَّنَا قَدْ صِرْنَا شُرَكَاءَ أي قد صار لنا نصيب في –
ٱلْمَسِيحِ أي في بركات ديانة المسيح أو كنيسته.
إِنْ تَمَسَّكْنَا أي بقينا متمسكين.
بِبَدَاءَةِ ٱلثِّقَةِ ترجمة حرفية عن اليوناني واليوناني أسلوب عبراني حيث يجعلون الصفة مضافاً الموصوف مضافاً إليه فيكون المعنى الثقة المبدوء بها أي الإيمان الوثيق الذي ابتدأتم به.
ثَابِتَةً إِلَى ٱلنِّهَايَةِ أي بدون انقطاع إلى نهاية التجربة للعدول عنها أو إلى نهاية الحياة.
١٥ «إِذْ قِيلَ: ٱلْيَوْمَ إِنْ سَمِعْتُمْ صَوْتَهُ فَلاَ تُقَسُّوا قُلُوبَكُمْ، كَمَا فِي ٱلإِسْخَاطِ».
ع ٧
إِذْ قِيلَ معنى اليوناني بالنظر إلى ما قيل أو كما قيل والمراد تذكير المخاطبين بما اقتبسه سابقاً ولم يذكر هنا إلا بعضه وقد سبق تفسير قوله –
ٱلْيَوْمَ إِنْ سَمِعْتُمْ صَوْتَهُ فَلاَ تُقَسُّوا قُلُوبَكُمْ، كَمَا فِي ٱلإِسْخَاطِ (ع ٨) «اليوم» أي الآن بينما أنتم تسمعون صوته.
١٦ «فَمَنْ هُمُ ٱلَّذِينَ إِذْ سَمِعُوا أَسْخَطُوا؟ أَلَيْسَ جَمِيعُ ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ مِصْرَ بِوَاسِطَةِ مُوسَى؟».
عدد ١٤: ٢ و٤ و١١ و٢٤ و٣٠ وتثنية ١: ٣٤ و٣٦ و٣٨
فَمَنْ هُمُ ٱلَّذِينَ وفي بعض التراجم «بعضهم إذ سمعوا أسخطوا».
إِذْ سَمِعُوا خبر الجواسيس الذين وردت قصتهم في سفر العدد (ص ١٣ و١٤) أو صوت الله المشار إليه في العدد السابق وهو الأقرب.
أَسْخَطُوا أي حركوا غضب الله عليهم.
أَلَيْسَ بحسب مقتضى العبارة الكلام على طريق الاستفهام ولكن من لا يجعل الجزء الأول منها استفهامياً يترجم الكلمة الأصلية هنا بغير أن. وعلى ذلك يكون المعنى أن بعضهم إذ سمعوا أسخطوا الله فمنعهم من الدخول إلى كنعان غير أن ليس جميع الذين خرجوا من مصر أسخطوا ومنعوا من الدخول بل بعضهم دخل. هذا كان تفسير أكثر القدماء وأما المحققون المتأخرون فيفهمون العبارة كما تُرجمت في العربية وهو الأصح لأن الذين أسخطوا لم يكونوا البعض بل الأكثرين.
جَمِيعُ البالغين إلا يشوع وكالب وبعضهم يستثني اللاويين أيضاً لعدم مشاركتهم في الحروب.
ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ مِصْرَ بِوَاسِطَةِ مُوسَى أي تحت رئاسته.
١٧ «وَمَنْ مَقَتَ أَرْبَعِينَ سَنَةً؟ أَلَيْسَ ٱلَّذِينَ أَخْطَأُوا، ٱلَّذِينَ جُثَثُهُمْ سَقَطَتْ فِي ٱلْقَفْرِ؟».
عدد ١٤: ٢٢ و٢٩ الخ و٢٦: ٦٥ ومزمور ١٠٦: ٢٦ و١كورنثوس ١٠: ٥ ويهوذا ٥
وَمَنْ مَقَتَ أَرْبَعِينَ سَنَةً الظرف المعلق هنا «بمقتَ» كان معلقاً في الأصل بقوله «أبصروا أعمالي» (ع ١٠).
أَلَيْسَ ٱلَّذِينَ أَخْطَأُوا لما عصوا الله وتذمروا عليه لعدم إيمانهم.
ٱلَّذِينَ جُثَثُهُمْ في الأصل أعضاؤهم من باب استعمال البعض للكل.
سَقَطَتْ فِي ٱلْقَفْرِ أي هلكوا قبل وصولهم إلى أرض كنعان.
١٨ «وَلِمَنْ أَقْسَمَ لَنْ يَدْخُلُوا رَاحَتَهُ، إِلاَّ لِلَّذِينَ لَمْ يُطِيعُوا؟».
عدد ١٤: ٣٠ وتثنية ١: ٣٤ و٣٥
وَلِمَنْ أَقْسَمَ لَنْ يَدْخُلُوا رَاحَتَهُ، إِلاَّ لِلَّذِينَ لَمْ يُطِيعُوا الكلمة الأصلية لقوله «الذين لم يطيعوا» قد ترجمها جمهور المفسرين بالذين لم يؤمنوا وأما الترجمة العربية فمسندة إلى قاموس العلامة روبنصن ومثلها في (ص ١١: ٣١) وكثير من المحققين يفهمها بالمعنى المذكور.
١٩ «فَنَرَى أَنَّهُمْ لَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يَدْخُلُوا لِعَدَمِ ٱلإِيمَانِ».
ص ٤: ٦
فَنَرَى أَنَّهُمْ لَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يَدْخُلُوا لِعَدَمِ ٱلإِيمَانِ فكانت جبانتهم ناتجة عن عدم إيمانهم بالله الذي وعدهم بأنه يكون معهم في حروبهم ويعطيهم النجاح والغلبة والتملك مع أن يد الله كانت ظاهرة بينهم بالآيات لإجارتهم وإنقاذهم فكانت الحجة عليهم كما كانت على بني البشر الذين على رغم ما أعلنه الله في نور الطبيعة ونور الوحي من جهة عالم الثواب والعقاب يخطئون لعدم إيمانهم. وهكذا دخلت الخطية في أول الأمر لما عصى أبوانا الأولان الله ولم يؤمنا بأنهما إذا أكلا من الشجرة التي نهاهما عن الأكل منها يموتان. وكانت غاية الكاتب في جميع هذا الكلام أن يبين أن خطية الكفر عظيمة جداً أمام الله وتؤدي إلى عقاب شديد للذين يسقطون فيها.
- إنه يجب على جميع الذين يسمعون الإنجيل ويقرون به أن يكونوا إخوة مقدسين. وجميع الذين هم شركاء الدعوة السماوية يُقدسون ويتحدون برباطات المحبة.
- إن الأمانة لله واجبة على كل إنسان مهما كانت خدمته ولا سيما على المقامين لخدمة الله في الأشياء المقدسة. لكن مهما كان الإنسان أميناً فلا يزال قاصراً جداً عن المطلوب منه وعن المثال السامي الذي قدمه لنا المسيح في خدمته على الأرض لأبيه السماوي وللبشر الذين نزل لكي يخلصهم.
- إنه كما أن الخليقة والإتقان العجيب الذي يُشاهد فيها برهان لا يُرد على أن مصدرها هو الله كذلك جميع ما يُشاهد في حياة المسيحيين من التقوى والصلاح والرحمة وعمل الخير برهان على أن واضع الديانة المسيحية والعامل بها في قلوب البشر لم يكن إنساناً فقط بل كان إلهاً أيضاً.
-
إن عدم الإيمان من الأمور التي يكرهها الله شديد الكره والمضرّة بالنفس. وإذا كان البرهان كافياً لإحداثه وأصرّ الإنسان على الكفر دل ذلك على قساوة القلب. ولما كان عدم الإيمان حينئذ غير معذور عليه فيعامله الله بالسخط والقصاص كما عامل الإسرائيليين أربعين سنة في التيه وحرم ذلك الجيل غير المؤمن من الدخول إلى أرض كنعان.
السابق |
التالي |