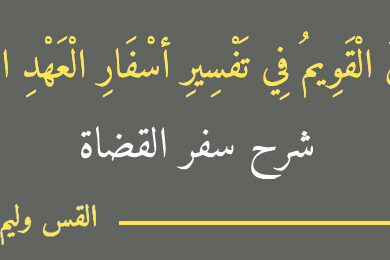سفر القضاة | 03 | السنن القويم
السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم
شرح سفر القضاة
للقس . وليم مارش
اَلأَصْحَاحُ ٱلثَّالِثُ
تأثير الأمم الباقية في أرض كنعان ع ١ إلى ٧
١ «فَهٰؤُلاَءِ هُمُ ٱلأُمَمُ ٱلَّذِينَ تَرَكَهُمُ ٱلرَّبُّ لِيَمْتَحِنَ بِهِمْ إِسْرَائِيلَ، كُلَّ ٱلَّذِينَ لَمْ يَعْرِفُوا جَمِيعَ حُرُوبِ كَنْعَانَ».
ص ٢: ٢١ و٢٢
فَهٰؤُلاَءِ هُمُ ٱلأُمَمُ بيان هؤلاء الأمم في (ع ٣) وهو قوله «أقطاب الفلسطينيين الخمسة» الخ.
تَرَكَهُمُ ٱلرَّبُّ (انظر تفسير ص ٢: ٢٣).
لِيَمْتَحِنَ بِهِمْ إِسْرَائِيلَ الامتحان عمل يتبين به الصحيح من الباطل والصواب من الخطإ والصالح من الشرير إلى غير ذلك من الأضداد والمختلفات. وبالإيجاز إنه عمل تتميز به الأحكام المختلفة. ومعناه هنا كمعناه في (ع ٤ وص ٢: ٢٢) ففيه زيادة التمحيص والتدريب. والمراد «بإسرائيل» هنا الإسرائيليون الذين بعد يشوع ومن عاصره من الشيوخ (ص ٢: ٧ – ١٠).
جَمِيعَ حُرُوبِ كَنْعَانَ أي محاربات الرب للكنعانيين وكسرهم بواسطة الإسرائيليين ولذلك عُرفت تلك الحروب «بحروب الرب» (عدد ٢١: ١٤). والمراد بقوله «لم يعرفوا» نفي المعرفة عن جميع الحروب فكأنه قال جهلوا جميع حروب الخ. وهذا يدل فوق عدم مشاهدتهم إياها على عدم سمعهم أنبائها لإهمالهم كل ما يتعلق بأعمال الرب. ويتبين مما يأتي أنهم لم يحاربوا شيئاً وإنهم كانوا يجهلون أساليب الحرب كل الجهل (ع ٢).
٢ «إِنَّمَا لِمَعْرِفَةِ أَجْيَالِ بَنِي إِسْرَائِيلَ لِتَعْلِيمِهِمِ ٱلْحَرْبَ. ٱلَّذِينَ لَمْ يَعْرِفُوهَا قَبْلُ فَقَطْ».
إِنَّمَا لِمَعْرِفَةِ أي ما ترك الرب الأمم في أرض كنعان إلا لمعرفة أجيال إسرائيل الخ.
أَجْيَالِ بَنِي إِسْرَائِيلَ أي أهل كل عصر منهم على التوالي.
لِتَعْلِيمِهِمِ ٱلْحَرْبَ بمقاومة الأمم لهم ومضايقتهم إياهم فإنهم بذلك يضطرون إلى محاربتهم فيتعلمون الحرب.
ٱلَّذِينَ لَمْ يَعْرِفُوهَا قَبْلُ الصفة هنا لبيان الواقع لا للتمييز لأن كل الإسرائيليين كانوا حينئذ يجهلون الحرب.
فَقَطْ أي لما ذُكر فقط لا لأنه سُرّ بسلامة الأمم ومقاومتهم لشعبه.
والعبارة الأصلية بردّ المحذوف ما يأتي (وقد أشرنا إلى الكلمات الأصلية بعلامات الاقتباس) «إنما» ترك الرب الأمم في كنعان «لمعرفة أجيال بني إسرائيل» و«لتعليمهم الحرب» إنهم «الذين لم يعرفوها قبل» ولهذه الغاية «فقط» تركهم.
وبهذا البيان لم يبقَ من منافاة بين هذه الآية والآيتين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين من الأصحاح الثاني.
ولا ريب أن الإسرائيليين كانوا مضطرين إلى معرفة الحرب لأنهم لا يستطيعون بدونها أن يملكوا أرض ميعادهم لأن الله وعدهم بأن يملكوها بالحرب وبأنه يساعدهم على ذلك بشرط توحيده وعبادته وحفظ وصاياه وإطاعته. وإن أعداءهم كانوا كثيرين من الكنعانيين وغيرهم من أمم فلسطين وهم بمضايقتهم للإسرائيليين يحملونهم على النهوض للحرب فلو بقوا جاهلين إياها قرضتهم الأمم ولم تبق لهم بقية. فعلى توالي المضايقة او الحروب تعلموا القتال وقهروا الفلسطينيين واستولوا على أرض ميراثهم حتى صارت مملكتهم بعدئذ من البحر إلى النهر أي من ذلك الحبر إلى نهر الفرات. على أنه لولا أن الرب كان معهم وعلمهم لابتلعتهم الأمم وترك الشعب إله إسرائيل واستخفوا به وعظموا آلهة الأمم الباطلة. ويأبى الله إلا أن يرفع شعبه ويرفع دينه على كل أديان البرايا.
٣ «أَقْطَابُ ٱلْفِلِسْطِينِيِّينَ ٱلْخَمْسَةُ وَجَمِيعُ ٱلْكَنْعَانِيِّينَ وَٱلصَّيْدُونِيِّينَ وَٱلْحِوِّيِّينَ سُكَّانِ جَبَلِ لُبْنَانَ مِنْ جَبَلِ بَعْلِ حَرْمُونَ إِلَى مَدْخَلِ حَمَاةَ».
يشوع ١٣: ٣
أَقْطَابُ ٱلْفِلِسْطِينِيِّينَ ٱلْخَمْسَةُ وفي العبرانية «حمشة سرَني فلشتيم» أي خمسة أقطاب الفلسطينيين واصل سِرَني سِرَنيم حُذفت منها الميم لأن ميم الجماعة في العبرانية تحذف بالإضافة كما تحذف نون جمع السالم بها في العربية. وترجمها بعضهم بأرباب أو أسياد وفي الترجمة السبعينية مرازبة أو حكام وكذا في الفلغاتا وفي غيرها أمراء. قال بعضهم والظاهر أنه كلمة اصطلاحية يلقب بها الحكام أو لقب موضعي لهم وأصلها فينيقي ولفظة سِرِن مدار والمرجّح إنه سيد القوم الذي يدور عليه أمرهم وهذا من معاني القُطب في العربية. وأقطاب الفلسطينيين هم أرباب المدن الخمس جتّ وأشدود وغزّة واشقلون وعقرون أو حكامها (انظر يشوع ١٣: ٣ و١صموئيل ٦: ١٧). والظاهر أن الفلسطينيين ليسوا تحت حكم ملكي كما كانوا في زمان صموئيل وداود. وقوله «أقطاب الفلسطينيين» بيان لقوله في أول الأصحاح «هؤلاء هم الأمم».
والفلسطينيون كسلوحيّون أي مصريون وكفتوريون أي كريتيون في الأصل ولعل اسم فلسطين يشير على أنهم ليسوا من سكان الأرض المقدسة في الأصل فإن معناها بلاد المتغربين (تكوين ١٠: ١٤ وتثنية ٢: ٢٣ و١أيام ١: ١٢) والكلام على فلسطين والفلسطينيين بالتفصيل في قاموس الكتاب.
وَجَمِيعُ ٱلْكَنْعَانِيِّينَ هم سلالة كنعان وهو ابن حام الرابع ابن نوح (تكوين ١٠: ٦) والمراد بهم هنا على ما يظهر قسم منهم وهم سكان فينيقية أو السهول البحرية التي قاعدتها صيدون المعروفة اليوم بصيداء سُميت باسم صيدون بن كنعان الأكبر (تكوين ١٠: ١٥) وهؤلاء لم يخضعوا لإسرائيل كل الخضوع قط.
ٱلصَّيْدُونِيِّينَ سكان صيدون وقراها. وهؤلاء بقوا مستقلين إلى النهاية.
وَٱلْحِوِّيِّينَ وهم أمة من نسل كنعان (تكوين ١٠: ١٧).
سُكَّانِ جَبَلِ لُبْنَانَ وفي سفر يشوع إن الحويين كانوا يسكون تحت حرمون في أرض المصفاة (يشوع ١١: ٣) وربما هي بقعة مصفاة ويظن أنها البقاع بين لبنان والجبل الشرقي. واسمهم منسوب إلى حوّة وتُلفظ في العبرانية حُقة أي محلة أو قرية مستديرة. وفي العربية صفّ حوله أحدق به واستدار. ونُسبوا إلى ذلك لأنهم كانوا يسكنون في قرى مستديرة في مركزها حظائر الغنم والبقر. وظن إوَلد إن معنى الكلمة سكان داخل البلاد. وقال جسينيوس إن معناها القرويون. والحوي هو ابن كنعان السادس (تكوين ١٠: ١٧). وكان الحويون في الشمال الأقصى من أرض كنعان عند جبعون وشكيم في أيام يعقوب (تكوين ٣٤: ٢).
جَبَلِ بَعْلِ حَرْمُونَ قيل هو جبل حرمون عينه وإنما قيل له «بعل حرمون» لأنه كان فيه معبد للبعل أو لأن سكانه كانوا يعبدون البعل. وقيل إنه أخد قنن جبل حرمون وكان عليها هيكل للبعل (انظر تفسير ص ٢: ١١). وجبل حرمون هو المعروف اليوم بجبل الشيخ وله في الكتاب اسمان آخران سريون وسنير (تثنية ٣: ٩ انظر التفسير). وهو جزء من لبنان الشرقي وعلى القرب منه ينابيع نهر الأردن.
مَدْخَلِ حَمَاةَ هو أول الوادي المؤدي إلى حماة وكان حدّ أرض كنعان الشمالي.
ورد في (يشوع ١٣: ٢ – ٦) ذكر الجشوريين والعوّيين الذين سكنوا جنوبي أرض الفلسطينيين والجبليين أي سكان جبيل المعروفة اليوم وموقعها بين بيروت وطرابلس على شط البحر. وسكن بعض الكنعانيين فيما بين مدن إسرائيل (ص ١: ٢٧ – ٣٦) وليس لهم ذكر هنا بالتفصيل لأن ليس لهم أهمية وحدهم.
٤ «كَانُوا لامْتِحَانِ إِسْرَائِيلَ بِهِمْ، لِيُعْلَمَ هَلْ يَسْمَعُونَ وَصَايَا ٱلرَّبِّ ٱلَّتِي أَوْصَى بِهَا آبَاءَهُمْ عَنْ يَدِ مُوسَى».
ص ٢: ٢٢
كَانُوا لامْتِحَانِ إِسْرَائِيلَ الخ (انظر تفسير ع ١ وص ٢: ٢٢ و٢٣).
٥ «فَسَكَنَ بَنُو إِسْرَائِيلَ فِي وَسَطِ ٱلْكَنْعَانِيِّينَ وَٱلْحِثِّيِّينَ وَٱلأَمُورِيِّينَ وَٱلْفِرِزِّيِّينَ وَٱلْحِوِّيِّينَ وَٱلْيَبُوسِيِّينَ».
مزمور ١٠٦: ٣٥
فَسَكَنَ بَنُو إِسْرَائِيلَ فِي وَسَطِ ٱلْكَنْعَانِيِّينَ الخ هذا يدل على أن سكان أرض كنعان كانوا من أمم مختلفة اتخذوا لغة واحدة سامية. وكان الحامل لهم على سكنى تلك الأرض ثلاثة أسباب (١) سهولة الاتجار بواسطة الشطوط البحرية. (٢) خصب سهول الأرض وأوديتها. (٣) حصانة جبالها وزيادة الأمن فيها. وكان هؤلاء الأمم يحبون السلم ويرغبون في الثراء فلا يلتفتون إلا إلى ما يعيق زراعتهم وتجارتهم. ومعنى «الكنعانيين» سكان الأغوار «والأموريين» سكان الأنجاد «والفرزيين» سكان السهول «والحويين» سكان القرى «واليبوسيين» الدارسون (من درس الحبوب كالحنطة ونحوها) على ما يرجّح. فالحثيون وحدهم من أولئك الأمم بقوا محافظين على نسبتهم إلى أصلهم وهو حث بن كنعان وثاني أبنائه. هاجروا إلى أرض كنعان من مملكتهم الطورانية ذات الشأن وهي في خارج تخوم فلسطين (انظر تفسير ص ١: ٤ وتكوين ١٠: ١٥ – ١٨ وخروج ٣٣: ٢ و٣٤: ١١ ويشوع ٩: ١ و٢٤: ١١). وسكنى بني إسرائيل بين هؤلاء الأمم عصيان لأمر الله (انظر تفسير ص ١: ٣٢).
٦ «وَاتَّخَذُوا بَنَاتِهِمْ لأَنْفُسِهِمْ نِسَاءً وَأَعْطُوا بَنَاتِهِمْ لِبَنِيهِمْ وَعَبَدُوا آلِهَتَهُمْ».
خروج ٣٤: ١٦ وتثنية ٧: ٣
وَاتَّخَذُوا بَنَاتِهِمْ الخ هذا أكبر علل الضلال وعبادة الأوثان وبه صار نسل إسرائيل خليطاً من الوثنيين وكانت الأجيال غير الجيل الذي كان في عصر يشوع ولهذا نهى الله الإسرائيليين عن الاقتران بنساء الأمم وعن تزويج بناتهم رجال الأمم (انظر خروج ٣٤: ١٦ وتثنية ٧: ٣ و٤).
٧ «فَعَمِلَ بَنُو إِسْرَائِيلَ ٱلشَّرَّ فِي عَيْنَيِ ٱلرَّبِّ، وَنَسَوْا ٱلرَّبَّ إِلٰهَهُمْ وَعَبَدُوا ٱلْبَعْلِيمَ وَٱلسَّوَارِيَ».
ص ٢: ١١ ص ٢: ١ و١٣ خروج ٣٤: ١٣ وتثنية ٧: ٥ و١٢: ٣ و١٦: ٢١ وص ٦: ٢٥ و٢ملوك ١٧: ١٥
ٱلْبَعْلِيمَ جمع بعل في العبرانية وهو الشمس فجمعوه باعتبار تعدُّد صوره وتماثيله أو باعتبار تعدُّد طلوع الشمس (انظر تفسير ص ٢: ١١ و١٣).
وَٱلسَّوَارِيَ وفي العبرانية «الأشروت» وكانت سواري أي أعمدة من خشب عليها صورة الإلاهة التي هي الطبيعة. وترجمها مترجمو السبعينية بالأدغال لأن عبادة الأعمدة المذكورة كانت على الغالب في الأدغال وتبعهم جماعة من المترجمين كمترجمي الإنكليزية القديمة. والسواري هي الترجمة الصحيحة (انظر ٢ملوك ٢٣: ٦ و١٥ وتثنية ١٢: ٣). وكانت سواري البعل من الحجر (خروج ٣٤: ١٣ وتثنية ٧: ٥).
٨ «فَحَمِيَ غَضَبُ ٱلرَّبِّ عَلَى إِسْرَائِيلَ، فَبَاعَهُمْ بِيَدِ كُوشَانَ رِشَعْتَايِمَ مَلِكِ أَرَامِ ٱلنَّهْرَيْنِ. فَعَبَدَ بَنُو إِسْرَائِيلَ كُوشَانَ رِشَعْتَايِمَ ثَمَانِيَ سِنِينَ».
ص ٢: ١٤ حبقوق ٣: ٧ تكوين ٢٤: ١٠ وتثنية ٢٣: ٤ وع ١٠
فَحَمِيَ غَضَبُ…فَبَاعَهُمْ (انظر تفسير ص ٢: ١٤).
كُوشَانَ رِشَعْتَايِمَ فسرّه بعضهم بكوشان ذي الشرّين. وجاء في الترجوم «كوشان الشرير ملك آرام على الفرات». وفي الترجمة السريانية ما يشبه ذلك ولا نعرف عنه إلا المذكور هنا. ونرى هنا يد الرب في تاريخ الأمم فإنه لما عمل بنو إسرائيل الشر في عيني الرب ونسوا الرب إلههم وعبدوا البعليم والسواري أتاهم ذلك الملك الظالم من بلاد بعيدة واستعبدهم وكان آلة بيد الرب لتأديب شعبه غير أن ذلك الملك لم يعرف الرب وظن أنه عمل ما عمله بمجرد إرادته.
مَلِكِ أَرَامِ ٱلنَّهْرَيْنِ أي الأرض التي بين دجلة والفرات أو الأرض المرتفعة بين هذين النهرين.
فَعَبَدَ بَنُو إِسْرَائِيلَ كُوشَانَ الخ أي أطاعوه وخضعوا وذلوا له وخدموه.
٩ «وَصَرَخَ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى ٱلرَّبِّ، فَأَقَامَ ٱلرَّبُّ مُخَلِّصاً لِبَنِي إِسْرَائِيلَ فَخَلَّصَهُمْ. عُثْنِيئِيلَ بْنَ قَنَازَ أَخَا كَالِبَ ٱلأَصْغَرَ».
ع ١٥ وص ٤: ٣ و٦: ٧ و١٠: ١٠ و١صموئيل ١٢: ١٠ ونحميا ٩: ٢٧ ومزمور ٢٢: ٥ و١٠٦: ٤٤ و١٠٧: ١٣ و١٩ ص ٢: ١٦ ص ١: ١٣
وَصَرَخَ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى ٱلرَّبِّ أي استغاثوا به أو طلبوا عونه ونصره لهم بأصوات عالية دلالة على شدة ضيقهم وآلامهم من العبودية القاسية. وهذا من فوائد تأديب الله لشعبه.
فَأَقَامَ ٱلرَّبُّ مُخَلِّصاً لِبَنِي إِسْرَائِيلَ سمع صلاة شعبه المستغيث به المعترف بخطاياه (ص ١٠: ١٠). وهو إله رحيم يسمع دعاء من أتى إليه بقلب سليم وأسف على ما ارتكب من الإثم وآمن بأنه قادر على أن يجيب الدعاء.
فَخَلَّصَهُمْ أي لم يكتف سبحانه بإقامة المخلّص وتركه لقوة نفسه بل كان معه وأعانه على تخليص شعبه.
عُثْنِيئِيلَ بْنَ قَنَازَ بدل من «مخلصاً» وابن قناز صفة لعثنيئيل فمعناه مولود قناز. ومعنى عثنيئيل أسد الله أي بطل الله الشجاع كالأسد.
أَخَا كَالِبَ بيان لعثنيئيل ويحتمل الأصل أنه بيان لقناز فتقرأ العبارة أخي كالب (انظر تفسير ص ١: ١٣). ولننظر هنا إلى مدة حياته فنقول إذا فرضنا أنه كان ابن خمس وعشرين سنة حين أخذ دبير وهي قرية سفر وهذا أقل سن مناسب لأن يكون فيه قائداً وزوجاً لابنة كالب (ص ١: ١١) ولنفرض إنه مرّ عشرون سنة من أخذها إلى استعباد كوشان رشعتايم كما يترجح من القرائن وإذا أضفنا إلى ذلك مدة الاستعباد وهي ثماني سنين على ما في آية التفسير هنا لم يكن سنه حينئذ إلا ٥٣ سنة. وذُكر في ع ١١ إنه مات بعد أن استراحت الأرض أربعين سنة فتكون مدة حياته ٩٣ سنة.
ويظهر لك من (ص ١: ١١) ومن هذه الآية وما بعدها أن عثنيئيل كان من الحكماء والقواد المتدربين والأبطال المجربين وإنه كان ممن يتقون الله في ذلك الجيل الملتوي وإن لله رجالاً في كل عصر لم يجثوا ركبة لبعل.
١٠ «فَكَانَ عَلَيْهِ رُوحُ ٱلرَّبِّ، وَقَضَى لإِسْرَائِيلَ. وَخَرَجَ لِلْحَرْبِ فَدَفَعَ ٱلرَّبُّ لِيَدِهِ كُوشَانَ رِشَعْتَايِمَ مَلِكَ أَرَامَ، وَٱعْتَزَّتْ يَدُهُ عَلَى كُوشَانِ رِشَعْتَايِمَ».
عدد ٢٧: ١٨ وص ٦: ٣٤ و١١: ٢٩ و١٣: ٢٥ و١٤: ٦ و١٩ و١صموئيل ١١: ٦ و٢أيام ١٥: ١ عدد ٢٣: ٧
فَكَانَ عَلَيْهِ رُوحُ ٱلرَّبِّ روح الرب أي الروح القدس مصدر الحياة باختلاف أنواعها الجسدية والعقلية والروحية (انظر تكوين ١: ٢) «وَرُوحُ ٱللّٰهِ يَرِفُّ عَلَى وَجْهِ ٱلْمِيَاهِ» أي روح الله أدخل في الكون المادي النظام والترتيب وحياة النبات والحيوان والإنسان. حلّ روح الرب على شمشون (ص ١٥: ١٤) أي أعطاه قوة غير اعتيادية فضرب الفلسطينيين. وروح الله أعطى بصلئيل (خروج ٣٥: ٣٠ – ٣٥) الحكمة والفهم والمعرفة لعمل خيمة الاجتماع وآنيتها. وأقام الرب أناساً لأجل خدمة خصوصية لشعبه كما احتاجوا وأعطاهم على نوع خاص المواهب المطلوبة لهذه الخدمة. وهكذا عثنيئيل وجدعون (ص ٦: ٣٤) ويفتاح (ص ١١: ٢٩) وغيرهم من القضاة.
وروح الرب مصدر الحياة الروحية أيضاً فبإرشاده نفهم معنى الكتب المقدسة الروحي. وهو يجدد القلب ويرشد المؤمنين إلى كل معرفة روحية ويُميل الإنسان إلى حفظ وصايا الله فيجعلها في داخلهم ويكتبها على قلوبهم (إرميا ٣١: ٣٢) وبإلهامه الخصوصي كتب كتّاب الأسفار المقدسة. والمفهوم هنا أن روح الرب أي الروح القدس أعطى عثنيئيل ما احتاج إليه من الشجاعة والحكمة والقوة ليخلص إسرائيل من ظالمهم.
واليهود أنزلوا عثنيئيل منزلة عالية بين القضاة وقالوا في قول نشيد الأناشيد «كُلُّكِ جَمِيلٌ يَا حَبِيبَتِي لَيْسَ فِيكِ عَيْبَةٌ» (نشيد الأناشيد ٤: ٧) لأنه هو وحده من القضاة خلا من كل لوم على عمل أو خطإ. وعلى كل حال يجب أن ننسب مآثره وصفاته الحسنة إلى روح الرب ليكون الفضل لله لا للإنسان الضعيف (انظر تفسير ص ٢: ١٨).
وَقَضَى لإِسْرَائِيلَ فسّر بعض الربانيين الإسرائيليين «قضى» وهي في العبرانية «يشفط» بانتقم. وقد جاءت بهذا المعنى في قول المرنم «اِقْضِ لِي يَا اَللّٰهُ وَخَاصِمْ مُخَاصَمَتِي» (مزمور ٤٣: ١) فإنها هنا بمعنى انتقم لي.
وَخَرَجَ لِلْحَرْبِ كان يقضي ويحارب مدة قضائه عند الحاجة إلى الحرب.
فَدَفَعَ ٱلرَّبُّ لِيَدِهِ أي إلى يده. وجاء في عدة مواضع مثل هذه العبارة بالباء بدلاً من اللام (انظر ص ١: ٤ و٢: ١٤ و٢٣ وانظر التفسير).
كُوشَانَ رِشَعْتَايِمَ (انظر تفسير ع ١٨).
وَٱعْتَزَّتْ يَدُهُ أي قويت وغلبت.
عَلَى كُوشَانِ رِشَعْتَايِمَ لم يقل عليه اعتماداً على سبق ذكره فوضع المظهر مكان المضمر لزيادة البيان والتأكيد لأن ذلك الملك الشرير كان قوياً جداً حتى وقع الشك في أنه يُغلب.
١١ «وَٱسْتَرَاحَتِ ٱلأَرْضُ أَرْبَعِينَ سَنَةً. وَمَاتَ عُثْنِيئِيلُ بْنُ قَنَازَ».
وَٱسْتَرَاحَتِ ٱلأَرْضُ أَرْبَعِينَ سَنَةً أي استراح سكان أرض كنعان بعضها ولا سيما العبرانيين من أتعاب الحرب تلك المدة. وفسر أحد الربانيين ذلك بقوله «استراحت الأرض أربعين سنة بعد موت يشوع».
وَمَاتَ عُثْنِيئِيلُ بْنُ قَنَازَ المرجّح أنه مات في أثناء السنين الأربعين لا بعدها ولا في نهايتها. والواو لا توجب أنه مات بعدها أو في نهايتها لأنها ليست للترتيب فإذا قلت جاء زيد وعمرو وجاز أن يكون عمرو قد جاء بعد زيد وأن يكون قد جاء قبله وأن يكونا جاءا معاً. وعلى هذا طول عُمر عثنيئيل إلى الحدّ غير المعتاد غير محقق.
ولم يبق ذكر لشيء من سبط يهوذا من هذا الوقت إلى أيام داود.
العبودية للموآبيين وإنقاذ أهود منها ع ١٢ إلى ٣٠
١٢ «وَعَادَ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَعْمَلُونَ ٱلشَّرَّ فِي عَيْنَيِ ٱلرَّبِّ، فَشَدَّدَ ٱلرَّبُّ عَجْلُونَ مَلِكَ مُوآبَ عَلَى إِسْرَائِيلَ، لأَنَّهُمْ عَمِلُوا ٱلشَّرَّ فِي عَيْنَيِ ٱلرَّبِّ».
ص ٢: ١٩ و١صموئيل ١٢: ٩
وَعَادَ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَعْمَلُونَ ٱلشَّرَّ (انظر ص ٢: ١٩) كانت توبة الإسرائيليين إلى حين. وهذا شأن سائر الناس إذا كانوا في الرخاء فإنهم يهتمون بلّذاتهم وينسون الرب ولذلك كان الله يجرب شعبه لأنه يؤدب كل من يحبه ليرده إليه. والشر الذي عملوه هو عبادة الأوثان.
فَشَدَّدَ ٱلرَّبُّ عَجْلُونَ لكي يعرفوا وهن الأصنام التي عبدوها وإنها لا تستطيع نصرهم وتعجز عن وقايتهم من الأعداء. ومعنى عجلون العجل السمين أو شبيه بعجل سمين ولعله لقب له كلقب رشعتايم أي الشرير لكوشان. فهو لقب يدل عل قوّته وحربه بغضب وحشي. وكان عجلون خليفة بالاق (عدد ٢٢: ٤).
كل قوّة من الله حتى قوّة الأشرار أيضاً. وهو يقوّي عقول الناس كما يقوّي أجسادهم فيعطيهم الحكمة في التدبير والشجاعة في العمل. وإذا أراد يشدد شعبه ويعطيهم القوة والحكمة والشجاعة ويعطي الضعف والجبانة لأعدائهم. وإذا أراد تأديب شعبه لسبب خطاياهم يشدد أعداءهم فيكونوا آلة بيد الرب غير أنهم لا يعرفون الرب بل ينسبون نجاحهم لأنفسهم أو لآلهتهم. فالشعب كان أخطأ وعبد الأوثان كغيره من الأمم فهو خاطئ جداً وشر من خاطئ من الأمم لأنهم لم يعرفوا من أمور الرب كما عرف الإسرائيليون فسمح لملك خاطئ أن يغلب هو وقومه الخطأة شعباً خاطئاً.
مَلِكَ مُوآبَ وهو ابن لوط من ابنته البكر.
لأَنَّهُمْ عَمِلُوا ٱلشَّرَّ فِي عَيْنَيِ ٱلرَّبِّ كرر السبب للتأكيد بياناً لكون الله عادلاً فهو لم يظلمهم بل هم ظلموا أنفسهم فاستحقوا العقاب للتأديب والتنبيه ليرجعوا إليه بالتوبة والأسف العظيم. وقوله «في عيني الرب» دلّ على وقاحتهم وفظاعة إثمهم وإن الله يرى أعماله ولا يخفى عليه شيء منها ويعلم ما يسرّون كما يعلم ما يُعلنون أنه فاحص القلوب والكلي وعالم ما في أعماق النفس.
١٣ «فَجَمَعَ إِلَيْهِ بَنِي عَمُّونَ وَعَمَالِيقَ، وَسَارَ وَضَرَبَ إِسْرَائِيلَ وَٱمْتَلَكُوا مَدِينَةَ ٱلنَّخْلِ».
ص ٥: ١٤ ص ١: ١٦
فَجَمَعَ إِلَيْهِ بَنِي عَمُّونَ أي بني أخي موآب وهو ابن لوط من ابنته الصغرى. وكان بنو موآب وبنو عمون متجاورين. فكانت أرض موآب شرقي القسم الجنوبي من بحر لوط وكانت أرض سبط رأوبين شرقي القسم الشمالي منه وكان النهر أرنون الفاصل بينهما. فكانت أرض رأوبين إلى جهة الشمال من النهر وأرض موآب إلى جهة الجنوب منه غير أن الموآبيين تعدوا على الرأوبينيين وأخذوا من أرضهم. وكان العمونيون إلى جهة الشرق من موآب ورأوبين فكان من الضرورة أن يتحالفوا ليقووا على الأعداء (انظر ص ١١: ١٣ – ١٦ و٢٥ و٢٧ والتفسير). ومن ذلك أنهم تحالفوا وكانوا يداً واحدة على يهوشافاط (٢أيام ٢٠: ١).
وَعَمَالِيقَ أي العمالقة وهم قبائل بدوية متوحشة ولا يُعرف أصلهم فهم ليس أولاد عماليق بن أليفاز لأنهم كانوا قبله (تكوين ١٤: ٧) وكانوا من أول أمرهم أعداء لبني إسرائيل وكانت منازلهم بين أرض كنعان ومصر في برية سيناء وتيه بني إسرائيل (تكوين ١٤: ٧ وخروج ١٧: ٨ وعدد ١٣: ٢٩ و١٤: ٢٥).
ضَرَبَ إِسْرَائِيلَ حاربهم بضرب السيف وقتل كثيرين من المحاربين.
وَٱمْتَلَكُوا أي امتلك أو استولى جنود القبائل الثلاث من المحاربين.
مَدِينَةَ ٱلنَّخْلِ هي أريحا (ص ١: ١٦) وقول يشوع «مَلْعُونٌ قُدَّامَ ٱلرَّبِّ ٱلرَّجُلُ ٱلَّذِي يَقُومُ وَيَبْنِي هٰذِهِ ٱلْمَدِينَةَ أَرِيحَا الخ» (يشوع ٦: ٢٦) يستلزم النهي عن بنائها فهو ليس بنبوءة بأنها لا تُبنى. ولعل النهي كان عن تحصين المدينة فتجدد بناؤها بعد خرابها في زمان يشوع ولكنها لم تتحصن. وأتت لعنة يشوع على حيئيل الذي حاول تحصينها في زمان آخاب (١ملوك ١٦: ٣٤). ولعل معنى «مدينة النخل» هنا المكان الذي كانت فيه أريحا وما يجاوره فإن الطلل يسمى باسم المدينة أو القرية التي هو أثرها.
١٤ «فَعَبَدَ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَجْلُونَ مَلِكَ مُوآبَ ثَمَانِيَ عَشَرَةَ سَنَةً».
تثنية ٢٨: ٤٨
عَبَدَ أي صاروا عبيداً. والظاهر أن ما استولى عليه الموأبيون لم يتجاوز حدود أفرايم.
١٥ «وَصَرَخَ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى ٱلرَّبِّ، فَأَقَامَ لَهُمُ ٱلرَّبُّ مُخَلِّصاً إِهُودَ بْنَ جِيرَا ٱلْبِنْيَامِينِيَّ، رَجُلاً أَعْسَرَ. فَأَرْسَلَ بَنُو إِسْرَائِيلَ بِيَدِهِ هَدِيَّةً لِعَجْلُونَ مَلِكِ مُوآبَ».
ع ٩ ومزمور ٧٨: ٣٤ ص ٢٠: ١٦
وَصَرَخَ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى ٱلرَّبِّ (انظر تفسير ع ٩).
فَأَقَامَ لَهُمُ ٱلرَّبُّ مُخَلِّصاً إن اليد التي أقامت عجلون على إسرائيل هي التي أقامت ذلك المخلص لهم لكن تركت اتخاذ الوسائل لاختياره وقوّى الرب هذا المخلص كما شدّد عجلون.
إِهُودَ بْنَ جِيرَا جاء في سفر التكوين ما يفيد أن جيرا ابن بنيامين (تكوين ٤٦: ٢١) وفي سفر الأيام الأول ما يفيد أنه ابن يالع بن بنيامين (انظر ٢صموئيل ١٩: ١٨ و١أيام ٨: ١ – ٧). وكثيراً ما نُسب الإنسان في الكتاب المقدس إلى جده القريب وجده البعيد وهو مجاز شائع في كل اللغاب الساميّة. وفي العربية كما في العبرانية يُنسب الإنسان إلى آدم فيقال اليوم لكل إنسان ابن آدم فنسب جيرا في موضع إلى أبيه وفي آخر إلى جده. ويسمى أهود أبيهود أيضاً (١أيام ٨: ١ – ٨).
رَجُلاً أَعْسَرَ أي يعمل بشماله. وهذه العبارة تحتمل ثلاثة معانٍ الأول إن أهود كانت يده اليمنى فدعاء أو مقطوعة أو مصابة بما يمنعه من استعمالها فاستعمل اليد اليسرى. والثاني أنه كان أعسَر يَسَر أو أضبط أي يعمل بكلتا يديه. والثالث أنه عوّد يسراه العمل وأهمل يمناه فصارت اليسرى بمنزلة اليمنى التي اعتاد جمهور الناس أعمالها أكثر من اليسرى. ولهذا جاء في السبعينية وفي الفلغاتا «رجلاً أضبط». وقال يوسيفوس إن أهود كان ماهراً في استعمال اليسرى وكان فيها كل قوته. وفي الأصل العبراني «رجلاً مغلق اليد ليمنى» وهذا لا يدل على أنه أضبط والمرجّح أنه كان قد عوّد اليسرى العمل أكثر من اليمنى. ومن غريب الاتفاق إن سبط بنيامين ومعنى بنيامين ابن اليمين كان كثيرون من رجالهم عُسراً (انظر ص ٢٠: ١٦).
ولكن بعضهم ظنّ أن يد أهود اليمنى كانت مصابة وإن الله أقامه ليُري الناس أن القدرة له لا للواسطة. وظن ذلك بناء على احتمال العبارة العبرانية ذلك وعلى ما جاء في الترجمتين الكلدانية والسريانية. ففي الأولى «مصاب» أو «ممنوع اليمنى» وفي الثانية «يده اليمنى جامدة» أو خدرة أو ثقيلة أو ضعيفة.
هَدِيَّةً وفي الأصل العبراني «منحة» أي عطية أو جزية أو هدية كما في ترجمتنا. وجاءت في سفر اللاويين بمعنى تقدمة (لاويين ٢: ١) والظاهر أنهم أرادوا بهذه الهدية أحد أمرين الأول أنهم على الطاعة والخضوع. والثاني أنهم مقيمون على الصداقة والوداد ويريدون استعطافه (تكوين ٣٢: ١٨ و٢صموئيل ٨: ٢ و٦). وبعض المفسرين رجّح أن تلك المنحة الجزية التي ضربها عليهم عجلون وقد جاءت بمعنى الجزية في غير هذا الموضع (١صموئيل ٨: ٦ و١ملوك ٤: ٢١ ومزمور ٧٢: ١٠). وأرسلوا هذه الهدية «بيده» إما لأنه كان أحد رؤساء بيوت إسرائيل (١أيام ٨: ٣ و٦) وإما لأنه هو الذي أشار عليهم بتلك الهدية.
١٦ «فَعَمِلَ إِهُودُ لِنَفْسِهِ سَيْفاً ذَا حَدَّيْنِ طُولُهُ ذِرَاعٌ، وَتَقَلَّدَهُ تَحْتَ ثِيَابِهِ عَلَى فَخْذِهِ ٱلْيُمْنَى».
سَيْفاً ذَا حَدَّيْنِ… وَتَقَلَّدَهُ تَحْتَ ثِيَابِهِ هذا السيف يُسمى بالعربية المشملة والمِشمل وهو سيف صغير نصله مستقيم له حدّان كأنه أُلف من نصلين أُلصق أحدهما بالآخر وقد يكون في وسطه ناتئ من الوجهين وقد يكون مستوي الوجهين ويُعرف عند عامة السوريين اليوم بالشاكرية. والظاهر أن الموآبيين أخذوا أسلحة الإسرائيلين ومنعوهم من حمل السلاح ومشتراه حتى اضطر أهود أن يصنع مشملاً أو سيفاً صغيراً يستره بثيابه. على أن السيوف الأشورية الكبيرة أي غير المشامل كانت كذلك كما ظهر من الآثار.
طُولُهُ ذِرَاعٌ عبرانية وهي نحو شبرين أي طول ما بين المرفق (المعروف عند العامة بالكوع) إلى طرف الإصبع الوسطى.
عَلَى فَخْذِهِ ٱلْيُمْنَى العادة أن يعلّق السيف على الجانب الأيسر ولكن علّقه أهود على الأيمن لأنه كان أعسر (ع ١٥).
١٧ «وَقَدَمَّ ٱلْهَدِيَّةَ لِعَجْلُونَ مَلِكِ مُوآبَ. (وَكَانَ عَجْلُونُ رَجُلاً سَمِيناً جِدّاً)».
وَقَدَمَّ ٱلْهَدِيَّةَ شبّه يوسيفوس في ترجمته هذه القصة ما أٰتاه أهود مع عجلون بما أتاه هرميديوس مع رستوجيتون من المهارة والذكاء في المداخلة وجذب المودّة لنفسه ودعا أهود شاباً آلف عجلون وكسب مودته وإكرامه بتكرار الهدايا له.
وَكَانَ عَجْلُونُ رَجُلاً سَمِيناً كاسمه فإن معنى عجلون عجل سمين.
١٨ «وَكَانَ لَمَّا ٱنْتَهَى مِنْ تَقْدِيمِ ٱلْهَدِيَّةِ صَرَفَ ٱلْقَوْمَ حَامِلِي ٱلْهَدِيَّةِ».
صَرَفَ ٱلْقَوْمَ حَامِلِي ٱلْهَدِيَّةِ (أو الجزية) هذا يدل على أن الهدية كانت كبيرة وافرة حتى حملها كثيرون وإنما كثّرها أهود لكي يسرّ بها عجلون ويستعطفه كثيراً. قال يوسيفوس أنه كان مع أهود خادمان وهو مخالف للنص فإن «القوم» لجماعة من الرجال وتدخله النساء على تبعية. وسُموا بذلك لقيامهم بعظائم الأمور.
١٩ «وَأَمَّا هُوَ فَرَجَعَ مِنْ عِنْدِ ٱلْمَنْحُوتَاتِ ٱلَّتِي لَدَى ٱلْجِلْجَالِ وَقَالَ: لِي كَلاَمُ سِرٍّ إِلَيْكَ أَيُّهَا ٱلْمَلِكُ. فَقَالَ: ٱسْكُتْ. وَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ جَمِيعُ ٱلْوَاقِفِينَ لَدَيْهِ».
يشوع ٤: ٢٠
أَمَّا هُوَ فَرَجَعَ وذلك لثلاث غايات:
- صون غايته والأمن على نيلها في وقت مناسب لأنه كان صعباً عليه أن يدركها على مرأى من جنود الملك وحَرَسه الذين كانوا حاضرين لحراسة الملك عند تقديم الهدية.
- اتقاء وقوع الخطر على قومه حملة الهدية.
- إعداد السبيل للهرب إذا اقتضت الحال لأنه لم يخلُ من الريبة من الملك وظنه أن الملك لم تخلُ نفسه من الريبة منه.
ٱلْمَنْحُوتَاتِ وفي الأصل العبراني «هفيسيليم» (والهاء حرف التعريف) جاءت في الترجوم «مقالع الحجارة» أو مقاطع الحجارة وفي حاشية ترجمتنا في النسخة ذات الشواهد «أو مقالع الحجارة» وفي السبعينية «المنحوتات» وفي السريانية كذلك وفي الفلغاتا «الأصنام» وتُرجمت في سفر التثنية «بالتماثيل» (تثنية ٧: ٥ وكذا في ٢ملوك ١٧: ٤١). وترجم فيسيل مفرد فيسيليم في (مزمور ٩٧: ٧) بتمثال. والذين ترجموها «بمقالع الحجارة» اتبعوا الترجمة الكلدانية وقول أحد رباني اليهود والمرجّح أنها الأصنام أو المنحوتات منها.
ٱلَّتِي لَدَى ٱلْجِلْجَالِ أي التي عند الجلجال وهي قرية قرب أريحا على غاية ما يقرب من أربعة أميال من الأردن وفي موقعها اليوم قرية اسمها جلجلية كانت مقراً لخيمة الشهادة معبد الرب الذي فيه تابوت العهد فجعلها الوثنيون معبداً للأصنام فكان شأن الأمم الغالبة أن يحولوا معابد الأمم المغلوبة معابد لهم وبقي هذا شأنهم إلى الأزمنة الحديثة.
وَقَالَ: لِي كَلاَمُ سِرٍّ إِلَيْكَ أَيُّهَا ٱلْمَلِكُ قال له هذا على أثر رجوعه من عند المنحوتات وقد صرف قومه فكان هذا القول تمهيداً لمقصده ووسيلة إلى معرفة ثقة عجلون به واطمئنانه بالانفراد معه. ولا يخفى ما للسير من القيمة عند الملوك. ولعل عجلون لما رأى ما أتاه أهود من الاحترام له وتقديم الهدايا الكثيرة ظنه يريد أن يُعلن له أسرار اليهود وأنه يخون شعبه لغاية في نفسه يساعده الملك على إدراكها فيزيد بأسه وسلطته على قومه. وقد جرى مثل ذلك كثيراً بين الأقوام كما يعرف مطالعو التاريخ. ورآى يوسيفوس إن ذلك السر حُلم ادعى أهود أنه يريد أن يقصه على عجلون.
فَقَالَ: ٱسْكُتْ وفي العبرانية «هَس» أي أسكت ومنها قول العامة هُس بمعنى اسكت وهذا معنى صه في العربية. خاف عجلون أن يعرف الناس ما بينهما ولو لفظة سرّ.
وَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ الخ أي من حضرته أي مكان حضوره فلا يلزم الكلام أنه كان في بيت.
٢٠ «فَدَخَلَ إِلَيْهِ إِهُودُ وَهُوَ جَالِسٌ فِي غُرْفَةٍ صَيْفِيَّةٍ كَانَتْ لَهُ وَحْدَهُ. وَقَالَ إِهُودُ: عِنْدِي كَلاَمُ ٱللّٰهِ إِلَيْكَ. فَقَامَ عَنِ ٱلْكُرْسِيِّ».
عاموس ٣: ١٥
فَدَخَلَ إِلَيْهِ إِهُودُ وَهُوَ جَالِسٌ فِي غُرْفَةٍ صَيْفِيَّةٍ أي بعد أن أخرج الواقفين لديه ذهب إلى عليته وجلس فدخل أهود الخ ففي الكلام إيجاز الحذف. ويظن البعض أن الملك كان جالساً في علّيته من الأول ولما رجع أهود من عند المنحوتات التي لدى الجلجال أرسل إلى الملك وقال بواسطة المرسَل «لي كلام سر الخ» فخرج من عند الملك جميع الواقفين ودخل إليه أهود وتلك العلّية كان يجلس فيها ليتبرد من الحرّ وهي في الأصل العبراني «علّية التبريد». وترجمها لوثر «بمظلة صيفية». والعلّية متعرضة للهواء وكثيراً ما تكون للانفراد والمسارّة لأنها تكون فوق مساكن الدار. وكانت علّية التبريد لسمع الأسرار أيضاً بديل قوله «كانت له وحده».
وَقَالَ إِهُودُ: عِنْدِي كَلاَمُ ٱللّٰهِ إِلَيْكَ الخ الله هنا في الأصل العبراني «إلوهيم» ومعناه آلهة والله فهو اسم مشترك كإله في العربية. فعجلون ظنه إلهه كموش أو آلهته لأن الوثنيين آمنوا بعدة آلهة. ورأى بعض المفسرين أن أهود أراد إله إسرائيل وأن عجلون فهم مراده. ولكن من البعيد أن يقوم عجلون احتراماً لإله غلب شعبه واعتقد ضعفه لأنه لم يحمِ عبّاده الإسرائيليين. وقال آخر إن الإيمان بإله يعتني بالمخلوقات كان إيمان كل الأمم فعجلون قام إكراماً لذلك الإله بقطع النظر عن كونه إله بني إسرائيل أو كونه إله غيره. ورأى يوسيفوس أنه قال له إنه رأى حلماً أمره الله أن يقصه عليه. وترجم بعضهم «كلام الله» برسالة الله بناء على أن تلك الرسالة سيفه الذي أدخله في بطنه ولكن الذي في الأصل العبراني «كلام» لا رسالة. ورأى بعض علماء اليهود أن أهود أراد تعليم عجلون وصايا الرب ولو قبل كلام الله وردّ الحرية إلى الإسرائيليين لزالت العداوة. وعلى هذا يكون قيامه عن كرسيه كرهاً لسمع كلام أهود. وقال بعض المفسرين المسيحيين الظاهر أن أهود كان من المشهورين بالصلاح ولعل كثيرين اعتقدوا نبوءته وأن عجلون حسب أنه أوحى إليه بما يقصه عليه فأكرم أهود وقام احتراماً لله الذي اعتقد إنه رب البرايا. وهذا كلام مقبول قلنا وكان قيامه فرصة لأهود أن يضربه بسيفه. قال يوسيفوس إنه قام عن كرسيه وطفر فرحاً بأن يسمع الحلم السماوي.
٢١ «فَمَدَّ إِهُودُ يَدَهُ ٱلْيُسْرَى وَأَخَذَ ٱلسَّيْفَ عَنْ فَخْذِهِ ٱلْيُمْنَى وَضَرَبَهُ فِي بَطْنِهِ».
فَمَدَّ إِهُودُ يَدَهُ ٱلْيُسْرَى لأنه كان أعسر (ع ١٥).
وَأَخَذَ ٱلسَّيْفَ عَنْ فَخْذِهِ ٱلْيُمْنَى (انظر ع ١٦ والتفسير).
ولا ريب في أن أهود كذب إن كان قد قال ما قاله لعجلون مما اخترعه ليتمكن من قتله ولم يكن من تدريب الرب له فهو قد أخطأ وإن اختاره الرب لإنقاذ إسرئيل لأنه لم يرفع عن التكليف واختار الشخص ولم يختر كل أعماله كما اختار شاول وداود وغيرهما من ملوك إسرائيل وكان منهم ما كان من المحظورات.
٢٢ «فَدَخَلَ ٱلْمِقْبَضُ أَيْضاً وَرَاءَ ٱلنَّصْلِ، وَطَبَقَ ٱلشَّحْمُ وَرَاءَ ٱلنَّصْلِ لأَنَّهُ لَمْ يَجْذِبِ ٱلسَّيْفَ مِنْ بَطْنِهِ. وَخَرَجَ مِنَ ٱلْحِتَارِ».
فَدَخَلَ ٱلْمِقْبَضُ أي مقبض السيف.
وَرَاءَ ٱلنَّصْلِ أي شفرة السيف (والشفرة ما عرض من الحديد وحُدد) وهي حديدة دون المقبض.
ٱلْحِتَارِ ما بين الدّبر القبُل (انظر حاشية هذه الآية في الكتاب ذي الشواهد).
٢٣ «فَخَرَجَ إِهُودُ مِنَ ٱلرِّوَاقِ وَأَغْلَقَ أَبْوَابَ ٱلْعُلِّيَّةِ وَرَاءَهُ وَأَقْفَلَهَا».
ٱلرِّوَاقِ الرواق مقدّم البيت وهو هنا مقدّم العلّية ورأى بعضهم على ما في الكلدانية أنه المدخل المزّين بالأعمدة.
أَبْوَابَ ٱلْعُلِّيَّةِ كانت هذه العليّة متعددة الأبواب لدخول الهواء من كل جهة لأنها كانت علّية التبريد (ع ٢٠).
٢٤ «وَلَمَّا خَرَجَ، جَاءَ عَبِيدُهُ وَنَظَرُوا وَإِذَا أَبْوَابُ ٱلْعُلِّيَّةِ مُقْفَلَةٌ، فَقَالُوا: إِنَّهُ مُغَطٍّ رِجْلَيْهِ فِي ٱلْغُرْفَةِ ٱلصَّيْفِيَّةِ».
١صموئيل ٢٤: ٣
مُغَطٍّ رِجْلَيْهِ كناية عن كونه يتغوّط (١صموئيل ٢٤: ٣).
فِي ٱلْغُرْفَةِ ٱلصَّيْفِيَّةِ أي الكنيف في عليّة التبريد أو كنيف التبريد.
٢٥ «فَلَبِثُوا حَتَّى خَجِلُوا وَإِذَا هُوَ لاَ يَفْتَحُ أَبْوَابَ ٱلْعُلِّيَّةِ. فَأَخَذُوا ٱلْمِفْتَاحَ وَفَتَحُوا وَإِذَا سَيِّدُهُمْ سَاقِطٌ عَلَى ٱلأَرْضِ مَيِّتاً».
فَلَبِثُوا أي انتظروا.
خَجِلُوا من خيبتهم وعدم اكتراث الملك بهم لاشتغاله بما لا يحسن بيانه.
فَأَخَذُوا ٱلْمِفْتَاحَ وَفَتَحُوا تجاسروا على ذلك لأنهم صار لهم أن يعتذروا لو كان حياً بأنهم أتوا ذلك خوفاً عليه من مرض أو عارض أصابه. وهذا يدل على أن أهود ترك المفاتيح عند الأبواب بعد أن أوصدها لغفلته عنها بغية الإسراع في الهرب أو لعلمه أن أتباعه لا يتجاسرون أن يفتحوا بدون إذنه وإلا فلا يتصور أن الملك يعطيهم مفاتيح علّيته الخاصة.
وَإِذَا سَيِّدُهُمْ سَاقِطٌ… مَيِّتاً (قابل هذا بما في ص ٤: ٢٢).
٢٦ «وَأَمَّا إِهُودُ فَنَجَا إِذْ هُمْ مَبْهُوتُونَ، وَعَبَرَ ٱلْمَنْحُوتَاتِ وَنَجَا إِلَى سَعِيرَةَ».
ع ١٩
ٱلْمَنْحُوتَاتِ (انظر تفسير ع ١٩).
سَعِيرَةَ وفي العبراني «السعيرة» ولعلها الأجمة ليتوارى بالأشجار عن الأعداء. وفي حاشية الكتاب ذي الشواهد «الحَرَجة» وهي مجتمع الشجر وكانت بين جبال أفرايم فانتهى منها إلى أرض أفرايم وراء الجلجال فأمن إدراكهم إياه.
٢٧ «وَكَانَ عِنْدَ مَجِيئِهِ أَنَّهُ ضَرَبَ بِٱلْبُوقِ فِي جَبَلِ أَفْرَايِمَ، فَنَزَلَ مَعَهُ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَنِ ٱلْجَبَلِ وَهُوَ قُدَّامَهُم».
ص ٥: ١٤ و٦: ٣٤ و١صموئيل ١٣: ٣ يشوع ١٧: ١٥ وص ٧: ٢٤ و١٧: ١ و١٩: ١
ضَرَبَ بِٱلْبُوقِ أي ضرب البوق بنفخه أي نفخ فيه شديداً. وكان البوق قرناً أو كهيئة القرن من المعدنيات.
جَبَلِ أَفْرَايِمَ أي أرض أفرايم الجبلية لا جبل بعينه كقولك جبل لبنان وهو عدة جبال وأودية وسهول. وكانت أرض أفرايم حصن الحرية الإسرائيلية وأمن الإسرائيليين وقوّتهم (ص ٤: ٥ و١٠: ١ و١صموئيل ١: ١ وقابل ١٣: ٦ بِ ١٤: ٢٢ وقابل هذا بما في ص ٦: ٢).
وَهُوَ قُدَّامَهُمْ لأنه القائد وهذا شأن القوّاد الأبطال.
٢٨ «وَقَالَ لَهُمُ: ٱتْبَعُونِي لأَنَّ ٱلرَّبَّ قَدْ دَفَعَ أَعْدَاءَكُمُ ٱلْمُوآبِيِّينَ لِيَدِكُمْ. فَنَزَلُوا وَرَاءَهُ وَأَخَذُوا مَخَاوِضَ ٱلأُرْدُنِّ إِلَى مُوآبَ، وَلَمْ يَدَعُوا أَحَداً يَعْبُرُ».
ص ٧: ٩ و١٥ و١صموئيل ١٧: ٤٧ يشوع ٢: ٧ وص ١٢: ٥
ٱتْبَعُونِي متوقعين النصر.
لأَنَّ ٱلرَّبَّ قَدْ دَفَعَ أَعْدَاءَكُمُ ٱلْمُوآبِيِّينَ لِيَدِكُمْ أي إنه ملككم إياهم. وعبّر عن المستقبل بصورة الماضي للتأكيد فكان النصر بمنزلة الواقع. وخلاصة العبارتين اتبعوني واثقين بالفوز لأن الله لا بد أن ينصركم على أعدائكم فكونوا على يقين أنكم تنتصرون (قابل هذا بما في ص ٧: ٩ – ١٥).
فَنَزَلُوا وَرَاءَهُ وَأَخَذُوا مَخَاوِضَ ٱلأُرْدُنِّ اي وثقوا بقوله وشجعوا وتبعوه واثقين واستولوا على مخاوض الأردن هي أجزاء منه رقيقة الماء يقطعها الناس مشاة وركباناً بلا جسر وكانت متعددة متوالية ظن بعضهم أنها كانت قليلة بين ثمانٍ وعشر وقد تبيّن أنها تبلغ الخمسين. وباستيلائهم على تلك المخاوض لم يتركوا مهرباً للأعداء ولا طريقاً إلى المدد من خارج. فصار لهم ما كانوا يظنونه رحباً وفردوساً من أرضهم ضيقاً وسجناً موصد الأبواب.
وذُكرت تلك المخاوض في (يشوع ٢: ٧) ولم تزل إحداها إلى هذا اليوم قرب أريحا وهي على غاية نحو ثلاثة أميال من بحر لوط.
إِلَى مُوآبَ أي أرض موآب. وهذا الجارّ متعلق بنعت محذوفة لمخاوض الأردن تقديره المؤدية أو ما هو بمعناها. والغاية أن أهود استولى على تلك المخاوض التي هي واسطة الاتصال بين أريحا والعبر الآخر من الأردن ليمنع الموآبيين من الهرب من أريحا إلى ذلك العبر الذي هو بدء الطريق إلى أرضهم.
وَلَمْ يَدَعُوا أَحَداً يَعْبُرُ فتمكنوا من قتل الأبطال كلهم كأنهم قد جُمعوا في قفص (انظر ع ٢٩).
٢٩ «فَضَرَبُوا مِنْ مُوآبَ فِي ذٰلِكَ ٱلْوَقْتِ نَحْوَ عَشَرَةِ آلاَفِ رَجُلٍ، كُلَّ نَشِيطٍ وَكُلَّ ذِي بَأْسٍ، وَلَمْ يَنْجُ أَحَدٌ».
فَضَرَبُوا أي قتلوا.
فِي ذٰلِكَ ٱلْوَقْتِ أي وقت مفاجئتهم إياهم.
نَشِيطٍ النشيط في العربية الذي طابت نفسه للعمل والسريع الخفيف. وفي الترجمة الانكليزية القوّي البنية. وفي العبرانية السمين (ع ١٧). والأرجح أنه هنا لجسم القوي أو الضليع. وقال بعضهم المختار (مزمور ٧٨: ٣١) والظاهر على هذا أن السمين هنا في العبرانية كناية عن المختار لأن الناس يختارون السمين من الغنم والبقر وغيرهما من البهائم التي تؤكل لحومها.
بَأْسٍ شجاعة وشدّة.
لَمْ يَنْجُ أَحَدٌ من الشجعان الأقوياء. والمعنى أن الموآبيين الحالّين في أريحا وجوارها كانوا كلهم ذوي بأس فإنهم كانوا على هيئة عساكر وليس على هيئة فلّاحين أو رعاة أو غيرهم من السكان المستوطنين.
٣٠ «فَذَلَّ ٱلْمُوآبِيُّونَ فِي ذٰلِكَ ٱلْيَوْمِ تَحْتَ يَدِ إِسْرَائِيلَ. وَٱسْتَرَاحَتِ ٱلأَرْضُ ثَمَانِينَ سَنَةً».
ع ١١
فَذَلَّ ٱلْمُوآبِيُّونَ أي صاروا إلى الهوان والضعة بعد أن كانوا أعزّاء متكبرين.
وَٱسْتَرَاحَتِ ٱلأَرْضُ ثَمَانِينَ سَنَةً أي استراح أهلها من الحرب. والمرجّح أن هذه الأرض أرض الأسباط الجنوبية واستراحتها كل هذه المدة تدلّ على أن قوة الموآبيين قد تلاشت في تلك الواقعة كل الملاشاة.
إنقاذ شمجر الإسرائيليين ع ٣١
٣١ «وَكَانَ بَعْدَهُ شَمْجَرُ بْنُ عَنَاةَ، فَضَرَبَ مِنَ ٱلْفِلِسْطِينِيِّينَ سِتَّ مِئَةِ رَجُلٍ بِمِنْساس ٱلْبَقَرِ. وَهُوَ أَيْضاً خَلَّصَ إِسْرَائِيلَ».
ص ٥: ٦ و٨ و١صموئيل ١٣: ١٩ و٢٢ و١صموئيل ١٧: ٤٧ و٥٠ ص ٢: ١٦ ص ٤: ١ و٣ الخ و١٠: ٧ و١٧ و١١: ٤ الخ و١صموئيل ٤: ١
وَكَانَ بَعْدَهُ أي بعد أهود. وهذا لا يستلزم أن أهود كان قد مات.
شَمْجَرُ بْنُ عَنَاةَ جاء في قاموس الكتاب أنه قاضٍ من قضاة إسرائيل. وقال الأستاذ لياس أنه لم يُذكر في موضع أنه قضى لإسرائيل وإنه قام بأمور الحرب وأهود في الحياة وإن محاربته كانت موضعية وكان غيره من المحاربين في موضع آخر وكلهم حاربوا لإنقاذ إسرائيل (انظر ص ٥: ٦). وليس في الكتاب ما يدلنا على السبط الذي منه شمجر ولا على مدة عمله. وكونه ابن عناة لا يفيدنا شيئاً من ذلك فإن هذا الاسم لم يُذكر إلا هنا. نعم ذُكر في (ص ١: ٣٣ ويشوع ١٩: ٣٨) «بيت عناة» (انظر ص ١: ٣٣) وهي بلدة في أرض نفتالي ولكن شمجر يصعب الظن أنه كان من أحد الأسباط في الشمال. وليس بين الأسماء اليهودية يومئذ شمجر أو عناة فظُنّ أنه كنعاني هاد ويؤيد ذلك أن معنى اسمه «اسم غريب» وهو مركّب من «شم» أي اسم و «جر» أي «غريب». وفسره صاحب قاموس الكتاب بحامل كاس. وقال بعضهم لا ريب في أن شمجر كان من سبط يهوذا أو سبط دان وفعله كفعل شمشون في أنه موضعيّ لا عامّ.
فَضَرَبَ أي قتل.
ٱلْفِلِسْطِينِيِّينَ (انظر تفسير ع ٣).
سِتَّ مِئَةِ رَجُلٍ بِمِنْساس ٱلْبَقَرِ المراد بالمنساس هنا عصا في طرفها حديدة حادة يُساق بها وكثيرون من العامة يسمّونها بالمسّاس اسم مبالغة من المس. وأثبت المترجم المنساس بناء على أنه اسم آلة من النسّ وهو السوق والزجر على ما في قاموس الفيروزبادي. وجاء في القاموس المهمزة عصا في رأسها حديدة ينخس بها الحمار وهذه هي المترجمة بالمنساس والتي يسميها العامة المسّاس سيق بها الحمار أو سيقت بها البقرة وكثيرون من الحراثين يحملونها لسوق البقر التي يحرثون عليها ولتمهيد مسلك السكة إذا أُعيقت. وهي تقوم في الحرب مقام الرمح ولذلك اتخذها شمجر أداته في القتال والظاهر أن أعداء الإسرائيليين لم يسمحوا لهم باقتناء أسلحة كرماح وسيوف. وقتله ست مئة رجل لم ينص أنه كان في واقعة واحدة فلا غرابة فيه فبعض الفلاحين الأسوجيين قتل في ليلة واحدة ثلاث مئة رجل في حرب موويجاه على أنه يصح أن يُنسب إليه قتل من قتله جنوده الذين يقودهم وإن لم تكن أدواتهم الحربية مناسيس على سبيل المجاز. ومنه قول المغنيات «ضَرَبَ شَاوُلُ أُلُوفَهُ وَدَاوُدُ رَبَوَاتِهِ» (١صموئيل ١٨: ٧).
وَهُوَ أَيْضاً خَلَّصَ إِسْرَائِيلَ ولكن لم يكن ما أتاه كافياً لتعميم الأمن لأن الطرُق قُطعت في أيامه كما تبين من أغنية دبورة (ص ٥: ٦).
فوائد
- إن الله يعلّم الجهلاء غير المعذورين بالمحنة والبلاء فيجب معرفة الواجبات والسعي في إدراكها (ع ١ و٢).
- إنه يجب أن نعلم ما فعله الرب لشعبه من حسن العناية فيزيدنا ذلك إيماناً وثقة وإلا فإن جهلنا صرنا إلى الذلّ والهوان والآلام والأحزان (ع ١).
- إن امتحان الرب للناس يُقصد به نفعهم وسعادتهم (ع ٤).
- إن مخالطة الأشرار تقود إلى الشرور والوقوع تحت غضب الله (ع ٥ – ٨).
- إن الرب يستجيب صلاة المتذللين له المعترفين بافتقارهم إلى مساعدته وإن لم يكونوا مستحقين الإجابة (ع ٩ – ١١).
- إن الإنسان لفساد طبعه لا يذكر الله إلا عند الشدة فإذا صار إلى الرخاء نسي الله وعاد إلى آثامه. فيجب أن نلتفت إليه تعالى في السرّاء والضرّاء (ع ١٢).
- إن الله إذا كفّ الضربة عن الأثيم عند توبته إليه يعيد الضربة له عند تركه إياه وقد تكون الضربة الثانية أشد من الأولى (ع ١٢ – ١٤ قابل آخر الآية ٨ بآخر ١٤).
- إن الرب لوفرة رحمته يرحم الاثيم إذا التجأ إليه لو تكررت معاصيه (ع ١٥ قابل ع ٥ – ٧ ب ع ١٢) فباب التوبة والقبول مفتوح أبداً ولكن ليس كل وقت وقت توبة فاليوم هو الزمان المناسب.
- إن الله قادر أن يخلص الضعفاء من الأقوياء بواسطة ضعيف لأن قوته في الضعف تكمل (ع ١٥ و١٧).
- إن الله إذا أقام منقذاً لشعبه وخلّصه ذلك المنقذ بوسائل تخالف الشريعة لم تكن تلك الوسائل مما يرضاها سبحانه وتعالى (ع ١٨ – ٢٤).
- إن النصر لا يقوم بحسن السلاح بل بقوة الله (ع ٣١ قابل هذا بما في ص ١٥: ١٥ و١٦ و١صموئيل ١٧: ٤٤ – ٥٠).
-
أيام الراحة في حياة الإنسان أكثر من أيام التعب والبركات أكثر عدداً من المصائب. فنذكر الشدائد والحروب لأنها غير اعتيادية ولكن يجب أن نذكر أيضاً أيام الراحة والبركات الاعتيادية ونرنم الترنيمات ١١ و٣٠ و٤٢١ «بركات الرب عدد شاكراً».
السابق |
التالي |