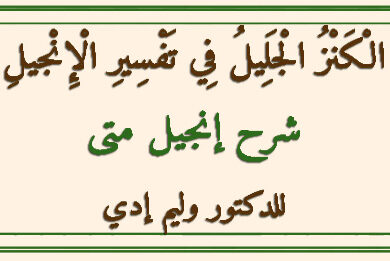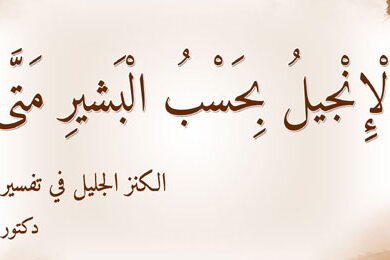إنجيل متى | 21 | الكنز الجليل
الكنز الجليل في تفسير الإنجيل
شرح إنجيل متى
الأصحاح الحادي والعشرون
اقتصر متّى على ذكر بعض الحوادث في أريحا، فلم يذكر زيارة المسيح بيت زكا، ولم يذكر مثل عشرة الأَمْناء. وضرب المسيح هذا المثل إما في المدينة وإما في الطريق وهو صاعد إلى أورشليم (لوقا ١٩: ١ – ٢٨).
١ «وَلَمَّا قَرُبُوا مِنْ أُورُشَلِيمَ وَجَاءُوا إِلَى بَيْتِ فَاجِي عِنْدَ جَبَلِ ٱلزَّيْتُونِ، حِينَئِذٍ أَرْسَلَ يَسُوعُ تِلْمِيذَيْنِ».
زكريا ١٤: ٤ ومرقس ١١: ١ الخ ولوقا ١٩: ٢٩
وَلَمَّا قَرُبُوا مِنْ أُورُشَلِيمَ صعود المسيح إلى أورشليم الذي ذُكر في بداءة هذا الأصحاح حدث يوم الأحد العاشر من نيسان، وهو بدء الأسبوع الأخير من حياته على الأرض. والأرجح أنه ترك أريحا نهار الجمعة الثامن من نيسان، ووصل إلى بيت عنيا مساءً عند بدء السبت اليهودي كما يظهر من قول يوحنا «ثُمَّ قَبْلَ الْفِصْحِ بِسِتَّةِ أَيَّامٍ أَتَى يَسُوعُ إِلَى بَيْتِ عَنْيَا» (يوحنا ١٢: ١).
بَيْتِ فَاجِي معناه في اليوناني «بيت التين» وهي قرية صغيرة شرق أورشليم على السفح الشرقي من جبل الزيتون، قرب بيت عنيا وعلى الطريق بينها وبين أورشليم. وليس من اليسير تعيين موقعها تماماً اليوم. واستنتج أكثر المفسرين أنها كانت بين بيت عنيا وأورشليم، لأن متّى ذكر وصول المسيح إليها بعدما خرج قاصداً أورشليم. وظنها بعضهم شرق بيت عنيا بناءً على تقديم مرقس ولوقا إياها على بيت عنيا في ذهاب يسوع من أريحا إلى أورشليم. ففهموا من قول متّى أن بيت عنيا كانت متنحِّية عن الطريق السلطانية بين أريحا وأورشليم وبيت فاجي، وأن المسيح في قدومه من أريحا وصل أولاً إلى بيت فاجي، ثم مال عن الطريق إلى بيت عنيا، ثم عاد إليها في سفره إلى أورشليم يوم الأحد.
جَبَلِ ٱلزَّيْتُون ويقع شرق أورشليم، ويفصل بينهما وادي قدرون (يوحنا ١٨: ١). ويرتفع ٢٥٥٦ قدماً فوق سطح البحر، ولا يزيد عن الهيكل سوى ٣٠٠ قدماً، لأن الهيكل كان على جبل المُريا (٢أخبار ٣: ١). وهو على بعد نحو ميل أو ثلث ساعة من المدينة. وحسبت تلك المسافة عند اليهود سفر سبت (أعمال ١: ١٢) وهو ألفا خطوة. ويقع على سفحه الغربي بستان جثسيماني (قارن لوقا ٢٢: ٣٩ مع مرقس ١٤: ٣٢) وعلى سفحه الشرقي بيت فاجي وبيت عنيا.
٢ «قَائِلاً لَهُمَا: اِذْهَبَا إِلَى ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي أَمَامَكُمَا، فَلِلْوَقْتِ تَجِدَانِ أَتَاناً مَرْبُوطَةً وَجَحْشاً مَعَهَا، فَحُلاَّهُمَا وَأْتِيَانِي بِهِمَا».
ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي أَمَامَكُمَا الأرجح أنها بيت فاجي التي لم يكونوا قد وصلوا إليها حينئذٍ وهي المذكورة في العدد الأول.
أَتَاناً… وَجَحْشا اقتصر مرقس ولوقا على ذكر الجحش فقط. وزادا على قول متّى أنه لم يجلس على ذلك الجحش أحدٌ قبل المسيح. وندر ركوب الخيل في الأسفار العادية يومئذٍ في اليهودية لقلتها واستخدامها في الحرب خاصة. واعتاد ملوك بني إسرائيل وأشرافهم ركوب الحمير (قضاة ١٠: ٤، ١٢ و١صموئيل ٢٥: ٢٠) فركوب الحمار لا يدل على الفقر ودناءة المقام فقد ركبه الملوك وقت السلام.
٣ «وَإِنْ قَالَ لَكُمَا أَحَدٌ شَيْئاً فَقُولاَ: ٱلرَّبُّ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِمَا. فَلِلْوَقْتِ يُرْسِلُهُمَا».
وَإِنْ قَالَ لَكُمَا أَحَدٌ أي اعترضكما، ويظهر من ذلك أن أصحاب الأتان والجحش كانوا من معارف يسوع وعارفي معجزاته، لأنه اشتهر كثيراً بإقامة لعازر في بيت عنيا. فكان قول الرسولين إن الرب محتاج إليهما كافٍ لأن يقنع أصحابهما بتسليمهما إلى الرسولين. ولا يخلو ذلك من علم سابق ونبوة، لأن المسيح عرف الحوادث وأنبأ بها قبل أن تحدث.
٤، ٥ «٤ فَكَانَ هٰذَا كُلُّهُ لِكَيْ يَتِمَّ مَا قِيلَ بِٱلنَّبِيِّ: ٥ قُولُوا لابْنَةِ صِهْيَوْنَ: هُوَذَا مَلِكُكِ يَأْتِيكِ وَدِيعاً، رَاكِباً عَلَى أَتَانٍ وَجَحْشٍ ٱبْنِ أَتَانٍ».
إشعياء ٦٢: ١١ وزكريا ٩: ٩ ويوحنا ١٢: ١٤، ١٥
الحادث المذكور إتمام للنبوة، والمسيح قصد إتمامها بما فعله (انظر متّى ١: ٢٢) ونطق زكريا بهذه النبوة منذ ٥٥٠ (زكريا ٩: ٩) ونسبها اليهود في كل عصر إلى المسيح المنتظر، ومقدمتها على ما ذكرها متّى من نبوة إشعياء (إشعياء ٦٢: ١١). ولم يفهم التلاميذ يومئذٍ أن ركوب المسيح على جحشٍ كان إتماماً لنبوة زكريا (يوحنا ١٢: ١٦). أمر المسيح تلاميذه قبل هذا الوقت أن لا يُظهروا للناس أنه المسيح ملك اليهود، من أجل ذلك تجنب كل احتفال. ولكن حان الوقت لأن يرفع الحجاب عن دعواه وأن يدخل أورشليم باحتفال، ليُظهر للناس أنه المسيح ملك اليهود الروحي.
لابْنَةِ صِهْيَوْن هذا اسم من أسماء أورشليم (إشعياء ١: ٨). لأن جبل صهيون هو أحد الجبال التي بُنيت عليها أورشليم وهو جنوب تلك الجبال وأعلاها.
مَلِكُكِ يَأْتِيكِ وَدِيعا تنبأ النبي بأن المسيح يأتي ملكاً مُدعياً حق التسلط على هذا العالم، ولكنه لا يأتي بمركبات وخيل كمحارب من الملوك الأرضيين، بل يأتي بما يليق برئيس السلام. ولا يأتي بعظمة وافتخار بل بالوداعة. وسيرة المسيح كلها وفق هذه النبوة.
أَتَانٍ وَجَحْشٍ ٱبْنِ أَتَان وفي الأصل «عَلَى حِمَارٍ وَعَلَى جَحْشٍ ابْنِ أَتَانٍ» (زكريا ٩: ٩) فالعطف على ذلك هو للتفسير، فيكون المعنى كقول العامة «حمار ابن حمار» أو لعل متّى قصد الأتان وابنها، وأن التلميذين أتيا بهما وأعداهما للركوب. ولا دليل إلا على أنه ركب أحدهما.
٦ «فَذَهَبَ ٱلتِّلْمِيذَانِ وَفَعَلاَ كَمَا أَمَرَهُمَا يَسُوعُ».
مرقس ١١: ٤
ذكر مرقس ولوقا أن أصحاب الأتان والجحش اعترضوا الرسولين في أول الأمر، فأجاباهم بالجواب الذي أمرهم به المسيح.
٧ «وَأَتَيَا بِٱلأَتَانِ وَٱلْجَحْشِ، وَوَضَعَا عَلَيْهِمَا ثِيَابَهُمَا فَجَلَسَ عَلَيْهِمَا».
٢ملوك ٩: ١٣
وَضَعَا عَلَيْهِمَا ثِيَابَهُمَا القصد بالثياب هنا الخارجية كالرداء والعباءة، ووضعاها احتراماً للراكب كما صنع أصحاب ياهو له (٢ملوك ٩: ١٣). ووضعا الثياب على الدابتين لعدم معرفتهما أيهما يختار أن يركبه.
جَلَسَ عَلَيْهِمَا أي على أحدهما وهو الجحش كما ذكر مرقس ولوقا. وقال «عليهما» بحذف المضاف الذي هو أحد، لمناسبة تكرارهما بضمير الاثنين.
٨ «وَٱلْجَمْعُ ٱلأَكْثَرُ فَرَشُوا ثِيَابَهُمْ فِي ٱلطَّرِيقِ. وَآخَرُونَ قَطَعُوا أَغْصَاناً مِنَ ٱلشَّجَرِ وَفَرَشُوهَا فِي ٱلطَّرِيقِ».
لاويين ٢٣: ٤٠ ويوحنا ١٢: ١٣
ٱلْجَمْعُ ٱلأَكْثَرُ بعض هذا الجمع أتى مع يسوع من أريحا، والبعض رافقه من بيت عنيا، والبعض أتوا من أورشليم ليستقبلوه، وسار بعضهم أمامه وبعضهم وراءه، وكان بينهم بعض الفريسيين الذين لم يفرحوا مع الجمع (لوقا ١٩: ٣٩).
فَرَشُوا ثِيَابَهُمْ… وأَغْصَان مِنَ ٱلشَّجَرِ احتراماً له كما اعتادوا أن يصنعوا للعائدين من الحرب منتصرين، وللملك الراجع إلى بلاده بعد غيبته عنها. وزاد يوحنا على ذلك أن الذين استقبلوه من أورشليم أتوا بسعف النخل (يوحنا ١٢: ١٢، ١٣) وفرشوه في الطريق إظهاراً لزيادة فرحهم بالانتصار والسلام (رؤيا ٧: ٩).
٩ «َٱلْجُمُوعُ ٱلَّذِينَ تَقَدَّمُوا وَٱلَّذِينَ تَبِعُوا كَانُوا يَصْرُخُونَ: أُوصَنَّا لابْنِ دَاوُدَ! مُبَارَكٌ ٱلآتِي بِٱسْمِ ٱلرَّبِّ! أُوصَنَّا فِي ٱلأَعَالِي!».
مزمور ١١٨: ٢٥، ٢٦ ومتّى ٢٣: ٢٩
أُوصَنَّا كلمة سريانية مركبة معنى أولها (أُوْصَ) خلص، ومعنى آخرها (نا) أرجو، وهي منقولة من مزمور ١١٨: ٢٥. وكان استعمالها أصلاً للدعاء، ثم اصطلح الشعب على استعمالها في هتاف السرور. وأكثر ما كانوا يستعملونها لذلك في عيد المظال وهم يرنمون مزمور ١١٨ كله.
لابْنِ دَاوُدَ هذا إقرار الجمع بأن يسوع هو المسيح ملك اليهود. وقبل المسيح هذا الاحترام بالمعنى الذي قصدوه.
مُبَارَكٌ ٱلآتِي وهذا منقول من مزمور ١١٨: ٢٦ ويراد به التمجيد والترحيب. وقصد الجمع بذلك إكرام المسيح وحده لا الزوار الآتين معه إلى العيد، فهو وحده المخلص الذي أتى ليخلص شعبه من خطاياهم.
بِٱسْمِ ٱلرَّبِّ أي المتسربل بسلطان الرب، والذي وكل الرب إليه إعلان مشيئته.
أُوصَنَّا فِي ٱلأَعَالِي إن كان قصدهم بذلك التمجيد، فيكون المعنى: ليتمجد المسيح تمجيداً يبلغ السماء ارتفاعاً! وإن كان قصدهم الدعاء، فيكون المعنى: خلِّص من علو السماء. ولا بد من أن هتافات الجمع كانت متنوعة، فذكر متّى بعضها ومرقس ولوقا غيره. فسأل الفريسيون من ذلك الجمع يسوع أن ينتهر الصارخين فأبى (لوقا ١٩: ٣٩). ولما رأى المدينة افتكر في الدينونة الآتية عليها وبكى، ولم يلتفت إلى ما كان له من الاحتفال والتمجيد أسفاً على المصائب المقبلة على تلك المدينة (لوقا ١٩: ٤١).
١٠ «وَلَمَّا دَخَلَ أُورُشَلِيمَ ٱرْتَجَّتِ ٱلْمَدِينَةُ كُلُّهَا قَائِلَةً: مَنْ هٰذَا؟».
ٱرْتَجَّتِ ارتجت عند دخوله إليها كما اضطربت عند ميلاده (متّى ٢: ٣) وذلك شأن كل حادث عظيم لانتشار خبره سريعاً بها. ولا عجب من أن ترتج من اجتماع تلك الجماعات الكثيرة وهتافهم واحتفالهم بالمسيح.
مَنْ هٰذَا؟ هذا سؤال من رأوا تلك الجماعات وسمعوا هتافها من بعيد، ولم يروا من تحتفل به. أو سؤال من نظروه ولم يعرفوا من هو لأنهم غرباء، فإن المدينة كانت حينئذ غاصة بالغرباء بمناسبة عيد الفصح. وسؤالهم هو تعجب واستفهام، ومعناه: أي الناس هذا حتى يرحب به كل هذا الجمع العظيم ويناديه بابن داود ويمجده معتقداً أنه المسيح؟ وهذا كان تأثير الحادثة في العامة، وأما تأثيرها في الفريسيين فذكره لوقا ويوحنا (لوقا ١٩: ٣٩، ٤٠ ويوحنا ١٢: ١٩).
١١ «فَقَالَتِ ٱلْجُمُوعُ: هٰذَا يَسُوعُ ٱلنَّبِيُّ ٱلَّذِي مِنْ نَاصِرَةِ ٱلْجَلِيلِ».
هذا جواب الجموع للسائلين. وليس فيه من الاحترام ما يوازي الاحترام الذي في هتاف أصدقاء المسيح، لكن فيه تصريحاً باسمه الشائع بين الناس، وهو أسهل على إدراك الغرباء فكأنهم قالوا «نبي الناصرة المشهور».
١٢ «وَدَخَلَ يَسُوعُ إِلَى هَيْكَلِ ٱللّٰهِ وَأَخْرَجَ جَمِيعَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يَبِيعُونَ وَيَشْتَرُونَ فِي ٱلْهَيْكَلِ، وَقَلَبَ مَوَائِدَ ٱلصَّيَارِفَةِ وَكَرَاسِيَّ بَاعَةِ ٱلْحَمَامِ».
تثنية ١٤: ٢٤، ٢٥، ٢٦ ومرقس ١١: ١١، ١٥ ولوقا ١٩: ٤٥ الخ ويوحنا ٢: ١٣ الخ
لم يهتم متّى بأن يذكر حوادث كل يوم من الأسبوع الأخير على ترتيب وقوعها، ولكن مرقس اهتم كثيراً بذلك. ففي بشارته أن المسيح في أول يوم من دخوله أورشليم «دخل الهيكل ونظر حوله إلى كل شيء» و «إِذْ كَانَ الْوَقْتُ قَدْ أَمْسَى، خَرَجَ إِلَى بَيْتِ عَنْيَا» (مرقس ١١: ١١).
دَخَلَ يَسُوعُ هذا من حوادث يوم الاثنين. وأتى من بيت عنيا إلى أورشليم صباحاً، وفي أثناء مسيره حدث بعض ما كان من أمر التينة (مرقس ١١: ١٢ – ١٤).
إِلَى هَيْكَلِ ٱللّٰه بُني الهيكل على جبل المُريا، ووسعوا قمة الجبل بأن أقاموا جدراناً عالية في سفحه في وادي يهوشافاط، وملأوا الفراغ بين القمة والجدران بالتراب والحجارة. وبنى سليمان الهيكل الأول سنة ١٠٠٥ قبل الميلاد، واستغرق بناؤه سبع سنين، ثم هدمه نبوخذ نصر سنة ٥٨٤ قبل الميلاد (٢أخبار ٣٦: ٦، ٧). وبنى زربابل الهيكل الثاني مكان الأول بعد سبعين سنة من هدمه. فكان دون الهيكل الأول في الزينة والبهاء، ولم يكن فيه تابوت العهد إذ فُقد هذا في السبي، ولم تظهر فيه سحابة المجد. ومع ذلك فإنه فاق الأول مجداً لدخول المسيح إليه (حج ٢: ٣، ٩). ودنس ملوك الأمم الذين استولوا على أورشليم هذا الهيكل مراراً، وخربوا جانباً منه. وأخذ هيرودس الكبير يرممه ويصلحه ليستميل إليه قلوب اليهود. وبدأ ذلك من سنة ١٨ من حكمه وذلك عام ٢٠ ق م. واشتغل بترميمه نحو عشرة آلاف من مهرة البنائين، وظل خلفاء هيرودس يصلحونه ويبدلون ويغيرون حتى صح قول اليهود للمسيح أنه «بُني في ٤٦ سنة». واتخذوا الحجارة من الرخام الأبيض، وكان منظره من أبهج مناظر أبنية الأرض لتغشيته بكثير من صفائح الفضة والذهب، علاوة على حسن تلك الحجارة. وكانت فسحة الهيكل مربعة عرض كل من جدرانها أربع مئة ذراع.
وكان في ذلك الهيكل أربع دور:
- الأولى: دار الأمم، وفي الجانب الشرقي منها باب الهيكل الجميل (أعمال ٣: ٢، ١٠) ويحيط بها أروقة، وعلى جوانبها غرف لسكن اللاويين. وفي أحد تلك الجوانب مجمع أو مدرسة لعلماء اليهود. وفي تلك المدرسة جلس يسوع وهو ابن ١٢ سنة وسط المعلمين يسمعهم ويسألهم (لوقا ٢: ٤٦). وفي تلك الأروقة خاطب الشعب، وفيها اجتمع التلاميذ كل يوم بعد صعوده (أعمال ٢: ٤٦). واشتهر أحد هذه الأروقة أكثر من غيرها بنسبته إلى سليمان (أعمال ٣: ١١) وكان علو هذا الرواق ٧٠٠ قدم. فجرب الشيطان المسيح بأن يطرح نفسه من سطحه إلى أسفل. وكان في تلك الدار موائد للصيارفة وباعة الحمام وأمثالهم. وسُميت دار الأمم لأنه لم يكن لغير اليهود أن يجاوزوها إلى الداخل. ولم يكن في هيكل سليمان دار للأمم، فلم يكن فيه سوى دار للكهنة والدار العظيمة (٢أخبار ٤: ٩).
- الثانية: دار النساء، ونُسبت إليهنَّ لا لأنها مختصة بهن، بل لأنه لم يجز لهن أن يتعدَّينها إلى داخل، فكن يأتين إليها ليقدمن القرابين. وهي أعلى من الدار الأولى، فكانوا يصعدون إليها بتسع درجات. وفصلوا بين الدارين بجدار من حجر علوه ذراع، وأقاموا قرب الدرجات أعمدةً من رخام كتبوا عليها باليونانية واللاتينية إنذارات للأمم، خلاصتها أن من جاوزها منهم إلى الداخل يُقتل (أفسس ٢: ١٣، ١٤). واتُّهم بولس أنه أدخل يونانيين إلى الهيكل ودنس ذلك الموضع المقدس (أعمال ٢١: ٢٨). وكان اليهود يمارسون العبادة العادية في تلك الدار (لوقا ١٨: ١٠ – ١٤) و(أعمال ٢١: ٢٦ – ٣٠) وكان في جوانبها ثلاثة عشر صندوقاً يضع العابدون فيها عطاياهم (مرقس ١٢: ٤١).
- الثالثة: دار إسرائيل، أي دار ذكور العبرانيين، وكانت الدار العظيمة في هيكل سليمان تشتمل على هذه الأقسام الثلاثة (٢أخبار ٤: ٩) وهي أعلى من دار النساء، وكانوا يصعدون إليها من تلك بخمس عشرة درجة، وفصلوا بينهما بجدار ارتفاعه ذراع فيه ثلاثة أبواب.
- الرابعة: دار الكهنة، شرق دار إسرائيل وفيها مذبح المحرقة والمرحضة. وغرب هذه الدار كان الهيكل الحقيقي وهو أعلى منها، وكانوا يصعدون إليه باثنتي عشرة درجة. وكان أمامه رواق يتجه إلى الشرق علوه ١٩٠ قدماً، وفي مدخله عمودان: اسم أحدهما ياكين، والثاني بوعز. وقُسم إلى قسمين: الأول القدس، وطوله ٦٠ قدماً وعرضه ٣٠ قدماً، وفيه المنارة الذهبية ومائدة خبز الوجوه ومذبح البخور. والثاني قدس الأقداس، وهو مربع طول كل جانب منه ٣٠ قدماً. وكان حجاب نفيس يفصل بينه وبين القدس (متّى ٢٧: ٥١).
وقد هُدم هذا الهيكل في حصار تيطس لأورشليم بعد الميلاد بسبعين سنة كما تنبأ المسيح (متّى ٢٤: ٢) واجتهد الإمبراطور يوليان أن يبنيه سنة ٣٦٣م، ولم ينجح.
وَأَخْرَجَ كان الذين أخرجهم في دار الأمم. وهذه هي المرة الثانية التي يفعل فيها الأمر نفسه (يوحنا ٢: ١٤، ١٥). وكانوا يتاجرون هناك في حيوانات الذبيحة وكل ما يحتاج إليه العابد للتقدمات من ملح وبخور وزيت وخمر وأمثال ذلك، تسهيلاً لمطالب العبادة. ويحتمل أنهم كانوا يبيعون ما ليس ضرورياً للقرابين، والأرجح أنه كان لرؤساء الكهنة نصيب كبير من ربح تلك التجارة.
مَوَائِدَ أوجبوا أن تكون النقود التي تُدفع في خدمة الهيكل يهودية (خروج ٣٠: ١٣). وكان زوار الهيكل يأتون من ممالك مختلفة بعملات البلاد التي يقيمون فيها، فاحتاجوا إلى الصيارفة ليبدلوها لهم بنقود يهودية. ولا ريب أن في ذلك ربحاً لرؤساء الكهنة يحصلون عليه من الصيارفة. فلما قلَبَ يسوع موائدهم اضطروا أن ينقلوها إلى أماكن أخرى خارج الهيكل.
بَاعَةِ ٱلْحَمَامِ كان الفقراء الذين لا يستطيعون أن يشتروا الغنم والبقر يشترون الحمام للذبيحة (لاويين ٥: ٧ و١٢: ٦ – ٨ و١٤: ٢٢). والظاهر أن المسيح لم يلقَ مقاومةً من أحد على ما فعله من طرد الباعة والصيارفة. ولعل ما فعله لا تستطيعه فرقة من الجنود. والذي حمل المسيح على ذلك العمل كان (١) شدة غيرته لله ولبيته. (٢) أنه أراد أن يعلن للشعب أنه هو المسيح، مصلح ما فسد في الدين إتماماً لنبوة ملاخي (مل ٣: ١، ٢). (٣) رمز إلى ما سيفعله في مجيئه الثاني وإلى فعله الروحي في تنقيته كنيسته وقلب كل مؤمن به، لأن كلاً منهما هيكله. ونذكر ثلاثة أسباب لعدم مقاومتهم إياه: (١) هيئته الخارقة الطبيعة، فإنها أوقعت الرعب في قلوبهم فلم يستطيعوا أن يقاوموه. (٢) مرافقته الجموع الكثيرة له والذين كانوا مستعدين أن يساعدوه على كل شيء. (٣) تبكيت ضمائرهم لهم على أنهم مذنبون بتجارتهم. والشاهد على ذلك أن يسوع أصاب بطردهم.
١٣ «وَقَالَ لَـهُمْ: مَكْتُوبٌ: بَيْتِي بَيْتَ ٱلصَّلاَةِ يُدْعَى. وَأَنْتُمْ جَعَلْتُمُوهُ مَغَارَةَ لُصُوصٍ».
إشعياء ٥٦: ٧ وإرميا ٧: ١١ ومرقس ١١: ١٧
هذه النبوة من أقوال إشعياء (إشعياء ٥٦: ٧).
بَيْتِي دعا اللهُ الهيكلَ بيته لأنه بُني لعبادته، وتخصص له، وأُجريت فيه مراسيم الدين والعبادة.
بَيْتَ ٱلصَّلاَةِ أُضيف البيت إلى الصلاة دون غيرها من مراسيم الدين لأنها الجزء الأعظم من مراسيم العبادة، ولأن الناس اعتادوا أن يعبِّروا بها عن كل ما بقي من تلك الأمور كالتسبيح وتقديم الذبائح والقرابين وقراءة كلمة الله وشرحها وتفسيرها.
مَغَارَةَ لُصُوصٍ وبخ الله اليهود في زمان إرميا النبي على تدنيسهم بيته بالعبادة الوثنية بهذه العبارة عينها (إرميا ٧: ١١). وكان صراخ الباعة والمشترين وأصوات البهائم ورعاتها في الهيكل تليق بمغارة لصوص يقتسمون فيها المسروقات بالخصام لا ببيت أبيه المقدس. فكأنه قال لهم: دنستم بيتي بتجارتكم حتى صار مثل مغارة اللصوص المتدنسة بفظائعهم.
وجعلوا الهيكل مغارة لصوص لأنهم سلبوا الله حقه إذ اتخذوا المعبد الإلهي سوقاً للكسب المادي. وسلبوا قاصدي العبادة الروحيين الفرصة التي اغتنموها ليرفعوا قلوبهم إلى الله بالصلاة في مقدسه المعين لها. وسلبوا الغرباء أموالهم بأن خدعوهم وغشوهم ببيع مواد التقدمة وصرف النقود.
والمرجح أن المسيح بقي كل هذا النهار (وهو نهار الاثنين) في الهيكل يمنع الناس من تدنيسه حتى قيل «إنه لَمْ يَدَعْ أَحَدًا يَجْتَازُ الْهَيْكَلَ بِمَتَاعٍ» (مرقس ١١: ١٦) وشغل المسيح الوقت بتعليم الناس، وصنع المعجزات. وكان رؤساء الكهنة وحراس الهيكل في كل تلك المدة ينظرون إليه بالغيظ، ويتآمرون على قتله لأنهم عجزوا عن إيقاع الأذى به وقتها (يوحنا ١٢: ١٩ ومرقس ١١: ١٨).
١٤ «وَتَقَدَّمَ إِلَيْهِ عُمْيٌ وَعُرْجٌ فِي ٱلْهَيْكَلِ فَشَفَاهُمْ».
إشعياء ٣٥: ٥، ٦
عُمْيٌ وَعُرْجٌ كان هؤلاء مجتمعين على جوانب الطرق إلى الهيكل ومداخله، ليطلبوا صدقة من العابدين الداخلين إليه، فتركوا طلب الصدقات ودخلوا دار الهيكل فشفاهم يسوع. ودنس الكهنة بيت الصلاة بأن جعلوه سوق تجارة، أما يسوع فقدسه بأن جعله بيت رحمة. وأظهر بطرده الباعة غيرته لقداسة بيت الله، وأظهر بمعجزاته قوته ورحمته وجوده. فكان صنعه تلك المعجزات جواباً لسؤال الذين سألوا في اليوم السابق «من هذا» (انظر ع ١٠). وصنع المسيح معجزات في أورشليم قبل ذلك ولكن لم يصنعها في الهيكل.
١٥ «فَلَمَّا رَأَى رُؤَسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ وَٱلْكَتَبَةُ ٱلْعَجَائِبَ ٱلَّتِي صَنَعَ، وَٱلأَوْلاَدَ يَصْرُخُونَ فِي ٱلْهَيْكَلِ وَيَقُولُونَ: أُوصَنَّا لابْنِ دَاوُدَ»؟».
اغتاظ رؤساء الكهنة من تأثير أعمال المسيح وتعاليمه في نفوس الشعب، وخافوا من خسارة سلطتهم عليهم، ورأوا في نجاحه موانع من تنفيذ قصدهم قتله (يوحنا ١١: ٥٣، ٥٧) وفهموا جيداً أن قصد يسوع من أعماله هو إثبات كونه المسيح، مُصلح الدين اليهودي الذي أنبأ به إشعياء وملاخي (إشعياء ٤: ٤ ومل ٣: ٣ و٤: ١).
ٱلْعَجَائِبَ في معجزات شفاء المرضى، وطرد الباعة من الهيكل. فتلك زادتهم كراهيةً له بدل أن تقنعهم بصحة دعواه.
ٱلأَوْلاَدَ يَصْرُخُونَ فِي ٱلْهَيْكَلِ أخذ الأولاد يكررون ما هتفت به الجموع عند دخول المسيح أورشليم والهيكل. ودلَّ هذا على احترام الشعب له. ويحتمل أن الأولاد رأوا آيات المسيح وسبحوه لأجلها.
١٦ «وَقَالُوا لَهُ: أَتَسْمَعُ مَا يَقُولُ هٰؤُلاَءِ؟ فَقَالَ لَـهُمْ يَسُوعُ: نَعَمْ! أَمَا قَرَأْتُمْ قَطُّ: مِنْ أَفْوَاهِ ٱلأَطْفَالِ وَٱلرُّضَّعِ هَيَّأْتَ تَسْبِيحاً؟».
مزمور ٨: ٢
أَتَسْمَعُ أشاروا بذلك إلى أنه لا يليق أن تسمع أصوات الأولاد في الهيكل، وأنه لا خدمة لهم في العبادة لصغرهم. وقصدوا بذلك توبيخ المسيح على أنه سمح بتقديمهم التسبيح له في ذلك المكان. وقولهم «هؤلاء» يعني قصدهم أنه لا يدعوه «ابن داود» إلا الأولاد الصغار.
أَمَا قَرَأْتُمْ في هذا السؤال شيءٌ من التوبيخ لرؤساء الكهنة والتعريض بغفلتهم عن كتاب الله، لأنهم لو عرفوا كلام الله حق المعرفة ما عثروا في تسبيح الأولاد في الهيكل إكراماً له. والكلام الذي اقتبسه هنا هو في مزمور ١٨: ٢ من الترجمة السبعينية، ومعناه أن الله يفرح بتسبيح الأولاد له إن كان نتيجة تأملهم في خليقته أو في إرساله المسيح فادياً ومخلصاً. فبيَّن بهذا حُسن تقديم ذلك التسبيح ولياقته في هيكله، وقال إن التسبيح له هو تسبيح لله. ولنا من ذلك أن الله يفرح الآن بصلاة الأولاد وتسبيحهم في البيوت وفي مدارس الأحد وفي الكنائس.
١٧ «ثُمَّ تَرَكَهُمْ وَخَرَجَ خَارِجَ ٱلْمَدِينَةِ إِلَى بَيْتِ عَنْيَا وَبَاتَ هُنَاكَ».
مرقس ١١: ١١ ويوحنا ١١: ١٨
تَرَكَهُمْ أي رؤساء الكهنة.
إِلَى بَيْتِ عَنْيَا وبات هناك إما في بيت لعازر (يوحنا ١١: ١) أو في بيت سمعان الأبرص (مرقس ١٤: ٣). وكانت تلك القرية على سفح جبل الزيتون الشرقي، واشتهرت بأنها وطن لعازر وأختيه مريم ومرثا. وهي تبعد مسيرة نحو ثلاثة أرباع الساعة من أورشليم (يوحنا ١١: ١٨).
١٨ «وَفِي ٱلصُّبْحِ إِذْ كَانَ رَاجِعاً إِلَى ٱلْمَدِينَةِ جَاعَ».
مرقس ١١: ١٢ الخ
كثيراً ما ذكر متّى الحوادث بدون التفات إلى ترتيب وقوعها. وأما مرقس فرتب الحوادث حسب أزمنتها وذكرها تفصيلاً. فنتعلم من بشارة مرقس ما لا نتعلمه من بشارة متّى، وهو أن المسيح لعن التينة في صباح يوم الاثنين عند ذهابه إلى المدينة لكي يطهر الهيكل، وأن التلاميذ شاهدوا أنها يبست في صباح الغد أي يوم الثلاثاء. ومتّى ذكر لعنة التينة ويبسها معاً بغضّ النظر عن أن بينهما يوماً، فذكرها بين حوادث يوم الثلاثاء أي بعد تطهيره الهيكل بيوم.
فِي ٱلصُّبْحِ أي صباح الاثنين على ما قال مرقس ١١: ١٢، ١٥.
جَاع أظهر يسوع ناسوته بجوعه، وأظهر لاهوته بتيبيس الشجرة بكلامه. أظهر شدة غيرته في التعليم في الهيكل بأن ذهب إليه من بيت عنيا قبل أن يتناول طعاماً.
١٩ «فَنَظَرَ شَجَرَةَ تِينٍ عَلَى ٱلطَّرِيقِ، وَجَاءَ إِلَيْهَا فَلَمْ يَجِدْ فِيهَا شَيْئاً إِلاَّ وَرَقاً فَقَطْ. فَقَالَ لَهَا: لاَ يَكُنْ مِنْكِ ثَمَرٌ بَعْدُ إِلَى ٱلأَبَدِ. فَيَبِسَتِ ٱلتِّينَةُ فِي ٱلْحَال».
عَلَى ٱلطَّرِيقِ كانت تلك الشجرة مباحة لأبناء السبيل.
جَاءَ إِلَيْهَا لا يلزم الفهم من ذلك أن المسيح لم يعرف أنها غير مثمرة، فقصد أن يعلم التلاميذ مثالاً أخلاقياً بواسطة تلك الشجرة، ففعل كما يفعل غيره من الناس في مثل تلك الأحوال، فوجدها كثيرة الأوراق، فاتخذ ذلك دليلاً على أن عليها شيئاً من باكورة التين. لأنه من المعلوم أن التين في فلسطين يثمر مع الأوراق، ويُنضج أحياناً بعض الثمر قبل غيره بأيام ليست قليلة.
وجاء في مرقس أنه لم يكن وقت التين أي وقت نضجه العام. وقال ذلك بياناً لقوله إن المسيح «جاء لعله يجد فيها شيئاً» أي بعضاً من باكورة التين. وإذ لم يكن وقت التين كان يقتضي أن لا يكون زمان الورق، فوجود الورق قبل حينه في تلك التينة يعني أنها مثمرة قبل الأوان.
وَرَقاً فَقَطْ أي لم يجد شيئاً من الثمر الفج، ولا من الثمر الناضج، ولا إشارة على أنها ستثمر.
وتلك الشجرة الكثيرة الورق الخالية من الثمر المبكر والمتأخر رمزٌ:
(١) إلى المنافق لأنه يدَّعي زيادة التقوى ولا يعمل شيئاً من أعمالها لمجد الله ولخير الناس.
(٢) إلى الأمة اليهودية التي ادَّعت أنها الأمة المنفردة بالقداسة على الأرض، لأن لها الشريعة والهيكل والشعائر الدينية من الصوم والأعياد والذبائح الصباحية والمسائية، ومع ذلك فهي خلت من الإيمان والمحبة والقداسة والتواضع والاستعداد لقبول المسيح وطاعة أوامره. فافتخرت بكونها شعب الله الخاص ورفضت ابنه الذي أرسله.
(٣) إلى كل إنسان أو كنيسة أو أمة تدَّعي القداسة ولم تأت بأثمار تليق بالتوبة والإيمان (انظر أيضاً مثل شجرة التين في لوقا ١٣: ٦ – ٩).
لاَ يَكُنْ مِنْكِ ثَمَرٌ خاطب الشجرة كأنها تدرك وكأنها أذنبت. وقصد بذلك إفادة البشر. فلا نظن أن المسيح فعل هذا غضباً، بل هو قصد أن يعلّم البشر بمثال منظور كما علمهم كثيراً قبل ذلك بأمثلة مسموعة. ولا فرق بين الرؤيا وهذا المثال، إلا في أن الرؤيا تكون أثناء النوم، وهذا كان في اليقظة. والمسيح لعن الشجرة لا لأنها بلا ثمر، بل لأنها لكثرة أوراقها كأنها ادَّعت الإثمار كذباً. وكان دعاء المسيح على تلك الشجرة نبوَّة بمستقبل الأمة اليهودية، فشتاتها في كل البلاد (مثل أغصان من تلك التينة) هو إنذار للناس في كل عصر بوقوع دينونة الله عليهم إن لم يأتوا بثمار القداسة، لأنهم كأغصان الكرم التي ينزعها الكرام ويحرقها (يوحنا ١٥: ٢، ٦) ومثل «أَشْجَارٌ خَرِيفِيَّةٌ بِلاَ ثَمَرٍ مَيِّتَةٌ مُضَاعَفًا، مُقْتَلَعَةٌ» (يهوذا ١٢). وهو إنذار لكل الكنائس غير المثمرة ككنيسة أفسس (رؤيا ٢: ٥).
فَيَبِسَتِ فِي ٱلْحَال نفهم من ذلك أن التينة أخذت تيبس من تلك الساعة. ويُحتمل أن التلاميذ شاهدوا حينئذ الأوراق تذبل. على أن التلاميذ لما رجعوا مساءً إلى بيت عنيا لم يلاحظوا ما أصابها من التغيير، ولكنهم رأوا ذلك في الغد (أي يوم الثلاثاء) وهم راجعون إلى أورشليم (مرقس ١١: ٢٠). فسرعة يبس الشجرة إشارة إلى خراب أورشليم وعقاب الأمة اليهودية.
ويتضح لنا من هذا ثلاثة أمور:
(١) معجزة إظهار قوة المسيح وهو تيبيس الشجرة بكلمة.
(٢) مثل لبيان عقاب المنافقين.
(٣) النبوة بخراب أورشليم.
صنع المسيح آيات كثيرة أظهر بها الرحمة. وهذه هي الآية الوحيدة التي أظهر بها العقاب فعلّم بها أنه يُجري العدل والقضاء كما يمنح الرحمة. وقد علّم مثال الدينونة بألطف الطرق، بأن ضرب تلك الشجرة، وهي جسم بلا شعور، ومبذولة لكل عابر سبيل فلم يتلف مالاً خاصاً. وتلك الشجرة عقيمة لا نفع منها للعامة فلم يتلف مالاً عاماً.
٢٠ «فَلَمَّا رَأَى ٱلتَّلاَمِيذُ ذٰلِكَ تَعَجَّبُوا قَائِلِينَ: كَيْفَ يَبِسَتِ ٱلتِّينَةُ فِي ٱلْحَالِ!».
مرقس ١١: ٢٠
لَمَّا رَأَى ٱلتَّلاَمِيذُ كان ذلك في يوم الثلاثاء. وما سبق في ع ١٨، ١٩ كان في يوم الاثنين، فجمع متّى حوادث اليومين وقصها جملة.
تَعَجَّبُوا من سرعة تأثير فعل المسيح في التينة. كانت خضراء فأصبحت يابسة كأنها ماتت منذ سنين، وذلك بكلمة فقط. والذي نطق بكلمات التعجب هو بطرس، فكان نائباً عن سائر الرسل كعادته (مرقس ١١: ٢١).
٢١ «فَأَجَابَ يَسُوعُ: ٱلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنْ كَانَ لَكُمْ إِيمَانٌ وَلاَ تَشُكُّونَ، فَلاَ تَفْعَلُونَ أَمْرَ ٱلتِّينَةِ فَقَطْ، بَلْ إِنْ قُلْتُمْ أَيْضاً لِهٰذَا ٱلْجَبَلِ: ٱنْتَقِلْ وَٱنْطَرِحْ فِي ٱلْبَحْرِ فَيَكُون»
متّى ١٧: ٢٠ ولوقا ١٧: ٦ و١كورنثوس ١٣: ٢ ويعقوب ١: ٦
لم يذكر المسيح شيئاً مما قصد بلعنه الشجرة، وترك ذلك لتأمل التلاميذ. وبيَّن لهم قوة الإيمان بتأثير كلامه في التينة. والإيمان المقصود هنا هو الإيمان الضروري لعمل المعجزات. وقد شاهد التلاميذ قوة المسيح بتلك المعجزة، فأكد لهم أنهم يستطيعون أعظم منها إن آمنوا به وقرنوا إيمانهم بالصلاة.
لِهٰذَا ٱلْجَبَلِ: ٱنْتَقِل الخ هذا الكلام جارٍ مجرى المثل، يراد به المستحيل على القوة البشرية، وذلك مثل ما جاء في قول بولس للكورنثيين (١كورنثوس ١٣: ٢) راجع شرح متّى ١٧: ٢٠. وأراد بالجبل هنا جبل الزيتون وبالجبل في ص ١٧ جبل الشيخ. إن نقل الجبال سهل على الله كإبراء المريض، ومع ذلك لم ينقل جبلاً لأنه ليس من مواضيع صلاة الإيمان. على أن إزالة الأمة اليهودية، والمملكة الرومانية وديانتها الوثنية من أمام الإنجيل، أعظم برهان على قوة الله ونعمته. إنها أعظم من نقل جبل حرمون وجبل الزيتون معاً وطرحهما في البحر. وهذا تم فعلاً. وأكد المسيح أنهم يتغلبون على كل الموانع في سبيل تأسيس الكنيسة.
ومعلوم أن قوة الله غير محدودة، وأن الرسل يستطيعون أن ينالوا على قدر إيمانهم. فإذا كان لهم إيمان لا يعجزون عن صنع شيء من العجائب مهما كان عظيماً، إن كان ضرورياً لنجاح الإنجيل.
٢٢ «وَكُلُّ مَا تَطْلُبُونَهُ فِي ٱلصَّلاَةِ مُؤْمِنِينَ تَنَالُونَهُ».
متّى ٧: ٧ ومرقس ١١: ٢٤ ولوقا ١١: ٩ ويعقوب ٥: ١٦ و١يوحنا ٣: ٢٢ و٥: ١٤
علم المسيح تلاميذه في هذا العدد ما يمكنهم أن يحصلوا به على مساعدة تلك القوة غير المتناهية، وهو الصلاة والإيمان معاً لا أحدهما دون الآخر. ولم يقصد المسيح بهذا القول غير تلاميذه الاثني عشر، ولم يعدهم إلا في نشرهم إنجيله ومقاومة أعدائه. فمن الضروري أن ذلك الوعد مقيد بشرط أنهم لا يطلبون إلى الله شيئاً لا يليق أن يمنحهم إياه.
كُلُّ مَا أي كل ما هو ضروري لإجراء أعمالهم الرسولية وموافق لإرادة الله.
٢٣ «وَلَمَّا جَاءَ إِلَى ٱلْهَيْكَلِ تَقَدَّمَ إِلَيْهِ رُؤَسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ وَشُيُوخُ ٱلشَّعْبِ وَهُوَ يُعَلِّمُ، قَائِلِينَ: بِأَيِّ سُلْطَانٍ تَفْعَلُ هٰذَا، وَمَنْ أَعْطَاكَ هٰذَا ٱلسُّلْطَانَ؟».
مرقس ١١: ٢٧ ولوقا ٢٠: ١ وخروج ٢: ١٤ وأعمال ٤: ٧ و٧: ٢٧
أتى يسوع في ذلك اليوم (يوم الثلاثاء) إلى الهيكل وبدأ يعلم الشعب كما فعل في يوم الاثنين. وكان مكان تعليمه موافقاً لاجتماع الشعب، وذلك إما دار الأمم أو دار إسرائيل الداخلية. وكان ذلك اليوم آخر يوم من أيام تعليمه العلني على الأرض، وهو من أهم أيام حياته.
رُؤَسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ وَشُيُوخُ ٱلشَّعْبِ اجتمعوا سابقاً وتآمروا في اتخاذ أحسن الوسائل ليصطادوه أو يجدوا علة يشتكون بها عليه إلى المجلس اليهودي الكبير، أو إلى الوالي الروماني (لوقا ١٩: ٤٧، ٤٨). ويظهر من النتيجة أنهم اتفقوا في تلك المؤامرة على أن يرسلوا إليه أناساً من فرق اليهود المختلفة، يسألونه أسئلة مخادعة ليوقعوه بها. وكان أول تلك المسائل قولهم:
بِأَيِّ سُلْطَان سأله رؤساء اليهود الدينيين وحراس الهيكل هذا السؤال، وكان لهم حق شرعي في مراقبة الأعمال التي تجري في الهيكل. فأتى يسوع المدينة راكباً باحتفال الجموع الهاتفين بقولهم «أُوصنا» ودخل الهيكل وادَّعى أن له حقاً أن ينظم ويصلح الأمور فيه، مع أنه لم يكن من الكهنة الذين هم بنو لاوي، وليس له سلطان على ذلك من الحبر الأعظم ولا من الوالي الروماني.
تَفْعَلُ هٰذَا أي طرد من يبيع ويشتري في الهيكل، ومنع كل من يمر بمتاع وتعليمه فيه. فأقام لهم برهاناً كافياً على أنه نبي مرسل من الله بالمعجزات التي صنعها أمام عيونهم. فأظهروا أنهم لم يقتنعوا بذلك البرهان، وطالبوا بغيره. ولم يفعلوا ذلك بإخلاص بل بمكر ليجدوا عليه ما يمكنهم من الشكوى عليه بأنه يجدف. فحاولوا أن يحصلوا على الجواب الذي حصل عليه قيافا بعد ذلك بسؤال صريح، وهو قوله إنه ابن الله (متّى ٢٦: ٦٣، ٦٤).
٢٤ – ٢٦ «٢٤ فَأَجَابَ يَسُوعُ: وَأَنَا أَيْضاً أَسْأَلُكُمْ كَلِمَةً وَاحِدَةً، فَإِنْ قُلْتُمْ لِي عَنْهَا أَقُولُ لَكُمْ أَنَا أَيْضاً بِأَيِّ سُلْطَانٍ أَفْعَلُ هٰذَا: ٢٥ مَعْمُودِيَّةُ يُوحَنَّا، مِنْ أَيْنَ كَانَتْ؟ مِنَ ٱلسَّمَاءِ أَمْ مِنَ ٱلنَّاسِ؟ فَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ قَائِلِينَ: إِنْ قُلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ، يَقُولُ لَنَا: فَلِمَاذَا لَمْ تُؤْمِنُوا بِهِ؟ ٢٦ وَإِنْ قُلْنَا: مِنَ ٱلنَّاسِ، نَخَافُ مِنَ ٱلشَّعْبِ، لأَنَّ يُوحَنَّا عِنْدَ ٱلْجَمِيعِ مِثْلُ نَبِيّ».
متّى ١٤: ٥ ومرقس ٦: ٢٠ ولوقا ٢٠: ٦
أجابهم يسوع بحكمة فلم يمنحهم فرصة للشكوى. ولم يرد بسؤاله أن يتخلص من الإجابة، إنما سألهم لأن جواب سؤالهم ضمن جواب سؤاله.
مَعْمُودِيَّةُ يُوحَنَّا القصد بمعمودية يوحنا كل خدمته، أي تعليمه الذي كانت المعمودية إشارة إليه وختماً له.
مِنَ ٱلسَّمَاءِ أي من الله. فإن أجابوا بالحق أن معمودية يوحنا من السماء، أي أنه نبي، ففي ذلك جواب لسؤالهم، لأن يوحنا شهد أن ليسوع سلطان المسيح التام (يوحنا ١: ٢٧، ٢٩، ٣٤ و٣: ١٣).
فَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ الأرجح أنهم فكروا في ما بينهم. ولم يكن تفكيرهم ليجاوبوه بما اعتقدوه حقاً، بل ليجهزوا جواباً وفق أهوائهم. فرأوا أنهم إن قالوا إن يوحنا نبي يدينون أنفسهم لأنهم لم يؤمنوا بتعليمه وبشهادته ليسوع أنه المسيح. وإن قالوا إنه ليس نبياً حكموا أنه كاذب، فيهيج عليهم الشعب ويرجمونهم، لأنهم يعتبرون يوحنا نبياً عظيماً صادقاً (لوقا ٢٠: ٦ ويوحنا ٧: ٢٧).
٢٧ «فَأَجَابُوا يَسُوعَ: لاَ نَعْلَمُ. فَقَالَ لَـهُمْ هُوَ أَيْضاً: وَلاَ أَنَا أَقُولُ لَكُمْ بِأَيِّ سُلْطَانٍ أَفْعَلُ هٰذَ».
إشعياء ٢٩: ١٠ – ١٢ وكولوسي ١: ١٩، ٢٨
لم يبق لهم سبيل للتخلص إلا بأن يدَّعوا الجهل، فاعترفوا أنهم لا يستطيعون أن يحكموا في أمر يوحنا المعمدان، وثبت أنهم غير أكفاء لأن يحكموا في دعوى المسيح.
لاَ نَعْلَمُ والصحيح أنهم لم يريدوا أن يظهروا اعتقادهم، فقد اعتقدوا أن معمودية يوحنا من الناس. وعلم المسيح رياءهم ولم يجبهم إلا بالسؤال الذي أفحمهم. ولا شك أنهم خجلوا كثيراً لأنهم اضطروا أن يعترفوا بالجهل بعد أن أرسلوا من أورشليم إلى يوحنا لجنة من الكهنة واللاويين للنظر في دعواه (يوحنا ١: ١٩).
وَلاَ أَنَا أَقُولُ لأني سكنت الرياح وأمواج البحر بأمري، ومشيت على الماء كما على اليابسة، وأشبعت ألوفاً من الناس من بضعة أرغفة، وشفيت كل أنواع الأمراض بكلمتي أو لمس يدي، وأخرجت الشياطين، وأقمت الموتى. وهذه براهين قاطعة على أن لي سلطاناً إلهياً به فعلت كل ما فعلت، ومع كل هذا لم تؤمنوا. فما فائدة الكلام!
فنرى من ذلك أن الحق واحد لا يتجزأ. ولا يصح أن يقبل الإنسان جزءاً منه ويترك باقيه. لقد رفضوا دعوى يسوع وامتنعوا عن قبول دعوى المعمدان! ويورد بعض الناس المسائل الدينية متظاهرين أنهم يطلبون الفائدة وهم يبطنون الكفر.
٢٨ «مَاذَا تَظُنُّونَ؟ كَانَ لإِنْسَانٍ ٱبْنَانِ، فَجَاءَ إِلَى ٱلأَوَّلِ وَقَالَ: يَا ٱبْنِي، ٱذْهَبِ ٱلْيَوْمَ ٱعْمَلْ فِي كَرْمِي».
أورد المسيح للكتبة والفريسيين ثلاثة أمثال بيَّن لهم في الأول خطيتهم، وفي الثاني عقابهم، وفي الثالث عاقبة كفرهم وعصيانهم لأمتهم ومدينتهم.
مَاذَا تَظُنُّونَ؟ سأل الكتبة هذا السؤال ليدينوا أنفسهم بجوابهم له، كما دان داود نفسه بجوابه لناثان. فلم يكتفِ بدفعهم عنه عندما تحاملوا عليه، بل حمل عليهم بما سيأتي من الأمثال، ليبيِّن إثمهم لعدم إيمانهم به.
ٱبْنَان أراد بالاثنين قسمي الناس الذين بلغتهم تعاليمه. فأحدهما أشرار لم يدَّعوا أنهم يطيعون الله، وتعدوا الشريعة علانية بلا حياء، كالعشارين والزناة. والقسم الثاني هم الذين حاولوا أن يبرروا أنفسهم بأعمال الناموس، كالكتبة والفريسيين، فامتنعوا عن الشر ظاهراً وافتخروا بتقواهم. ويبدو للمشاهد أن القسم الثاني أفضل من القسم الأول، لأن البر الذي في الناموس خير من عدم البر. وهذا المثل عن صاحب كرم يعتني بكرمه هو وعائلته. والقصد برب الكرم الله، وبالكرم العالم (متّى ١٣: ٣٨). وبالابنين ما ذكرناه، وبدعوة أبيهما إلى العمل دعوة الله للناس إلى العمل معه (١كورنثوس ٣: ٩).
ٱلأَوَّلِ أراد به العشارين والزناة.
ٱعْمَلْ فِي كَرْمِي ذلك ما يحق لصاحب الكرم أن يأمر ابنه به، وفيه إشارة إلى أن لله حقاً أن يأمر الناس بخدمته. وأعظم ما يأمر الله به قبول ابنه (يوحنا ٦: ٢٩). والذي أمر به رب الكرم ابنه شفاهاً يأمرنا به الله بكتابه، وبروحه، مخاطباً ضمائرنا.
٢٩ «فَأَجَابَ: مَا أُرِيدُ. وَلٰكِنَّهُ نَدِمَ أَخِيراً وَمَضَى».
مَا أُرِيدُ هذا دليل على العصيان والاستخفاف والجسارة، لأنه لم يكلف نفسه عناء تقديم عذر. وما قاله هذا الابن هو قول لسان حال العشارين والزناة.
نَدِمَ أَخِيراً وَمَضَى أي ذهب إلى الكرم وعمل فيه بالرضى والأمانة كما أمره أبوه. وهكذا فعل العشارون والزناة بالتوبة والطاعة عند تبشير يوحنا المعمدان، كما شهد المسيح لهم في ع ٣٢ فاعتمدوا منه (لوقا ٧: ٢٩). وأتى كثيرون منهم إلى المسيح (لوقا ١٥: ١) فاتضع الذين كانوا عصاة وأطاعوا بنعمة الله والإصغاء إلى ضمائرهم. وظهر من هذا العدد قيمة الندامة. فإذا ندم أو تاب شر الخطاة قبله الله. وظهر منه أيضاً برهان التوبة الحقيقية، وهو العمل لا الكلام ولا الدموع.
٣٠ «وَجَاءَ إِلَى ٱلثَّانِي وَقَالَ كَذٰلِكَ. فَأَجَابَ: هَا أَنَا يَا سَيِّدُ. وَلَمْ يَمْضِ».
متّى ٢٣: ٣ وتيطس ١: ١٦
لم يرد بتقديم ذكر أحد الابنين على الآخر أن الدعوة وُجِّهت لأحدهما قبل الآخر، إنما أراد أن الاثنين دُعيا دعوة واحدة.
هَا أَنَا هذا جواب الابن الثاني، وهو جواب رياء لا جواب إخلاص، لأنه لم يقصد العمل وأجاب بما ذكر ستراً لما قصده من العصيان. ودليل ذلك أن المسيح ذكر أنه قال «ها أنا، ولم يمضِ» فلم يقل إنه ندم على قوله كما قال الأول. وفي ذلك إشارة إلى ما فعله الكتبة والفريسيون، فإنهم ادعوا شديد الغيرة لشريعة الله، وتظاهروا بالاستعداد التام للطاعة الكاملة لأوامره، ولكنهم عصوها بدليل قول المسيح عنهم «يَقْتَرِبُ إِلَيَّ هذَا الشَّعْبُ بِفَمِهِ، وَيُكْرِمُني بِشَفَتَيْهِ، وَأَمَّا قَلْبُهُ فَمُبْتَعِدٌ عَنِّي بَعِيدًا» وقوله «حَسَبَ أَعْمَالِهِمْ لاَ تَعْمَلُوا، لأَنَّهُمْ يَقُولُونَ وَلاَ يَفْعَلُونَ» (متّى ١٥: ٨ و٢٣: ٢) فقد اقتصروا على حفظ طقوس الشريعة وأعرضوا عن فضائلها، وقاوموا الله في تأسيس ملكوته الإنجيلي، وعزموا على قتل ابنه.
وَلَمْ يَمْضِ الله لا يقبل الإقرار بالطاعة والتقوى إذا لم يقترن بالعمل. وهذا مثال لما فعله الفريسيون بادعائهم التقوى ادعاء الابن الثاني بقوله «ها أنا». وعدم مضيه مثالٌ لما فعلوه يوم دعاهم الله أولاً إلى التوبة بلسان يوحنا المعمدان، وثانياً بلسان يسوع المسيح.
٣١ «فَأَيُّ ٱلاثْنَيْنِ عَمِلَ إِرَادَةَ ٱلأَبِ؟ قَالُوا لَهُ: ٱلأَوَّلُ. قَالَ لَـهُمْ يَسُوعُ: ٱلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ ٱلْعَشَّارِينَ وَٱلزَّوَانِيَ يَسْبِقُونَكُمْ إِلَى مَلَكُوتِ ٱللّٰهِ».
لوقا ٧: ٢٩، ٥٠
إِرَادَةَ ٱلأَبِ هي الطاعة لأمره بالذهاب إلى كرمه والعمل فيه. وأراد بها حفظ كل شريعة الآب السماوي المعلنة في كتابه والاجتهاد في سبيل ملكوته.
قَالُوا لَهُ: ٱلأَوَّل أجابوا بالصواب، ولم يشعروا بأنهم دانوا أنفسهم بتلك الإجابة لأنهم لم يفهموا قصد المسيح بالمثل. ولا عجب من أنهم لم يشعروا بذلك، لأن الذين يرفعون لله صلوات شكر أنهم أفضل من باقي الناس لا يشعرون بأنهم يشبهون الابن الذي قال «ها أنا يا سيد» ولم يمضِ. فالأول هو الذي أطاع دون الثاني. كان الأول رديء القول جيد العمل. وكان الثاني جيد القول رديء العمل.
قَالَ لَـهُمْ يَسُوعُ أوضح المسيح للفريسيين ما لم يفهموه من ذلك المثل، وما قصده بالابنين.
يَسْبِقُونَكُمْ إلى دخول الملكوت السماوي. أي أن رجاء دخول العشارين والزناة ذلك الملكوت أقوى من رجاء دخول الفريسيين إليه، لأن كبرياء الفريسيين واتكالهم على البر الذاتي جعلاهم يبقون خارج ذلك الملكوت غير مبالين بالملجأ الذي أعده الله للنجاة من غضبه الآتي على العالم الساقط في هاوية الخطية. وأما العشارون فشعروا بإثمهم، وأن لا شيء لهم من البر الذاتي، فبادروا إلى الهروب من ذلك الغضب إلى ملجأ بر المسيح الكامل وفدائه (متّى ٩: ٩ ولوقا ٧: ٢٩ و٣٧ – ٥٠ و١٥: ١، ٢ و١٩: ٢، ٩، ١٠).
٣٢ «لأَنَّ يُوحَنَّا جَاءَكُمْ فِي طَرِيقِ ٱلْحَقِّ فَلَمْ تُؤْمِنُوا بِهِ، وَأَمَّا ٱلْعَشَّارُونَ وَٱلزَّوَانِي فَآمَنُوا بِهِ. وَأَنْتُمْ إِذْ رَأَيْتُمْ لَمْ تَنْدَمُوا أَخِيراً لِتُؤْمِنُوا بِه».
متّى ٣: ١ الخ و٢بطرس ٢: ٢، ٢١ ولوقا ٣: ١٢، ١٣
طَرِيقِ ٱلْحَقّ أي الطريق الحقيقية لنوال البر، وهي التوبة والإيمان بالمسيح الذي شهد له يوحنا أنه «الطريق والحق والحياة» (يوحنا ١٤: ٦)
فَآمَنُوا بِه أي بتعليم وجوب التوبة، وبشهادته أن يسوع هو المسيح.
وَأَنْتُمْ إِذْ رَأَيْتُمْ في هذا تلميح إلى أنه كان يجب على الفريسيين أن يرغبوا في التوبة اقتداءً بالعشارين.
لَمْ تَنْدَمُوا أشار المسيح بذلك إلى أن الله يرفض بر الفريسيين الذي افتخروا به، وأنهم محتاجون إلى التوبة كالعشارين. ولا يلزم أن يفهم من هذا العدد أن كل العشارين تابوا، ولا أنه لم يتب أحد من الفريسيين. إنما القصد أن الذين آمنوا كانوا ممن قبلوا الرسالة، من أمثال متّى وزكا من العشارين، ونيقوديموس ويوسف الرامي ثم بولس من الفريسيين.
ولم يعلّم المسيح بهذا المثل أن رجاء خلاص الشرير والمنافق المشهور برذائله أقوى من رجاء خلاص الذي سيرته الظاهرة حسنة. إنما أراد أن يوضح أن الأمل في خلاص أثيم إذا تاب وترك كل خطاياه هو أقوى من الأمل بنجاة الذي يتظاهر بالفضيلة دون أن يترك خطاياه القلبية من الكبرياء على البر الذاتي.
٣٣ «اِسْمَعُوا مَثَلاً آخَرَ: كَانَ إِنْسَانٌ رَبُّ بَيْتٍ غَرَسَ كَرْماً، وَأَحَاطَهُ بِسِيَاجٍ، وَحَفَرَ فِيهِ مَعْصَرَةً، وَبَنَى بُرْجاً، وَسَلَّمَهُ إِلَى كَرَّامِينَ وَسَافَرَ».
مزمور ٨٠: ٨ – ١١ ونشيد الأنشاد ٨: ١١ وإشعياء ٥: ١ الخ وإرميا ٢: ٢١ ومرقس ١٢: ١ الخ ولوقا ٢٠: ٩ الخ، متّى ٢٥: ١٤، ١٥
اِسْمَعُوا مَثَلاً آخَرَ في هذا تلميح إلى أن الفريسيين أرادوا الانصراف عن المسيح، فلم يسمح لهم بذلك قبل أن يسمعهم كلام التوبيخ والإنذار. وأبان لهم في هذا المثل العقاب الذي سيجلبونه على أنفسهم بعصيانهم.
إِنْسَانٌ رَبُّ بَيْتٍ رمز برب البيت إلى الله.
غَرَسَ كَرْماً القصد بالكرم ملكوت الله على الأرض، أي كنيسته التي سلمها أولاً إلى شعب العبرانيين وسماها كرمة (مزمور ٨٠: ٨ وإشعياء ٣: ١ وحزقيال ١٥: ٢) وقوله «غرس كرماً» يدل على أن الله مؤسس الكنيسة، علاوة على أنه ربها. فدعا أولاً إبراهيم من بين النهرين وبدأ تأسيس الكنيسة في عائلته. ثم أتى بنسله من مصر وأسكنه أرض كنعان وفرض لهم رموزاً امتازوا بها عن سائر الأمم كما يمتاز الكرم بسياجه عن غيره من الأراضي، وحماهُ بعنايته (إشعياء ٢٦: ١ و٢٧: ٣ وزكريا ٢: ٥) وفعل ذلك كله ليجعله شعباً مقدساً مثمراً في كل عمل صالح.
أَحَاطَ… وَحَفَرَ … وَبَنَى أي فعل كل ما يُنتظر من أصحاب الكروم. وزاد على ذلك ليكن ذلك الكرم مخصباً محفوظاً. وفي ذلك إشارة إلى أن الله لم يترك شيئاً مما يقتضيه صلاح الكرم الروحي أي كنيسته اليهودية حتى صح قوله «ماذا يُصنع أيضاً لكرمي وأنا لم أصنعه له» (إشعياء ٥: ٤). وأشار بولس إلى هذه الوسائط بقوله «الَّذِينَ هُمْ إِسْرَائِيلِيُّونَ، وَلَـهُمُ التَّبَنِّي وَالْمَجْدُ وَالْعُهُودُ وَالاشْتِرَاعُ وَالْعِبَادَةُ وَالْمَوَاعِيدُ» (رومية ٩: ٤).
سَلَّمَهُ إِلَى كَرَّامِينَ من عادة أرباب الحقول والكروم أن يسلموها إلى فعلة بشرط أن يؤدوا لأصحابها جزءاً من الثمر. وعلى هذا سلم الله ملكوته أولاً إلى الأمة العبرانية. فكانوا بالنسبة إليه كالفعلة إلى رب الكرم. وكانوا علاوة على ذلك قد عاهدوا الله على أن يكونوا شعبه (خروج ١٩: ٣ – ٨) فكان عصيانهم خيانة ونكثاً بالوعود.
وَسَافَرَ رَمز بحضور رب الكرم وسفره إلى إظهار وجود الله واحتجابه. فلما كان بنو إسرائيل في البرية، ولا سيما يوم كانوا أمام سيناء، أظهر الله لهم حضوره بأمور كثيرة، فكلمهم بصوت مسموع، وسار أمامهم أربعين سنة بعمود السحاب والنار، وأعطاهم المن من السماء كل تلك المدة، وكان يعاقبهم على عصيانهم وتذمرهم في وقته. فيصحُّ أن يُقال إنه كان حاضراً بينهم في كل تلك المدة. ولكن بعد إقامتهم بأرض كنعان ارتفعت عنهم تلك العلامات الظاهرة امتحاناً لهم، ليرى: هل يطيعون هم أوامره أم لا. وعلى هذا يسوغ أن يقال إنه احتجب عنهم. فكلما أمهل الله الخاطئ في هذه الأرض يصح أن يقال إنه بعُد عنه (٢بطرس ٣: ٣، ٤).
٣٤ «وَلَمَّا قَرُبَ وَقْتُ ٱلأَثْمَارِ أَرْسَلَ عَبِيدَهُ إِلَى ٱلْكَرَّامِينَ لِيَأْخُذَ أَثْمَارَهُ».
وَقْتُ ٱلأَثْمَارِ لجني أثمار الكرم الحقيقي وقت معين في كل سنة، ولله كل الحق أن يسأل شعبه ثمار الشكر والطاعة والعبادة والمحبة في كل حين (لوقا ١٣: ٧ ويوحنا ١٥: ٢، ٥، ٨) ويحتمل أن يراد بوقت الأثمار المدة التي تقضَّت على بني إسرائيل بعد إقامتهم بأرض كنعان وانتصارهم على أعدائهم، لأنه كان لهم حينئذ فرصة للتأمل في إتمام الله مواعيده لآبائهم، وإجرائه معجزاته لأجلهم منذ إخراجهم من مصر، ولإظهار ما استفادوه من تعليمه وتأديبه.
عَبِيدَهُ أشار بذلك إلى الأنبياء الذين دعوا الناس إلى الله وحده، ونهوهم عن الآلهة الباطلة. ولم يُرد بأولئك العبيد الأنبياء الذين أرسلهم في وقت واحد، بل الذين أرسلهم في أزمنة مختلفة منذ كان اليهود أُمة.
لِيَأْخُذَ أَثْمَارَهُ لم يسأل الله الناس أكثر مما يحق له أن يطلبه، فيطلب ثمار البر على قدر ما يعطيهم من وسائط النعمة وفرص التوبة والبركات الروحية، وذلك مثل قوله «أَرْسَلْتُ إِلَيْكُمْ كُلَّ عَبِيدِي الأَنْبِيَاءِ مُبَكِّرًا وَمُرْسِلاً قَائِلاً: لاَ تَفْعَلُوا أَمْرَ هذَا الرِّجْسِ الَّذِي أَبْغَضْتُهُ» (إرميا ٤٤: ٤).
٣٥، ٣٦ «٣٥ فَأَخَذَ ٱلْكَرَّامُونَ عَبِيدَهُ وَجَلَدُوا بَعْضاً وَقَتَلُوا بَعْضاً وَرَجَمُوا بَعْضاً. ٣٦ ثُمَّ أَرْسَلَ أَيْضاً عَبِيداً آخَرِينَ أَكْثَرَ مِنَ ٱلأَوَّلِينَ، فَفَعَلُوا بِهِمْ كَذٰلِكَ».
٢أخبار ٢٤: ٢٠، ١ ونحميا ٢٩: ٢٦ ومتّى ٥: ١٢ و٢٣: ٣٤ الخ وأعمال ٧: ٥٢ و١تسالونيكي ٢: ١٥ وعبرانيين ١١: ٣٦، ٣٧
أشار بذلك إلى معاملة الشعب العبري أنبياء الله (١صموئيل ٢٢: ١٥ و١ملوك ٩: ١٠ و٢٢: ٢٤، ٢٧ و٢أخبار ٢٤: ١٩ – ٢١ و٣٦: ١٦ ونحميا ٩: ٢٦ وإرميا ٣٧: ١٥، ١٦ ولوقا ١٣: ٢٤ وعبرانيين ١١: ٣٧ ورؤيا ١٦: ٦ و١٨: ٢٤).
٣٧ «فَأَخِيراً أَرْسَلَ إِلَيْهِمُ ٱبْنَهُ قَائِلاً: يَهَابُونَ ٱبْنِي».
أَرْسَلَ إِلَيْهِمُ ٱبْنَهُ الأمر الجوهري في هذا المثل توضيح ما بلغه الكرامون من الشر، وهو أنهم أهانوا ابنه علاوة على إهانتهم عبيده المرسلين الأولين. إرسال رب الكرم ابنه كان نهاية الوسائط، إذ رأى أنه لا نفع من إرسال عبيد آخرين. كذلك الله إذ لم يجد نفعاً في إرسال أنبياء آخرين، لأن اليهود اضطهدوا الأنبياء الأولين وقتلوهم، أرسل ابنه الحبيب الذي كان عليهم أن يقبلوه بإكرام كما يقبلون الآب (يوحنا ٣: ١٦، ١٧ و٥: ٢٣ ورومية ٨: ٣، ٣٢ وغلاطية ٤: ٤ و١يوحنا ٤: ٩، ١٤). وإرسال الله ابنه ليموت عن الناس دليل على أنه «لاَ يَشَاءُ أَنْ يَهْلِكَ أُنَاسٌ، بَلْ أَنْ يُقْبِلَ الْجَمِيعُ إِلَى التَّوْبَةِ» (٢بطرس ٣: ٩).
يَهَابُونَ ٱبْنِي أي يستحون ويخافون أن يعاملوه كما عاملوا العبيد، فيسمعون له ويطيعونه كما يليق بشرفه ومقامه. فالمسيح أثبت في ذلك أفضليته على كل الأنبياء في كل عصر. لكنه أثبتها بطريق لم يستطع بها الفريسيون أن يثبتوا عليه التجديف بدعواه أنه ابن الله كما كانت غاية مراقبتهم له. ومشابهة الجسديات للروحيات ناقصة، لأن رب الكرم في المثل جهل مقاصد الكرامين الشريرة حين أرسل ابنه إليهم، ظناً منه أنهم سيكفون بذلك عن عصيانهم. وأما الله فعلم منذ الأزل كيف يعامل الناس ابنه، ولكنه أرسله لكيلا يبقى لهم عذر.
٣٨ «وَأَمَّا ٱلْكَرَّامُونَ فَلَمَّا رَأَوْا ٱلابْنَ قَالُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ: هٰذَا هُوَ ٱلْوَارِثُ. هَلُمُّوا نَقْتُلْهُ وَنَأْخُذْ مِيرَاثَهُ».
مزمور ٢: ٨ وعبرانيين ١: ٢ ومزمور ٢: ٢ ومتّى ٢٦: ٣ و٢٧: ١ ويوحنا ١١: ٥٣ وأعمال ٤: ٢٧
تآمر الكرامون بالشر على الابن عندما رأوه خلافاً لما توقعه رب الكرم منهم. وفعلوا ذلك إما لأنهم لم يخافوا رجوع رب الكرم، أو لأنهم أغمضوا عيونهم عن النظر في عاقبة شرهم. كذلك تآمر اليهود على قتل المسيح ورفضوا أنه مسيحهم وملكهم، فعرَّضوا أنفسهم لعواقب أفعالهم الهائلة. لقد تشاور اليهود على قتل المسيح وفق هذا المثل (يوحنا ١١: ٤٧ – ٥٣). ومثله تآمر إخوة يوسف عليه وهو قادم إليهم (تكوين ٣٧: ١٩) فظنوا أنهم يبطلون مقاصد الله في ترؤّس يوسف عليهم، فخابوا. وكذلك خاب اليهود بظنهم أن يبطلوا مقاصد الله المتعلقة بابنه يسوع المسيح (أعمال ٣: ١٨ و٤: ٢٧، ٢٨).
هٰذَا هُوَ ٱلْوَارِث علم الكرامون أن الابن هو الوارث الحقيقي. لكن اليهود لم يعرفوا أن يسوع هو المسيح، ولو أن هذا ممكناً لهم لو أنهم نظروا بقلوب وعقول منفتحة إلى المعجزات التي صنعها أمامهم. ولكنهم أغمضوا عيونهم عمداً وقسّوا قلوبهم لكيلا يقتنعوا بما يناقض أهواءهم ويعاكس أغراضهم. لذلك كانوا بلا عذر. أما كون المسيح وارثاً فواضح من أن الله «جعله وارثاً لكل شيء» (عبرانيين ١: ٢).
نَقْتُلْهُ وَنَأْخُذْ مِيرَاثَهُ رأى الفريسيون أن لا طريق لحفظ سلطانهم على الشعب إلا بقتل المسيح، لأن دعواه تبطل دعواهم (يوحنا ١١: ٤٨ و١٢: ١٩).
٣٩ «فَأَخَذُوهُ وَأَخْرَجُوهُ خَارِجَ ٱلْكَرْمِ وَقَتَلُوه».
متّى ٢٦: ٥ الخ ومرقس ١٤: ٤٦ الخ ولوقا ٢٢: ٥٤ الخ ويوحنا ١٨: ١٢ الخ وأعمال ٢: ٢٣
قصة معاملة الكرامين ابن رب الكرم نبوَّة بما علم المسيح أنهم قصدوا أن يفعلوه به، وقد فعلوه بعد ثلاثة أيام من ذلك. وأظهر بتلك القصة للفريسيين أنه عالم بمقصدهم السري.
خَارِجَ ٱلْكَرْمِ ظن البعض ذلك إشارة إلى تسليم يسوع إلى الأمم ليصلبوه (يوحنا ١٨: ٢٨) وإلى أنه يصلب خارج أورشليم (لوقا ٢٣: ٢٣ ويوحنا ١٩: ١٧ وعبرانيين ١٣: ١٢، ١٣). ولم يتحقق أن المسيح قصد بذلك سوى رفض اليهود إياه وقتلهم له.
٤٠ «فَمَتَى جَاءَ صَاحِبُ ٱلْكَرْمِ، مَاذَا يَفْعَلُ بِأُولَئِكَ ٱلْكَرَّامِينَ؟».
ذكر هنا رجوع رب الكرم كأنه أمر لا ريب فيه، وأنه يحاكم الكرامين الأشرار. وفي ذلك إشارة إلى رجوع المسيح عند خراب أورشليم. وغايته من سؤاله عما يفعله رب الكرم عند مجيئه أن يدينوا أنفسهم بجوابهم، ويسلموا بأن الدينونة التي ستقع عليهم هي مما يقتضيه العدل.
٤١ «قَالُوا لَهُ: أُولَئِكَ ٱلأَرْدِيَاءُ يُهْلِكُهُمْ هَلاَكاً رَدِيّاً، وَيُسَلِّمُ ٱلْكَرْمَ إِلَى كَرَّامِينَ آخَرِينَ يُعْطُونَهُ ٱلأَثْمَارَ فِي أَوْقَاتِهَا».
لوقا ٢٠: ١٦ ولوقا ٢١: ٢٤ وعبرانيين ٢: ٣ وأعمال ١٣: ٤٦ و١٥: ٧ و١٨: ٦ و٢٨: ٢٨ ورومية ٩: ١٠ و١٥: ٩، ١٠، ١٦، ١٨
قَالُوا أي الكتبة والفريسيون، وربما وافقهم على ذلك غيرهم من الحاضرين. ولعلهم لم يشعروا حينئذٍ بأن المسيح ضرب هذا المثل عليهم، أو أنهم شعروا وتجاهلوا خجلاً من الجمع.
يُهْلِكُهُمْ حكموا بمقتضى اختبارهم فعل الناس في مثل تلك الأحوال، وبموجب العدل وذلك بعد ما أخذ منهم الكرم وسلمه إلى آخرين. والقول الذي نسبه متّى هنا إلى الفريسيين نسبه مرقس ولوقا إلى المسيح. فنستنتج من أقوال الثلاثة أن المسيح سأل الكتبة والفريسيين أولاً فأجابوه بذلك، فكرر جوابه تصديقاً لقولهم إشارة إلى معنى آخر يستلزمه المعنى الأصلي.
كَرَّامِينَ آخَرِينَ أشار بذلك إلى دعوة الأمم (رومية ١١: ١١ – ٢٥).
يُعْطُونَهُ ٱلأَثْمَارَ لا يلزم من ذلك أن يطيع كل الأمم ويقدمون لله أثمار البر. فالقصد به أن الله ينزع وسائط النعمة ممن لا يستعملونها كما ينبغي، ويعطيها لغيرهم. فإن كان هؤلاء أمناء بقيت تلك الوسائط لهم.
ويشير هذا المثل إلى رفض اليهود خاصة. وفيه بيان معاملة الله لكل من يستحقون وسائط النعمة ويعصونه. وجواب الكتبة والفريسيين هنا نبوة بمستقبلهم. والله لا يسكت عن سلب حقوقه من أثمار كرمه الروحي، فإذا لم يكن الذين سُلم إليهم أمناء سلَّمه إلى غيرهم من أصحاب الأمانة.
٤٢ «قَالَ لَـهُمْ يَسُوعُ: أَمَا قَرَأْتُمْ قَطُّ فِي ٱلْكُتُبِ: ٱلْحَجَرُ ٱلَّذِي رَفَضَهُ ٱلْبَنَّاؤُونَ هُوَ قَدْ صَارَ رَأْسَ ٱلزَّاوِيَةِ. مِنْ قِبَلِ ٱلرَّبِّ كَانَ هٰذَا وَهُوَ عَجِيبٌ فِي أَعْيُنِنَا».
مزمور ١١٨: ٢٢، ٢٣ وإشعياء ٢٨: ١٦ ومرقس ١٢: ١٠، ١١ ولوقا ٢٠: ١٧ وأعمال ٤: ١١ وأفسس ٢: ٢٠ و١بطرس ٢: ٦، ٧
أتى المسيح هنا ببرهان من كتبهم، وهو أن الله أنبأ منذ القدم بنفس الأمر الذي قصده المسيح في هذا المثل.
فِي ٱلْكُتُبِ أي أسفار العهد القديم (رومية ١: ٢) وما ذكره المسيح في هذا العدد اقتبسه من مزمور ١١٨: ٢٢ وهو المزمور الذي أخذ منه الشعب قولهم «أُوصنا» ونادوا به يوم دخوله المدينة باحتفال.
ٱلْحَجَرُ ٱلَّذِي رَفَضَهُ الكلام هنا عن حجر في الجبل، اختاره رئيس البنائين رأساً للزاوية ووضع عليه علامة ذلك. لكن البنائين حسبوه غير موافق وتركوه مكانه. والقصد بالبناء هنا كنيسة الله. وبرئيس البنائين الله وبالحجر الذي اختاره رئيساً للزاوية الرب يسوع المسيح الذي عيَّنه الله منذ الأزل ليكون أساساً لبيته الروحي أي كنيسته (إشعياء ٢٨: ١٦) والبناؤون هم الأمة اليهودية، ولا سيما يهود ذلك العصر الذين أبوا أن يقبلوا يسوع مسيحاً (أعمال ٤: ١١ و١بطرس ٢: ٧). وسبب رفضهم يسوع أنه كان من عائلة بائسة، وكان متواضعاً محتقراً من الناس (إشعياء ٥٣: ٢، ٣) وليس له جاه عالمي، ولم يقصد إنشاء مملكة عالمية. ونسبة هذه النبوة إلى يسوع خاصة لا تمنع نسبتها أولاً إلى داود ثم إلى زربابل (زكريا ٣: ٩ و٤: ٦ – ١٠) لأن كلاً منهما كان رمزاً إلى المسيح.
رَأْسَ ٱلزَّاوِيَةِ تمت مقاصد الله وصار المسيح أساس الكنيسة بالرغم من كل مقاومات اليهود (أفسس ٢: ١٩ – ٢٢).
هٰذَا أي جعل يسوع المسيح أساساً للكنيسة.
عَجِيب أي هذا الأمر حيَّر كل من نظر فيه، لأنه خلاف ما توقعه أكثر أفراد الأمة العبرية. فلو لم يكن من حكمة الله التي لم تُدرَك ومقاصده الأزلية، ما أمكن أن يحدث. ولا شك أن كل حوادث عمل الفداء هي غاية في العجب. وهل أعجب من أن الله يرسل ابنه الوحيد فادياً، وأن الكلمة الأزلي صار جسداً واتضع في كل حياته على الأرض، ورفضته الأمة المختارة وقتلته! وهل أعجب من إقامة الله إياه من الموت، ومن أنه بنى عليه كنيسته المجموعة من اليهود ومن كل أمم الأرض وجعلها دائمة إلى الأبد! فهذه الأمور كلها لا تزال عجيبة عند الناس في الأرض، والملائكة والقديسين في السماء.
٤٣ «لِذٰلِكَ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ مَلَكُوتَ ٱللّٰهِ يُنْزَعُ مِنْكُمْ وَيُعْطَى لأُمَّةٍ تَعْمَلُ أَثْمَارَهُ».
متّى ٨: ١١، ١٢
أوضح المسيح في هذا العدد مقصده من ذلك المثل، ففسّر الكرم بملكوت الله. وعبَّر متّى في بشارته عن الكنيسة بملكوت الله أربع مرات وبملكوت السماء عشرين مرة.
يُنْزَعُ مِنْكُمْ الخطاب لليهود، والقصد أنه ينزع منهم كل وسائط النعمة والبركات المختصة بشعب الله الخاص، كاستئمانهم على أقوال الله، وإرثهم للمواعيد.
وَيُعْطَى لأُمَّةٍ أي أن الأمم تُعطى وسائط النعمة التي أهملها اليهود (أعمال ١٣: ٤٦ – ٤٨ و١٥: ١٤ و٢٨: ٢٨ ورؤيا ٥: ٩، ١٠) وتحققت هذه النبوة من جهة الأمم في بيت كرنيليوس (أعمال ١٠) وبإيمان ملايين منهم بالمسيح من ذلك الوقت إلى الآن، وتمَّت أيضاً من جهة اليهود بخراب مدينتهم وتشتتهم في العالم، وبأن قليلين منهم آمنوا بالمسيح ونالوا فوائد خلاصه.
٤٤ «وَمَنْ سَقَطَ عَلَى هٰذَا ٱلْحَجَرِ يَتَرَضَّضُ، وَمَنْ سَقَطَ هُوَ عَلَيْهِ يَسْحَقُهُ».
إشعياء ٨: ١٤، ١٥ وزكريا ١٢: ٣ ولوقا ٢٠: ٨ ورؤيا ٩: ٣٣ و١بطرس ٢: ٨ وإشعياء ٦٠: ١٢ ودانيال ٢: ٤٤
في هذا العدد إشارة إلى قوله «يَكُونُ مَقْدِسًا وَحَجَرَ صَدْمَةٍ وَصَخْرَةَ عَثْرَةٍ لِبَيْتَيْ إِسْرَائِيلَ، وَفَخًّا وَشَرَكًا لِسُكَّانِ أُورُشَلِيمَ. فَيَعْثُرُ بِهَا كَثِيرُونَ وَيَسْقُطُونَ، فَيَنْكَسِرُونَن» (إشعياء ٨: ١٤، ١٥). وذلك يُظهر عواقب رفض الإيمان بالمسيح في هذا العالم فادياً وفي العالم الآتي دياناً.
مَنْ سَقَط أشار بذلك من عثروا بالمسيح لاتضاعه (إشعياء ٨: ١٤ و٥٣: ٢ ولوقا ٢: ٣٤ ويوحنا ٤: ٤٤) وأكثر الذين سمعوه حينئذ كانوا في تلك الحال. وهي حال إثم وخطر، لكنها ليست حال يأس، لأنه يمكن للذي وقع فيها أن ينجو منها بالتوبة.
سَقَطَ هُوَ عَلَيْهِ أي الحجر وكل ما بُني عليه. أو المسيح وكل قوة ملكوته معاً. ولعل ذلك مما قيل في دا ٢: ٣٤، ٣٥، ٤٥ ووقت سقوطه يوم الدين.
يَسْحَقُه القصد بالمسحوق هنا من وجب عليه الهلاك ويئس من الخلاص، فلا يسقط هذا الحجر للدينونة إلا على من سقط على ذلك الحجر أولاً.
٤٥، ٤٦ «٤٥ وَلَمَّا سَمِعَ رُؤَسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ وَٱلْفَرِّيسِيُّونَ أَمْثَالَهُ عَرَفُوا أَنَّهُ تَكَلَّمَ عَلَيْهِمْ. ٤٦ وَإِذْ كَانُوا يَطْلُبُونَ أَنْ يُمْسِكُوهُ خَافُوا مِنَ ٱلْجُمُوعِ، لأَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُمْ مِثْلَ نَبِيٍّ».
ع ١١ ولوقا ٧: ١٦ ويوحنا ٧: ٤٠
شعر هؤلاء أخيراً بأن المسيح قصدهم في المثل. فلو لم يخافوا الشعب لبلغوا مقاصدهم منه علانية. فاضطروا أن يحاولوا قتله بمكر وخيانة. وفي قوله «تكلم عليهم» ربما يقصد تكلم عنهم بما هو الحكم عليهم بالتوبيخ الذي يستحقونه، إذ عرف مسبقاً أنهم يزمعون قتله مكراً وخبثاً.
السابق |
التالي |